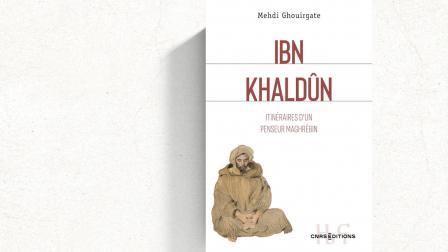يُعزَى ضعف علاقة الأنظمة الشمولية العربية بالعلم إلى النقص في الخبراء والمختبرات والباحثين والعلماء. والمثال الأكثر جدارة، هو أن المختبرات الوحيدة كانت لصناعة البراميل المتفجّرة وإجراء تجارب على السلاح الكيماوي، إضافةً إلى تطوير أدوات التعذيب على أنها أدوات إقناع محلّية، يأخذ كل نظام بها بما يتناسب مع غايات محلّية الطابع، فالإسلامي المطلوب في بلدٍ مكرّمٌ في بلد آخر، كذلك اليساري واليميني، ولا ننسى الإضافات المذهبية التي بدأت تأخذ أدوارها بقوّة فريدة.
ليست هذه الأنظمة خالية من العلماء، وإنما يجري تجريدهم من العلم وتحويلهم الى مجرمين لدى السلطة، أو ينجون بأنفسهم، ويتوظّفون في أعمال إدارية، وقد لا يحصلون على عمل، فيذهبون الى الغرب حيث يجدون أكثر من فرصة، تعود عليهم بالنجاح، وأحياناً بالشهرة، تضنّ عليهم بها أنظمة بلدانهم، لتصنيفهم خطراً على الجهل المعمَّم على شعوبهم.
لم يمنع تخصيص العلم من إيجاد ساحة للعلم البديل، لا علاقة له بالطب البديل، كان لفرضياته تطبيقات في مجالات عادت بالفائدة عليها، مستمدّة من أنها أنظمة صمود وتصدٍّ، مقاومة وممانعة، وغيرها من تلك الشعارات التي لا تدوم طويلاً، تظهر وتختفي حسب المرحلة السياسية. فالشعارات لم توضع إلا لمساس الحاجة إليها، تختصر الكثير من الكلام إلى قليله، تحت هذا القليل يُوضَع أيٌّ كان في السجن. عموماً الشعب يصغي إليها، يخضع لها، ويعمل بها.
ولضمان نجاح هذه العملية، وهي عملية غير دقيقة ولا معقّدة، طالما أنها قسرية، تنشد تحويل الشعارات إلى إيمان لا يتطرّق إليه الشك. فانصرف الجهد إلى صناعة الإنسان القومي، وترقيته من إنسان عادي إلى إنسان نوعي، من خلال قالب موحَّد من الطاعة، لا تخلو من خنوعٍ يحتّمه عدم التفكير بالاحتجاج، واعتبار كل ما يقدّمه النظام عبارة عن مكرمة؛ بالمقابل إبداء المواطن إخلاصه مشفوعاً بامتنان لتلك الهبة التي لا يستحقّها، ونبذ الديمقراطية، ولو كان على حساب الجهل بها. إذ ما الحاجة إليها؟
هذه الصناعة ليست أسيرة المختبرات، والأصح اعتبار الوطن كلّه مختبراً لها، فالأشياء لا تُختلق ولا تَختلق نفسها. وراءها جيش من العاملين على بناء على هذه الصناعة، بوسعنا تصوُّر آلية العمل المستوحاة من تصنيع الإنسان الجديد المؤمن بقوميته، من دون إيمان بها، فالطاعة لا تهتم بالقوميات.
لذلك فلنتصور أن هناك أشخاصاً يستيقظون صباحاً، لا يستثنى منهم أحد من القمة إلى القاعدة، ومنهم مفكّرون وصحافيّون ومحللون سياسيّون وفنّانون وضبّاط أمن وشرطة وموظّفون كبار... هؤلاء عمّال هذه الصناعة، كرّسوا جهودهم لها، ومن دون تعاون بينهم. كلٌّ منهم يتوجّه إلى معمله، ويبدأ بإجراء تجاربه، وجميعها تصبّ في مجرى واحد، تدور حول أسلوب التعامل مع المواطن والتأكُّد من صلاحيته للبقاء على قيد الحياة، عبر امتحان دائم، يفترض أنه مذنب، ووضعه على الدوام موضع الدفاع عن النفس، محاولاً إثبات براءته.
إذا كان كافكا اختلق المتّهم كاف، ففي بلادنا وجد تطبيقاته العملية.