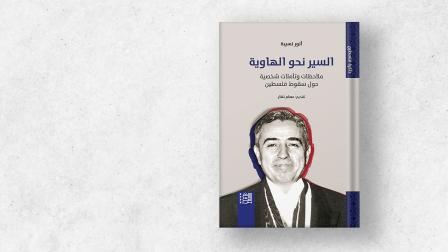طفولة، إكرليك على قماش لـ صلاح بنجكان(العربي الجديد)
كتبت مستشارة المندوب السامي البريطاني ورسامة الخرائط والرحالة البريطانية الشغوفة بالآثار غرترود بل في كتابها "العامر والغامر: رحلة من القدس إلى أنطاكية في عام 1905"، كيف أنها أثناء وجودها في جبل العرب بضيافة الشيخ محمد الأطرش ناقشت معه أمورًا وأوضاعًا سياسية تخص بلدًا عربيًا بعيدًا: "ناقشنا أمور الحرب في اليمن بكل ما تحمله من أبعاد نظريًا، حيث كنت الوحيدة التي لدي أنباء عنها، وقد استقيتها من جريدة التايمز الأسبوعية قبل شهر". اللافت في قول بِل أو الخاتون كما كان العراقيون يسمونها، أنها لم تجد أي غضاضة بـ "قِدم" معلوماتها أو تقادمها، فقد كانت الأمور في مطلع القرن العشرين تسير على هذه الوتيرة "القاتلة ببطئها" وفقًا لمعايير اليوم. كل ما في الكتاب يزين المقارنة بين مطلع القرن الماضي واليوم.
مائة عام ونيف مرّت منذ رُسمت خرائط المشرق والعراق وباقي الدول العربية من قبل البريطاني سايكس والفرنسي بيكو. وكان لبِل يدٌ "خفيفة وخفية" كما هو معروف في رسم الحدود. تكشف رحلة بِل هذه كما كتبها ورسائلها الأخرى، عن شغفها الكبير بالآثار والنقوش المتناثرة في المشرق، فقد تأنت في وصفها متسلحة بكل معرفتها الآثارية في ردّ تلك الأوابد والآثار إلى زمنها، وتعيين مدارسها المعمارية ومقاييسها وما إلى ذلك من أمور. وبقدر ما بدت بِل شغوفة بالمعرفة حال تعلّق الأمر بالحجر والمكان، بدت استعلائية ومراوغة تطلق الأحكام المبرمة بسهولة حيال كل فرد عربي سواء أكان دليلًا صغيرًا أم شيخًا ذا مكانة رفيعة أم وجيهًا محترمًا. إذ إنها لم تتردد مثلًا في ردع أحد أدلائها، وكان قد تباسط معها في الحديث، قائلة:
"اسمع، أنت! أنا لستُ أنتِ، نادني جنابك". لكأن بِل أقامت في ذهنها فصلًا نهائيًا بين البشر والحجر. شيء "استشراقي" تمامًا يطابق إلى حد كبير تلك الصور الفوتوغرافية للمناظر الفلسطينية الخالية من الناس في مطلع القرن العشرين. صور كانت لها رسالة وحيدة على ما يبدو: الفصل بين الناس والمكان تمهيدًا لتشريع الجملة الأشهر في المشروع الصهيوني: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. يسهّل هذا الفصل المتكبر بين الناس والمكان على رجل السياسة - أو امرأة السياسة - القيام بمهمته.
ربما كان الدافع أو المحرك إلى سلوك بِل هذا، يرتبطُ إلى حد ما بشعور الكراهية والمقت، الذي تبلور مَلَكةُ المراوغة بدورها، إخفاءه وتغليفه بعبارات لا ينقصها ذكاء ولا مباغتة، عبارات كانت حاضرة على الدوام على لسان بِل حيال كل من "تسول له نفسه" التصرف بذكاء يشفّ عن ندية تجاهها. لئن كان الكتاب في ظاهره كتاب رحلة، فإنه كما لا يخفى تدوين "خفيف" لرحلة لم تكن رؤية الآثار والعبور إلى الصحراء هدفها الوحيد. فمن حين لآخر، تتناثر مقاطع صغيرة وبعض الجمل، التي تخبّر عن "وظيفة" بِل، التي ما كان لها أن تتم لولا هذا الشعور "سلوك الكراهية" تجاه الناس.
فحين تصل غرترود بِل إلى دمشق وتزور الوجهاء والأعيان والحكام، ومن بينهم الأمير عبد القادر الجزائري وأخوه الأمير طاهر، فإنها تفصح بوضوح: "لا وجود لأمة العرب، فالتاجر السوري تفصله مسافة كبيرة عن البدوي، أكبر بكثير من تلك التي تفصله عن العصملي، وسورية تسكنها أعراق تتكلم اللغة العربية وكل منها يتوق للإمساك بخناق العرق الآخر".
والسؤال أكانت نظرة بِل نحو الناس، والرائجة أيضًا لدى زملائها من مهندسي الانتدابين الإنكليزي والفرنسي، سببًا مؤثِرًا في دورها في رسم خرائط سايكس بيكو الشهيرة؟ وبقطع النظر عن الجواب الذي سيتم تعليبه في خانة "القومية" حال كان منتقدًا لبِل ونظرتها الاستعلائية، تبدو "قصة" الأعراق والمذاهب والأديان موضوعة جميعًا على "المحك" في ما يخص سورية.
لكن طريقة وضعها اليوم هي أبعد ما تكون عن الموضوعية أو الواقعية، إذ إنها ليست وليدة عوامل داخلية، ولا تجربة واعية بضرورة المضي قدمًا، بل وليدة ظروف استثنائية بكارثيتها وتخريبها، وتشغل العوامل الخارجية نصيبًا كبيرًا منها، فضلًا عن تغييب إرادة السوريين. ويشبه السؤال عن "الطائفية"، إن كانت من أصل طباع السوريين أم مجلوبة من الغرب والاستشراق، السؤال المبدّد للجدية والعمل والقائم على مفاضلة مفتعلة: التراث أم الحداثة؟. فكل جواب عنه، سيفضي إلى إثارة أجوبة مناقضة، ضمن حلقة مفرغة، لا تؤدي إلا إلى إذكاء الكراهية.
إقرأ أيضا: نوبل للياسمين
مائة عام ونيف مرّت منذ رُسمت خرائط المشرق والعراق وباقي الدول العربية من قبل البريطاني سايكس والفرنسي بيكو. وكان لبِل يدٌ "خفيفة وخفية" كما هو معروف في رسم الحدود. تكشف رحلة بِل هذه كما كتبها ورسائلها الأخرى، عن شغفها الكبير بالآثار والنقوش المتناثرة في المشرق، فقد تأنت في وصفها متسلحة بكل معرفتها الآثارية في ردّ تلك الأوابد والآثار إلى زمنها، وتعيين مدارسها المعمارية ومقاييسها وما إلى ذلك من أمور. وبقدر ما بدت بِل شغوفة بالمعرفة حال تعلّق الأمر بالحجر والمكان، بدت استعلائية ومراوغة تطلق الأحكام المبرمة بسهولة حيال كل فرد عربي سواء أكان دليلًا صغيرًا أم شيخًا ذا مكانة رفيعة أم وجيهًا محترمًا. إذ إنها لم تتردد مثلًا في ردع أحد أدلائها، وكان قد تباسط معها في الحديث، قائلة:
ربما كان الدافع أو المحرك إلى سلوك بِل هذا، يرتبطُ إلى حد ما بشعور الكراهية والمقت، الذي تبلور مَلَكةُ المراوغة بدورها، إخفاءه وتغليفه بعبارات لا ينقصها ذكاء ولا مباغتة، عبارات كانت حاضرة على الدوام على لسان بِل حيال كل من "تسول له نفسه" التصرف بذكاء يشفّ عن ندية تجاهها. لئن كان الكتاب في ظاهره كتاب رحلة، فإنه كما لا يخفى تدوين "خفيف" لرحلة لم تكن رؤية الآثار والعبور إلى الصحراء هدفها الوحيد. فمن حين لآخر، تتناثر مقاطع صغيرة وبعض الجمل، التي تخبّر عن "وظيفة" بِل، التي ما كان لها أن تتم لولا هذا الشعور "سلوك الكراهية" تجاه الناس.
فحين تصل غرترود بِل إلى دمشق وتزور الوجهاء والأعيان والحكام، ومن بينهم الأمير عبد القادر الجزائري وأخوه الأمير طاهر، فإنها تفصح بوضوح: "لا وجود لأمة العرب، فالتاجر السوري تفصله مسافة كبيرة عن البدوي، أكبر بكثير من تلك التي تفصله عن العصملي، وسورية تسكنها أعراق تتكلم اللغة العربية وكل منها يتوق للإمساك بخناق العرق الآخر".
والسؤال أكانت نظرة بِل نحو الناس، والرائجة أيضًا لدى زملائها من مهندسي الانتدابين الإنكليزي والفرنسي، سببًا مؤثِرًا في دورها في رسم خرائط سايكس بيكو الشهيرة؟ وبقطع النظر عن الجواب الذي سيتم تعليبه في خانة "القومية" حال كان منتقدًا لبِل ونظرتها الاستعلائية، تبدو "قصة" الأعراق والمذاهب والأديان موضوعة جميعًا على "المحك" في ما يخص سورية.
لكن طريقة وضعها اليوم هي أبعد ما تكون عن الموضوعية أو الواقعية، إذ إنها ليست وليدة عوامل داخلية، ولا تجربة واعية بضرورة المضي قدمًا، بل وليدة ظروف استثنائية بكارثيتها وتخريبها، وتشغل العوامل الخارجية نصيبًا كبيرًا منها، فضلًا عن تغييب إرادة السوريين. ويشبه السؤال عن "الطائفية"، إن كانت من أصل طباع السوريين أم مجلوبة من الغرب والاستشراق، السؤال المبدّد للجدية والعمل والقائم على مفاضلة مفتعلة: التراث أم الحداثة؟. فكل جواب عنه، سيفضي إلى إثارة أجوبة مناقضة، ضمن حلقة مفرغة، لا تؤدي إلا إلى إذكاء الكراهية.
إقرأ أيضا: نوبل للياسمين