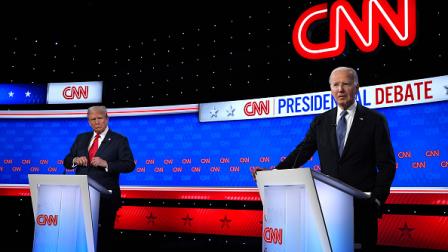تتطلب الإجابة عن ذلك، عودة إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى السياقات التي اشتعلت معها الثورة، سواء تلك المتعلقة بالثورات، التي انطلقت من تونس ثم مصر واليمن وليبيا وغيرها، ووصلت ارتداداتها قبل مارس/آذار 2011 إلى سورية، أو الأسباب البعيدة غير المباشرة، التي دفعت ملايين السوريين للنزول إلى الشوارع أواسط مارس 2011، للمطالبة بالحرية، وكسر سطوة الاستبداد الحاكم لبلدهم منذ نحو نصف قرن، لتتصاعد المطالب سريعاً خلال أسابيع بفعل القمع الوحشي للمتظاهرين، الذين طالبوا بـ"إسقاط النظام" بدل إصلاحه.
البداية: مطالب الكرامة والحرية
فيما يؤرَخُ للثورة السورية، على أنها انطلقت منتصف مارس 2011، فإن إرهاصاتها والمؤشرات الدالة على اقتراب تفجرها، كانت قد بدأت قبل ذلك بأربعة أسابيع؛ فظهر الخميس السابع عشر من فبراير/شباط 2011، وعند مدخل "الحريقة" أحد أشهر أسواق دمشق القديمة، وبعد إهانة شرطي مرور لشابٍ كان يقود سيارته في ذاك الشارع المزدحم، وتصاعد الإهانة اللفظية لاعتداء بالضرب، تجمّع عشرات الشبان عفوياً في محيط الحادثة، وأطلقوا هتافاً نابعاً من وحي اللحظة المشحونة: "الشعب السوري ما بِينذَل".
سُمع دوي الهتاف في أرجاء ذلك السوق، ووصل صداه إلى عموم سورية بعد انتشار فيديو الواقعة على الإنترنت. يومها، وعقب أسبوعٍ على الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، وشهرٍ على هروب زين العابدين بن علي من تونس، كشفت الحادثة الرمزية، التي انتهت في غضون دقائق، بعد وصول وزير الداخلية السوري حينها سعيد سمور إلى المكان الذي يبعد عشرات الأمتار عن مكتبه القريب في ساحة "المرجة-الشهداء"، حجم الاحتقان القائم في النفوس المتأهبة للهتاف ضد سلطةٍ تحكم سورية بقبضةٍ أمنية حديدية، تحت حكم قانون الطوارئ منذ سنة 1963، وتُحرّم الهتاف العلني، إلا بحياة وانجازات "القائد" الذي يحكم سورية "للأبد".
ظهر الثلاثاء، 15 مارس 2011، نظّم العشرات تظاهرة سريعة في سوق الحميدية الشهير وسط دمشق، وبدا الشعار الذي رُفع مرعباً للنظام وأجهزته الأمنية، على الرغم من أن أعداد المشاركين في التظاهرة كانت ضئيلة. فالهتاف المُعلن الذي دوى في آذان السامعين وسط دمشق كان "الله... سورية... حرية وبس"، بينما الآذان السورية تعرف هذا الشعار جيداً على أنه "الله... سورية... بشار وبس"، لكن تظاهرة الحميدية أسقطت الثلث الأخير من الشعار، لتستبدل "بشار" بـ"الحرية"، ولتبدو دلالات المفردتين متناقضتين.
بعد ثلاثة أيامٍ، كانت درعا جنوبي البلاد، تغلي على وقع إهانة أجهزة أمن النظام لمطالب الأهالي بإطلاق سراح أطفالهم من السجون، بعدما كانوا اعتُقلوا لكتابتهم على الجدران شعارات ضد رئيس النظام السوري. بلغ الغليان المُستتر ذروته، وتحول إلى تظاهراتٍ في الشوارع، واجهتها أجهزة أمن النظام سريعاً بقمع وحشي، انتهى بمقتل شابين من المتظاهرين بالرصاص يوم الجمعة 18 مارس، فيما كانت مدنٌ أخرى بينها دمشق العاصمة، وبانياس الساحلية تشهد بالتزامن تظاهراتٍ بدا أن رقعتها تتسع شيئاً فشيئاً.
كرة الثلج: إسقاط النظام
كرة الثلج تدحرجت، وبدأت الأحداث تتسارع شيئاً فشئياً، إذ انطلقت التظاهرات من درعا جنوبي البلاد، مروراً بدمشق وأريافها التي انتفضت، ثم حمص في الوسط، وإدلب في الشمالي الغربي، واللاذقية غرباً، ودير الزور شرقاً، وغيرها من المدن والبلدات شمال شرق البلاد وشمالها. لكن الشعارات فعلياً كانت عبارة عن مطالب بالحرية والكرامة، وكسر سطوة الأجهزة الأمنية على حياة الناس، قبل أن يزداد القمع الوحشي للأجهزة الأمنية مع اتساع رقعة التظاهرات السلمية. وبدأت حصيلة القتلى برصاص الأمن بالازدياد، حتى وصل عدد القتلى من المتظاهرين يوم "الجمعة العظيمة" (22 أبريل/نيسان 2011) إلى نحو مائة قتيل، وأدخل النظام بالتزامن، الجيش إلى درعا، في محاولة لكسر إرادة المتظاهرين هناك.
كل ذلك التسارع في اتساع رقعة المناطق الثائرة، والبطش المضاد لقمعها، بما في ذلك استخدام الأمن للرصاص الحي، وإنزال الجيش إلى بعض المناطق، سرّع رفع التظاهرات لشعار "الشعب يريد إسقاط النظام"؛ إذ بدا أن النظام غير قابلٍ للإصلاح، وغير مستعدٍ أساساً لسماع أصوات المطالبين به.
يُجمع محللون ومتابعون على أن النظام وجد في اتساع رقعة التظاهرات السلمية ضده، حرجاً كبيراً أمام العالم الذي يراقب هذه التظاهرات ومطالبها، فشجع حركة التسلح التي بدأت بعد أشهرٍ من انطلاق الثورة، وهو ما يرفع عنه حرج شن حربٍ ضد الثورة. بينما وجدت شرائح من المتظاهرين، أن لا سبيل للحماية من رصاص أجهزة الأمن، إلا بحمل السلاح الخفيف، الذي تدفقَ على المناطق الريفية، فيما بقي النظام مسيطراً على مراكز المدن، وبدأ استخدام السلاح الثقيل والطيران الحربي ضد المناطق التي باتت خارج سيطرته، منذ سنة 2012.
بهذا الاختصار السريع، يُمكن إجمال تسارع وتيرة أحداث الثورة، التي أخذت منعطفاً نحو التسلح في سنتها الثانية، وتتالت المنعطفات لاحقاً في السنوات التالية، مع بروز الجماعات المتطرفة "القاعدة" و"داعش"، التي استغلت حالة الفوضى لتدخل على الخط، مستثمرة الاحتقان الشعبي الواسع نتيجة مجازر النظام المتتالية، وتقديم نفسها كطرفٍ يقاتل النظام، لكن وفق مشاريعها الخاصة، وإيديولوجيتها العابرة للحدود. هذا الأمر خلق تحدياً أمام قوى الثورة، التي باتت في مواجهة النظام وهذه الجماعات في الوقت نفسه، بالتزامن مع تسارع استقدام إيران لعشرات المليشيات لدعم النظام السوري عسكرياً لمواجهة قوى الثورة وحاضنتها الشعبية.
ضرب الحاضنة الشعبية
ويبدو أن استهداف الحاضنة الشعبية للثورة السورية، كان وما زال هدفاً رئيسياً، لكافة القوى التي تدخّلت لدعم النظام السوري، بهدف كسر إرادة تبنّيها لمطالب الثورة الرئيسية؛ فقصف المدن والبلدات التي تُعتبر حواضن للثورة السورية، وتعمّد قتل المدنيين فيها، هدفه وضع السكان أمام خياري: الهلاك، أو الخضوع وترك دعم الثورة ومطالبها.
ومع تحويل النظام وحلفائه، مدناً وبلداتٍ وقرى بأكملها، إلى حطامٍ نتيجة القصف والغارات لسبع سنوات، لا تتوفر بفعل استمرار تساقط الضحايا يومياً أرقام محددة لأعدادهم، لكن إحصائيات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية تتحدث عن أكثر من نصف مليون قتيل حتى الآن، فضلاً عن ملايين النازحين داخل سورية، ونحو سبعة ملايين آخرين خرجوا منها، معظمهم يقيمون في دول الجوار بشكل خاص، ومئات الآلاف نجحوا في الوصول لدول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى في شمال أفريقيا، والخليج العربي وغيرها.
على الرغم من كل ذلك، ما زالت شعارات الثورة الأولى المُطالبة بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، تُسمع حتى اليوم، في التظاهرات القليلة التي تخرج سواء داخل سورية في المناطق التي لا يحكمها النظام، أو في الفعاليات التضامنية التي ينظمها سوريون في الخارج.
مجتمع الأسد "المتجانس"
بعد أن باتت سورية محكومة فعلياً بالتفاهمات بين الدول الكبرى الفاعلة فيها، ومسيطراً على الجانب الأكبر منها من قبل روسيا وإيران، أطل رئيس النظام بشار الأسد في أغسطس/آب 2017، ليقول في خطابٍ له بدمشق: "خسرنا خيرة شبابنا والبنية التحتية لكننا ربحنا مجتمعاً أكثر صحة وتجانساً"، مشيراً بذلك إلى المجتمع السوري "المنشود" الذي يأمل حكمَه في سورية التي يسيطر عليها.
ويبدو أن هذا "المجتمع المتجانس" من وجهة نظر النظام، هو المجتمع الذي لا يوجد فيه معارضون لحكمه؛ وبالتالي فإن تهجير الملايين، وقتل مئات الآلاف، كان للوصول إلى هذا "المجتمع المتجانس"، بدلاً من التنازل أمام مطالب التظاهرات الشعبية عند انطلاقها، وحماية البلد من الفوضى والانقسامات المجتمعية.
وسط كل هذه المآسي والمجازر التي يتعرض لها السوريون في مختلف المناطق، وفي الغوطة الشرقية راهناً، لا تزال شرائح كثيرة من السوريين، تُبدي تمسكاً بالثورة، وإصراراً على تحقيق مطالبها الأولى؛ ولعل كلام أحد السوريين في مدينة دوما لوفدٍ من الأمم المتحدة، الذي دخل تلك المنطقة المنكوبة لساعات، في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الحالي، يعبّر عن مشهد الثورة في أسوأ ظروفها. إذ أظهرت مشاهد مصورة نُشرت على الإنترنت، حديث ناشط سوري معروف في الغوطة الشرقية، يدعى أبو عماد المنشد، وقد وجّه كلامه لوفدٍ من الأمم المتحدة قائلاً: "نحن نُقصف بالكيماوي، ونحن نُقتل بالصواريخ الروسية، بسياسة الترويع وسياسة الأرض المحروقة(...) لسنا طلاب رغيف، نحن طلاب حرية ولا نزال ومصرين على انتزاع حريتنا من الطاغية بشار الأسد... كنا طلاب حرية، وبدأنا بسلمية، ولكن بشار الأسد ضربنا بالصواريخ"، قبل أن يرفع بقايا صاروخ بيده، كانت قوات النظام أطلقته على دوما في وقتٍ سابق.