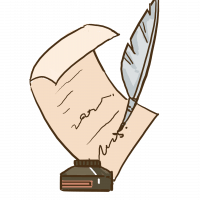ملف| تحتاج فلسطين أن نحبّها بسذاجة الأطفال (23)
لم أتمكن من أن أتمالك نفسي أمام نكتة أطلقها أحد طلابي عن الحرب على فلسطين، ولم أستطع أن أصدّق نظرة البقية المحدّقة نحو الفراغ، والتي تُوحي باللامبالاة، وكأنّ ما يجري، يجري في مكانٍ بعيد جداً، في عالم آخر لا يخصّهم ولا يعنيهم بشيء.
نعم أعترف بأنّها كانت من المرّات القلائل التي أُظهر فيها غضبي بهذا الوضوح أمام طلابي، رغم أنّي أدرك جيداً أنّي أحمّلهم أكثر مما عليهم أن يحملوا، وأنّي أحاول بطريقة ما أن أجعلهم نسخة عن جيلنا في ما يخصّ فلسطين تحديداً. والأهم من هذا كلّه، أفهم كيف أنّهم ما زالوا مخدرين بوجعهم الخاص، ينفضون غبار الموت عن أجسادهم الضئيلة ويسعون باتجاه الحياة، علّهم يحصّلون منها ما عجزنا نحن عن تحصيله. لكنها فلسطين، فلسطين التي لا يعرفونها كما عرفناها، ولم يحملوها كما حملناها غصّة في قلوبنا، وحلماً من أحلام طفولتنا البريئة.
وجدت نفسي بعدها، أختلق فرصة لأحكي لهم عن فلسطين، فلسطين كفكرة عن الحق، لا فلسطين كما شوّهها السياسيون، وكما استغلها الجميع، من أحبّها ومن كرهها.
تحدثنا كثيراً عن الأمهات اللواتي يبكين أطفالًا ماتوا دون أن يأكلوا، وعن أحلامٍ ماتت قبل أن تقفز من الأسرّة، وعن بردِ الخيم، وعن وجع الأرض عندما تُسقى بدماء أولادها، وعن حلم العودة للبلاد التي انتُزعت عنوة، عن أناس مثلنا، يشبهوننا تماماً، لديهم ما يحبون وما يكرهون، لديهم أمان وأكلات مفضلة وكرة يلعبون بها، وأمهات يطلبن منهم النوم باكراً، لكن ينقصهم أن يراهم العالم.
نتناوب على حلم عودة فلسطين، وكلّ جيل يُودع حلمه أمانة عند الجيل الذي يليه
اخترت أقرب نافذة على فلسطين، وطلبت منهم أن يفتحوها، من خلال مشاهدة مسلسل "التغريبة الفلسطينية"، بعدما أسهم هذا المسلسل بشكل كبير بتشكيل الوعي تجاه فلسطين في عقل طفليّ الصغيرين. وبعد انتهاء الحلقة الأخيرة، تنهدت طفلتي ذات التسع سنوات، وعلّقت على المسلسل بجملة صرت أردّدها دائماً وأستخدمها لأُسكت بها كلّ من يشكّك بقدرة الأطفال على استشعار الحقيقة. "حاسة ما لازم احضر أي شي بعد اليوم"، وكأنّها شعرت بالاكتفاء مما شاهدته ولم تعد تريد مشاهدة أي شيء آخر.
يستخدم طفلاي منذ ذلك الوقت كلمة إسرائيلي للإشارة لأيّ شرير في أيّ زمان وأيّ مكان، فقد صار الإسرائيليون بالنسبة لهما مرادفاً للوحشية والقتل والدمار والعنف.
هذه الحرب هي الحرب الأولى التي يشهدها طفلي على فلسطين، ولا أعتقد أنّها الأخيرة، كما لم تكن الأخيرة بالنسبة لي، أنا التي لم أتجاوز الثالثة والثلاثين من عمري، وقد شهدت أكثر من أربع حروب على فلسطين، وهي الحروب التي أسهمت بشكل أو بآخر بتشكيل هويتي الوطنية وحدّدت انتماءاتي والكثير من وعيي تجاه العالم وازدواجيته وقسوته. فاكتشفت على ضوء وصغر مصطلحات استخدمتها دائماً وحفظتها، أن عبارة "الكيل بمكيالين" مثلا هي واحدة من أكثر العبارات بلاغةً بالنسبة إليّ، وأكثرها تعبيراً عن النظرة الغربية لنا نحن الشعوب التي تعيش على هامش العالم كزائدة دودية لا يعني استئصالها لأحد أيّ شيء، فهم لا يكتفون بمحاولة اقتلاعنا من جسدِ العالم فقط، بل أيضاً يزايدون علينا بألم هذه الجراحة.
خبر عاجل هزّ منزلنا الصغير، وصل الطفلان بعده لاستنتاجٍ بريء، ولم يحتاجا لتأكيد منّا، بل صارا يقفزان ويصرخان بأعلى صوت "انتصرت فلسطين انتصرت فلسطين". كم تمنيت القفز معهما والصراخ أيضاً، لكن فرحة الكبار ستكون دائماً ناقصة، فنحن نعرف مسبقاً أنها فرحة آنية، وأنّ العقبى للخواتيم.
لا يكتفون بمحاولة اقتلاعنا من جسد العالم فقط، بل هم أيضاً يزايدون علينا بألم هذه الجراحة
تذكرت طفولتي، تذكرت فلسطين التي كانت قضيتي التي حملتها فوق ظهري قبل أن أفهم شيئاً عن القضايا والأوطان والانتماءات والصراعات. تذكرت كم قفزت قفزًا، وكم فرحت فرحًا، لخبرٍ عاجل، أو لجملة أسأت فهمها، واستنتجت انتصار فلسطين منها. تذكرت أشعار سليمان العيسى، حميدة الطاهر، دلال المغربي، وحنظلة الذي رسمته على دفاتري وكتبي المدرسية... ولكن ماذا يعني كلّ هذا؟ يعني شيئاً واحداً فقط، أنّنا نتناوب على حلمِ عودة فلسطين، وكلّ جيل يُودع حلمه أمانة عند الجيل الذي يليه، حلم خارج نطاق التحقيق، وبعيداً جداً عن الأضواء في آخر النفق، حلم يتاجر به، وتُبنى عليه السياسات، وتُؤلف من أجله الأحزاب، ويُباد بحجة قتله شعب كامل، شعب لم يحلم بأكثر من حياة بسيطة، ويوم عطلة عادي، وأرض، أرض لا يشاركه العالم كلّه عليها، ويطالبه في أحد الأيام بأن يحكم عقله ويسلمها ويرحل ببساطة.
دخلت في نقاشات عقيمة مع كثيرين، اتهموني بالدفاع عن طيش حماس، واتهموني أيضاً بالسذاجة، وعند هذه الفكرة بالذات توقفت كثيراً، فأنا فعلاً ساذجة جداً بحب فلسطين، ولم أدّع يوماً أنّي خبيرة في السياسة. ولا بالعلوم العسكرية، ولا بردّات الفعل وحساب العواقب، ولكنّي لا أستطيع بأيّة حال أن أسقط عن شعب كامل حقه بأن يقول هذه الأرض لي، ولو كان طائشاً في قولها، ولو لم يحسب حساباً لما قد يحدث، ففي مرّات كثيرة قد تكون البطولة في قول لا فقط، في الاحتجاج وعدم الرضوخ، أعرف أنّ الثمن الذي دُفع كان أكبر بكثير مما يقدر عاقل على احتماله، لكن هل كان الطيش سبب دفع هذا الثمن، أم أنّ السبب أنّ أحدا يمتلك القوة، وآخر ضعيف؟ أنّ طرفا يقف العالم كلّه خلفه، وطرفا لا يراه العالم من الأساس؟
لن تعجز إسرائيل يوماً عن اختراع حجة، ولن تحتاج حتى أيّ مبرّر، ولن تحتاج البحث، فما فعلته، فعلته عن دراية، وعن تخطيط، ورغبة، وما ترتكبه من جرائم لا ترتكبه أيضاً عن عبث، غاياتها لا تُخفى على أحد، ولكن غاياتنا نحن الذين نبحث دائماً عمن نلومه، هي الغريبة. فنحن ندرك تماماً أنّنا عاجزون عن محاسبة الجلاد، فنحاسب المجلود.
أشعر بالعجز وكثيراً ما أستيقظ وأنا أشعر بالاختناق، وأتمنى أن يحدث شيء ما ويتوقف كلّ هذا، ليس في فلسطين فقط، بل في كلّ مكان. ولكن ليس أمامي شيء، وليست لديّ حيلة، سوى أن أحكي لأولادي وطلابي عن فلسطين، ونبكي معاً.