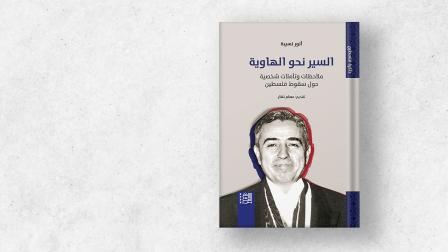يحكي لنا الكاتب المصري شادي لويس (1978) في روايتهِ الأخيرة "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة" (دار العين، 2021) حكاية العنف في الثقافة بكلّ ما تتضمنه مفردة شاسعة مثل "الثقافة" من مكوّنات، فاللغة والدين والسلطة والعائلة حاضرة في حكاية العنف هذه. الرواية مثالٌ على تلك المشقة التي يتكبّد عناءها الناس في شرق القاهرة، وفي غربها، ولربما امتداداً إلى الخليقة برمّتها.
التاريخ الذي يوجزه لويس في روايتهِ هو تاريخ العنف، العنف في السرديات الكبرى - ومنها النصوص الدينية - التي تؤثر في الثقافة على امتداد العصور، والعنف اليومي التراتبي الذي ينتقل في الأسرة من الأب إلى الأم، ومن الأم إلى الطفل، ومن الطفل إلى الحيوانات. ونراه في الخارج ينتقل من الجيش إلى الشرطة، ومن الشرطة إلى الناس. نراه ينتقل في اللغة من النص المقدّس إلى الكاهن، ومن الكاهن إلى الرعية. نراه في الرواية حروباً بين الدول كما في الحرب العراقية الإيرانية وهزيمة 1967، وأيضاً في المعارك التي تحدث في الشوارع ويتناوب عليها البشر في النهار والكلاب في الليل.
إنّ قراءةً في شكل هذا النّص الذي يستورد العنف من كلّ جانب، تأخذ بالقارئ إلى خلاصةٍ مفادها أنّ العنف بذاته أداة الروائي المثلى لتحفيز شخصياتهِ. إذ في البحث عمّا جعل السرد غزيراً تلقائياً ومتنوعاً في رواية اليوم الواحد، لا يحتاج القارئ وقتاً طويلًا كي يُدرك الممكنات التي صنعتها مشاهدات العنف لدى الراوي الذي استعادَ ذلك اليوم من طفولتهِ. في أحداث يبدو أنّها خرجت للتوّ من ذاكرة الطفل، على الرغم من مرور السنوات، نجد أنّ سِجِلَّ العنف يبقى جديداً دوماً، فحكاية العنف لا تجيزُ لضحاياه أن ينسوا. في ضوء هذا يُمثّل الطفل أولئك الذين يعانون من عنف يجهلونه.
التاريخ الذي يوجزه لويس في روايتهِ هو تاريخ العنف
تبدأ الحكاية بهروب الطفل مع والدته بسبب تعنيف الأب للأم أمام أقاربهم الذين كانوا في زيارة عائلية. ثُمّ ما إن تخرج الأم مع طفلها من المنزل حتى تتحوّل الرواية إلى مسارٍ آسرٍ من المشي الذي يرافق السرد. يمشي الطفل ووالدته في شوارع القاهرة، تتواتر الأسئلة بينهما، وفي تواتر الأسئلة يتوارى شعور الطفل بالخوف. وبعد ساعاتٍ من المشي، يُداري شعوره بالتعب وراء سؤاله عن الوجهة، ما يدفع والدته إلى الغضب منه. فالكنيسة التي لجأت إليها لم تستقبلهما، لكون المنزل يقع في مناطق نفوذ كنيسة أخرى، ولأنّها هاربة من منزل زوجها، وهذا حَدَثٌ خارج إرادة الربّ. إذاً، بات القارئ يعرف أنّ الأم لا تملك وجهة لهروبها. لكنّ الطفل يخشى ذلك ولا يعرفه.
خلال ساعات الهروب أعاد الراوي سرد مشاهدات قاسية من سنوات الطفولة المبكرة، وقد تقاطعت مع أحداث رافقت مسيره مع والدته. وهو يكتشف أُماً لِصّة، تسرق من محلات الألبسة بخفّةِ من اعتاد الظفر بمعارك صغيرة. يستعيد الطفل، شجارات الأب مع الأم، وكلاهما استخدمه شاهداً على تلك العلاقة التي لن تصل إلى نهاية إلا بموت أحد طرفيها. فالسيدة المسيحية المصرية تبحثُ عن خلاصٍ من زواجها، لا يتوافر لها سوى إن لجأت إلى الجامع الكبير. ما دفع السيّد المصري (زوجها) إلى استدعاء أقاربها، الذين عَرَضوا إخراج الجان مِنَ جسدها. في مشهد انتحار الأم، وهو مشهد متروٍّ وبارد، يوصل لويس حقيقة الموت ولا مبالاتهِ.
في تصويرهِ للجسد، لأماراتهِ وانفعالاتهِ، يخبرنا لويس ببراعةٍ عن جسدٍ لا يريدُ أن يقاوم الموت، عن جسدٍ انطفأت رغبتهُ في الحياة. فهو جسد امرأة، مهمتهُ فقط، أن يُتَقَاذَف بين الولاءات، وبين بيوت الجيران والإرساليات، وبين البيت والشارع. في غمرة الهروب الكبير، الذي يشبه سفراً من أسفار الخليقة، وفي يوم يشهد أعمال عنف ديني يستعيد الراوي ذكرى الحروب مع "إسرائيل"، ولا سيما هزيمة 1967. إنّه طفل، لكنّ الكاتب يستخدم ذاكرة الطفل بعدما اكتست الحوادث العارية وعياً، كي يعترف بهزيمة شاملة شهد فصولاً منها في نهاية الثمانينيات في مصر.
عدا عن مهارة لويس في بناء مشاهد حياتية تلقائية ودالّة، وبناء جملة سردية بسيطة تقدّم كلّ ما ينتظر القارئ معرفتهُ عن تاريخ الشخصية وبنائها النفسي، وعن العائلة المصرية وسياقها السياسي والاجتماعي وأنماط تديّنها. فهو يستخدم الحكايات - حتى تلك التي تبدو مفككة ومن دون سؤال جوهري - في الوصول إلى سرد منضبط غير انفعالي، كلّ حدث فيهِ يندرج في حدثٍ أوسع منه. مثل حكاية العنف التراتبي في مؤسسة الأيتام حيث فصلت الحكومة بين الأطفال بحسب دياناتهم، مسلمين ومسيحيين، إلى جانب من لا يعرفون دياناتهم.
يعترف بهزيمة شاملة منذ نهاية الثمانينيات في مصر
كما أورد لويس حكاية عن التجنيد الاجباري تتحدثُ عن فصل بين الضباط المتعلمين والجنود غير المتعلّمين، وأولئك الذين لا يعرفون إن كانوا أُميّين أو لا. بذلك فهي رواية عن العنف، عن الاستبعاد والتصنيف. أمّا المثال الأبرز للحكايات التي تبدو من غير طائل، فهي حكاية رجائي الذي تاه في شوارع القاهرة بسبب بناء الشركة السويسرية لحيّين متشابهين. كان رجائي يزور العائلة المصرية، ودخل حيّاً مشابهاً، وبذلك ندرك أنّ حكاية هذه العائلة في الشارع رقم 30، يمكن أن تكون حكاية أي منزل آخر، إنّها حكاية الجميع.
إلى جانب التقنيات السردية التي يستخدمها صاحب "طرق الرب" من تناص مع نصوص مقدّسة، وإدراج حكايات فرعية، وتوثيق معلومات. فإنّ الراوي بدورهِ يبتكر تقنياتهِ لتبديد ثقل اليوم، وتبديد قسوة الطفولة؛ إذ ينشغل في عد خطواتهِ داخل المنزل وخارجه. حتى في أكثر المواقف صعوبة، وهو يهرب برفقة والدته من الانفجار والنّاس، كان الطفل يعدّ الخطوات. وعندما يردّ على الكاهن بأنّ كنيسته أقرب لمنزلهم من الكنيسة في الحيّ الآخر بثلاث خطوات، يكتشف أنّ حُجّتهُ تنتمي إلى عالمهِ وحسب، فيما للكبار حُجَجٌ مختلفة تكشفها السنوات القادمة للطفل، ويعيدها الأدب إلى الواجهة.
* كاتب من سورية