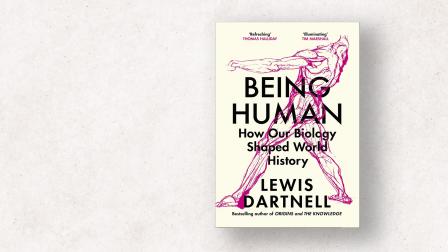في عام 1980، بدأت نصوص عبد الكبير الخطيبي تعود إلى لغتها الأمّ، التي لم يكتب بها، لكنّها حضرت مثل هاجس نفسيّ وفكريّ لديه. في ذلك العام، تلاحقت ترجمات أعماله من الفرنسية: "الاسم العربي الجريح" (ترجمة محمد بنيس)، و"في الكتابة والتجربة" و"ديوان الخط العربي" (كلاهما بترجمة محمد برادة)، و"النقد المزدوج" (ترجمة جماعية شارك فيها أدونيس وعبد السلام بن عبد العالي وزبيدة بورحيل وعز الدين الإدريسي).
أخذ الخطيبي بسرعة موقعاً أماميّاً في خريطة الثقافة العربية، وهو الذي أتت مقارباته ضمن طبقة صوتٍ أنضجَ ممّا كان متداولاً في سجالات المثقّفين العرب، وضمن دائرة أوسع من القضايا والمواضيع والمناهج. خدَمته الأجهزةُ المفاهيمية الجديدة التي طبّقها على ظواهر مغربية، مستنداً إلى توليفٍ طريفٍ بين علم الاجتماع والسيميولوجيا والأنثروبولوجيا ونظريات الأدب والفن، إضافة إلى نزوع نحو التأنّق الأسلوبي، ما يضع أعماله في منطقة تخومية بين الكتابة الفكرية والأدبية.
ولنَيل ذلك الموقع سريعاً، ربما خدمه افتتان بيروت - وقد كانت عاصمة النشر العربي، بلا منازع، آنذاك - بكلّ "بضاعة فكريّة" تأتي من المغرب، وكانت الدفعة الأولى من أعماله قد صدر معظمها عن "دار العودة". كذلك خدمته، أيضاً، شهرته الفرنسيّة التي كانت أصداؤها تصل إلى المنطقة العربيّة منذ عشر سنوات تقريباً، رغم إقامته في المغرب منذ منتصف الستينيات؛ فقد صدرت أعماله متلاحقةً في كبريات دور النشر الباريسية (غاليمار، ماسبيرو، دونويل...)، وحاور بعض "نجوم الفكر" الفرنسيّين بندّيّةٍ وصداقة، وقد راجت في هذا السياق شهادات رولان بارت وجاك دريدا حول خصوبة أعماله.
قد يوحي هذا اللقاء الأوّل بين مدوّنة الخطيبي والثقافة العربية بأنّ علاقة متينة ومنسابة ستُبنى بين مثقّف متغرّب (في اللغة على الأقل) وثقافته الأم كما لم يحدث مع أسماء عربية بارزة أخرى منذ ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، مثل هشام شرابي وأنور عبد الملك وسمير أمين وإدوارد سعيد ومصطفى صفوان. فقد حال التوغّل الفكري لهؤلاء في الثقافات الغربية دون وصول سلسٍ لأطروحاتهم، أما المفكّر المغربي، فقد أتى بخطاب أكثر رهافة، يقترب من المألوف والحسّي ولا يفترق عنه إلا حيناً لتهيئة القارئ بأدوات نظرية ضرورية، ومن ثمّ يعود إلى الغوص في نسيج العلامات الملموسة.
كان حريصاً على إبقاء المتن العربي محوراً لانشغالاته
لم يكن هذا اللقاء الأوّل غير حفلة كبيرة، أقرب إلى زفّة متأخرة. لعلّها تعبّر عن تكفير عن ذنب أكثر من كونها احتفاءً حقيقياً. ومن الواضح أن الطاقة الاكتشافية التي دفعت نحو كتابات الخطيبي سرعان ما نضبت. فبعد 1980 سيصل بعضُ ما بقي من الخطيبي في الفرنسية متقطّعاً: "المناضل الطبقي على الطريقة الماوية" (شعر، 1986، ت: كاظم جهاد)، و"صيف في استوكهولم" (رواية، 1992، ت: فريد الزاهي)، و"الذاكرة الموشومة" (رواية تخييل ذاتي، 1998، ت: وائل حلاق). لكنّ جزءاً من أعمال الخطيبي لم يصل إلى اللسان العربي بعدُ، أو لم يصدر في كتب جرى تداولها بشكل موسّع عربياً، ومن ذلك عمله الأشهر، ربما، في الثقافة الفرنسية، "كتاب الدم" (صدر أوّل مرة في 1979)، أو أطروحته الجامعيّة عن الرواية المغاربية، وكذلك الأمر مع "حبّ ثنائي اللغة" (1983)، المصدر الأكثر كثافة لالتقاط ملامح سيرته الذاتية.
ولنا أن نضيف، هنا، غيابَ مجموعة كتاباته الشعرية التي عُرفت بعنوان "تحابٌّ" وتمثّل وحدها من الناحية الكمّية ربع مدوّنة الخطيبي كما يتجّلى ذلك في أعماله الكاملة التي أصدرتها منشورات "لا ديفيرانس" عام 2008. لا داعي لأن نذكّر بأن الثقافة العربية لم تفكّر في مشروع كهذا، حيث تغيب فلسفة جمع الأعمال الكاملة عن مدوّنات المفكّرين والباحثين، إلا في ما ندر.
كانت حفلة الـ1980 تُخفي بضجيجها الكثير من الخطيبي، بما في ذلك جرحٌ لعلّه أكثر إيلاماً من "جُرح الاسم". فحين عاد الفتى من "السوربون" بدكتوراه في تخصّص علم اجتماع الأدب إلى المغرب، كان يأمل توطين المعرفة التي حصّلها في بلاده. لأوّل وهلة، بدا كل شيء ملائماً. فقد وافقت عودته إطلاق مشروع "معهد السوسيولوجيا" بجهود عالم الاجتماع الفرنسي - المغربي بول باسكون (1932 - 1985)، الذي أحاط نفسه بمجموعة من الباحثين الشباب، ومنهم الخطيبي وآخرون بتنا نعرفهم اليوم جيّداً، مثل عبد الله العروي وعبد الله حمودي وحسن رشيق.
كان هدف المعهد وضْع لبنة لتأسيس بُنية تحتيّة للبحث العلمي ضمن العلوم الاجتماعية. أما على المستوى النظري، فقد اشتبك الباحثون المغاربة بجرأة مع مشروع تجاوز الخلفيات الكولونيالية للعلوم الاجتماعية، وبدا أنهم يخطون خطوات حاسمة في هذا المسار. لكن، وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يجد مشروع كهذا دعماً سياسياً لنجاحاته المعرفية وبدايات إشعاعه عالمياً، قرّر الحسن الثاني في 1970 إيقاف نشاط المعهد. صادف ذلك تسلّم الخطيبي إدارته، وليس من العسير أن نتخيّل مشاعر الإحباط التي غمرت الباحث الشاب وبقية زملائه.
كل ما في الأمر أن السلطة شعرت بمدّ يساري لدى جماعة الباحثين الشبّان، فميولاتهم الماركسية واضحة، ولا تزال رياح ثورة أيار/ مايو 68 الفرنسية تعصف بأذهانهم، إذ كانوا شهوداً عليها - من قريب أو بعيد - في جامعات باريس. انطلاقاً من التشدّد الذي اتّسمت به السلطة السياسية في المغرب وقتها، مثّل الخطيبي بالذات نوعاً من الإزعاج. فقد كان - مثلاً - من بين مؤسّسي نقابة التعليم العالي، وكان الحديث عن تثوير العلوم الاجتماعية، وخصوصاً تقنيات البحث الميداني، أمراً كافياً لإرعاب الحرصاء على تكريس الوضع السائد.
لا يزال طموحه إلى "نقد مزدوج" يراوح مكانه عربياً
هكذا، وتحت عنوان احتمال أن يكون مصدرَ "وجع رأس" للسلطة، ذهب مشروع توطين المعرفة السوسيولوجية هدَراً في المغرب، وربما في مجمل البلاد العربية. ربما كانت قدرة الباحثين الجدد على الزعزعة النظرية لمقولات المعرفة الغربية سبباً آخر في تخوّفات السلطة، فكيف سيكون الحال إذا اشتدّ عودُهم وقارعوا مقولات النظام والبُنى الثقافية والعقائدية القائمة. من هذه الزاوية، كان من الضروري، إذاً، خنق المشروع الوليد في مهده. لقد ساد في سنوات الرصاص القتلُ على الشُّبهة، وذلك ما حدث تقريباً مع "معهد السوسيولوجيا"، وبشكل من التعميم مع العلوم الاجتماعية، وإن تفرّع المشروع لاحقاً إلى اجتهادات فردية حقّقت نتائج طيّبة.
يبقى أن هذا الإجهاض لتطلّعات جيلٍ لا يمكن إلّا أن نراه كحركة قمع بطريركية من المؤكّد أنها سبّبت جرحاً عميقاً في نفس الخطيبي. فقد اندثر - ربما إلى الأبد - حلم مأسسة العلوم الاجتماعية في المغرب، وتبعثرت أوراق الباحثين الشباب، وتزامن ذلك مع اختناق سياسيّ ودوامة محاولات الانقلاب على الحسن الثاني (1971 و1972)، ودخول نفق مظلم من صدامات بين الدولة والمجتمع لا شكّ في أنها أجّلت كل محاولة استئناف. وحتى عودة المعهد للنشاط في 1975، باسمٍ جديد - "المعهد الجامعي للبحث العلمي" (سيشرف عليه الخطيبي) - لم تُعِد الروح إلى الطموحات الأولى، وبدا أن بريق المشروع الأصلي قد انطفأ نهائياً.
يمكن أن تُفسِّر هذه السياقاتُ الكثيرَ من المنعطفات اللاحقة في مسار الخطيبي، من ذلك مواصلة التأليف بالفرنسية التي باتت تمثل تعويضاً لما يفتقده الباحث والكاتب داخل وطنه. وهنا ذهب الخطيبي نحو مزيد من الانزياح التدريجي نحو الأدبيّ - الذاتي، سرداً وشعراً، ليصبحا الحامل الأساسي لكل ما هو بحثيّ أو فكري. كذلك اختار مواصلة إصدار أعماله في دور نشر فرنسية.
لا تخفى هنا حسابات الرواج والرغبة في الانتماء إلى ثقافة نقاشيّة مفتوحة، لكن يبدو الخطيبي في كل ذلك وكأنه اختار الحلول المريحة، وفضّل أن يدير مسيرته بنوع من المسايرة كي يكون التعايش ممكناً مع نظام قمعي. وقد تجلّى ذلك بالخصوص في الثمانينيات حين أشرف على مشروع سوسيولوجي آخر؛ "المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع"، سرعان ما تركه يذوي منتقلاً إلى مشروع أقلّ مواجهة باسم مجلة "الأزمنة الحاضرة". ويمكن أن يفسّر انحسارُ اليسار عالمياً، في منعطف التسعينيات، بعضاً من الانكسار النفسي لصاحب "الذاكرة الموشومة".
لكن من الضروري التنويه بأن الخطيبي، ومع مفارقته للثقافة العربية لغةً، كان حريصاً على إبقاء المتن العربي محوراً لانشغالاته، كمواضيع بحث وكعلامات يتأمّلها. وبما أنه يفعل ذلك في لغة أجنبية، فقد جعل من عناصر الثقافة العربية (الوشم، النصوص المقدّسة والشفهية، الممارسات، الخط...) مرجعيّةً في متون الفكر الغربي. ولعلّ مدوّنته تمثّل النموذج الذي قطع مسافة أطول في دمج ما يتعلّق بالثقافة العربية ضمن المرئي في الغرب.
ربما جاءت تلك الشهرة العربية بعد 1980 كعزاء للخطيبي في غربته اللغوية، لكنها هي الأخرى كانت حمّالة لمجموعة من الإخفاقات، فهي في النهاية تكشف النفَس القصير لجهاز الترجمة العربي. وحين نأخذ مسافة من كل ذلك، سيبدو أن مجيء الخطيبي إلى الثقافة العربية كان أقرب إلى تقليعة. لم تتغلغل خياراته الأسلوبية في الكتابة العربية، وبقيت المنطقة التي تحرّك فيها بين الأدبي والفكري فقيرةً كما كانت، وحتى تلك النقلة التي تحدّث عنها محمد بنّيس في مقدّمة "الاسم العربي الجريح" بأخذ الثقافة العربية من "حديث كتُبٍ عن كتبٍ" إلى توفير أدوات لملامسة الواقع الحي، لم يتحقّق منها الكثير.
قد تكون غربته اللغوية خياراً واجه به انكساراته النفسية
ولننظر أيضاً إلى دعوته الأبرز؛ النقد المزدوج ببعديه: نقد المعرفة الغربية ومقولاتها حولنا، ونقد البنى الثقافية المحلية وكسر امتناعها عن البحث والدراسة. إنها أهداف لا تزال تراوح مكانها. في زمن الخطيبي، كان يمكن الحديث عن لحاق - ولو متأخراً - بالمنتج المفاهيمي الأوروبي. وفيما تضخّم هذا الأخير، تباطأ نسق الملاحقة العربية؛ وبالتالي، كيف يمكن نقد المعرفة الغربية في ظل توسّع فجوة إنتاج المعرفة، بحيث يبقى أكثر الفكر غائباً في متداول الثقافة العربية. بقي النقد المزدوج مصطلحاً كبيراً، يحضر كشعار لا أكثر، وليس كاستراتيجية معرفية كما أملَ الخطيبي. ثمّ، ها إنّ أعمال جيله لا تزال الأكثر جرأة والأكثر احتكاكاً بالواقع.
إذا أمعنّا النظر أكثر، سنجد أن ترك مدوّنة الخطيبي في منتصف الطريق - بين الغياب والحضور - له أسبابه الموضوعية. ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أننا نستقبل الخطيبي من داخل ثقافتنا العربية التي كان المفكّر المغربي قد حرص على أخذ مسافة منها، ليس تعالياً بالضرورة، بل كجزء من تصوّره لـ"النقد المزدوج"، بما يفرضه من مسافة مع الثقافة الأصل، كما يفرض مسافة مع الثقافة التي يأخذ منها أدوات بحثه.
هناك أيضاً ما أشار له بنّيس، وقد يشاركه في القناعة نفسها كلُّ مترجمي الخطيبي، حيث إن مواجهة نص صاحب "الاسم العربي الجريح" تضعنا أمام "ما لم تعرفه العربية" من مصطلحات وتراكيب، وأحياناً "ما لم تعرفه الفرنسية" أيضاً. وهذه الوضعية بعثت الكثير من التهيّب لدى من يتطلّعون إلى ترجمته، ولا سيّما حين نلمس رهافة التناول الفكري الذي تتميّز به كتابات الخطيبي، وتلك الانتقالات الخاطفة بين المتون والعوالم الدلالية، أو المسالك المفضية إلى اكتشافات العلاقات الخفية بين الأشياء، التي يُهيّأ لها ما يشبه السيناريو السردي. ومن ذلك ربطه بين المثَل الشعبي والجسد، حيث يُثبت أن الأخير قد جرى تلبيسه بفضاء رمزي مقنّن، بقصد السيطرة عليه، ومن ثمّ يصبح تنظيم الحياة قائماً على الذاكرة النصية (المكتوبة والملفوظة). ولاحقاً يتوسّع الخطيبي أكثر، فيلاحظ أن الخطّة ذاتها تُعتمَد للسيطرة على الفضاء (إخضاع الصحراء بالقصيدة).
فجأة، يرمي الخطيبي بملاحظة تُثري نظريّته دون أن تقطع سياق تفكيره، فينتقل بالظاهرة إلى ثقافة أخرى، ليجد أن إرادة السيطرة على الجسد من خلال المتون تحضر بشكل آخر في الثقافة الغربية، حين يكشف أن مفردتي جسد Corps ومتن Corpus، في الفرنسية، ملتبستان أو، بعبارته، "يسكن كل واحد منهما في الآخر".
هذه التنقّلات الشطرنجية نادرة في ثقافتنا العربية، وبالتالي يتحوّل تعريبها إلى تمرين مضاعف. تعقيدٌ آخر قد يكون سبباً في تعطيل علاقة التبادل بين العربية ومدوّنة الخطيبي، يتمثّل بالخيارات الأجناسية. في الأعمال الكاملة، التي أصدرتها منشورات "لا ديفيرانس"، خُصّص المجلّد الأوّل للسرد والثاني للشعر، والثالث لـ"المحاولات"، باعتبارها جنساً من أجناس الكتابة يجمع بين الذاتيّ والفكري. هذا الشكل من الكتابة شبه غائب في ثقافتنا، أو هو حاضر دون تسمية أو تمثّل واضح، وبالتالي إن ما يقع ضمنه يكون في جزء كبير منه غير مرئي عربياً.
هل لنا أن نضيف إلى هذه الأسباب معركة وراثة الخطيبي، ليس فقط على مستوى حقوق ترجمة أعماله ونشرها، بل أيضاً تلك المعركة بين الخطيبي الفرنكفوني، بحكم النصّ، والخطيبي الذي آن له أن يتحدّث بالعربية ولو بعد رحيله؟
لو أننا أردنا تخيّل وصيّة فكرية للخطيبي، فهل لهذه الوصية ألّا تشير إلى عودته إلى العربية، باعتبارها ضرورة للطرفين، أي للخطيبي والثقافة العربية. كيف لمغامرة معرفية كهذه أن تبقى خارجنا؟ كيف لمغامرة منطلقُها العلامةُ العربية ألا يكون منتهاها هنا؟
وكم تَعُدّ ثقافتنا من مغامر معرفيّ مثل عبد الكبير الخطيبي؛ الباحث بالمعنى العميق للكلمة، ذاك الذي يذوّب التخصّص والسياقات في تجربته، ويفتح لنفسه منطقة معرفية خاصة. ضمن هذا التعريف، فإن ما يبقى هو ما يؤسّسه الباحثون، حين يطلّون على بئر العلاقات العميقة التي تنظّم العناصر المركِّبة للعالم.
إلى متى نُقصي جزءاً من الرحلة التي جعلت الفكر الغربي يشعر بأنه "في الطرف الأقصى من ذاته"، بحسب عبارة رولان بارت؟ نعرف أن الكثير من هذا ضائع منّا إلى الآن، مفلت في مدارات بعيدة عنا، والمفارقة أننا "المرسل إليه" الأصلي. هناك الكثير ممّا يزال ضائعاً، لكنه مسموع ومقروء في لغة أخرى.