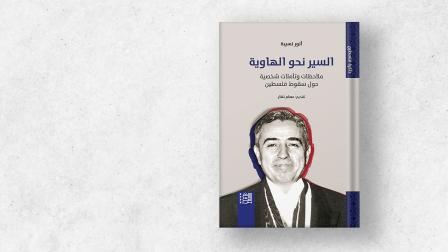"إذا كان القرن السابع عشر هو قرن الرياضيات، والقرن الثامن عشر قرن الفيزياء، والقرن التاسع عشر قرن البيولوجيا، فإن القرن العشرين هو قرن الخوف". هذا حسب الروائي الفرنسي ألبير كامو. ما نعرفه فعلًا، ونتذكّره، ولم ننسه بعد، هو أن الخوف قد هيمن على القرن العشرين. فخلاله ظهرت أربعة أنظمة شمولية؛ الستالينية والنازية والفاشية والصينية، إضافة إلى حربين عالميّتين، امتدّتا من أوروبا إلى قارّات العالم الأخرى. ضحايا هذا القرن زادت عن مائتي مليون، وخراب بلدان وعواصم ومدن. كان العالم خائفًا، حتّى أن الحرب الباردة لم تكن باردة؛ كانت مرعبة، هدّدت البشرية بحرب نووية. وإن لم تكن أكثر من حرب جواسيس، فالبشر كانوا تحت رقابة الأعداء من الطرفين.
ماذا عن القرن الواحد والعشرين؟ هل سيشهد انتشار الحرّيات، بعد سقوط جدار برلين، وانهيار الاتّحاد السوفييتي وتمزّقه، وانفراط عقد تكتّل اشتراكيات شرق أوروبا، أم عودة الدكتاتوريات؟
كان المتوقّع انتشار الحرّيات؛ بدأت بوادره أواخر القرن الماضي بالثورات المخملية والملوّنة التي عمّت أوروبا. غنيٌّ عن البيان، في هذا القرن ترسّخت حرّيات المثليّين في الغرب، بإجراءات طاولت الزواج والتبنّي والتمتّع بالعلنية بحماية القانون. وكان من المتوقّع أيضًا الانتصار النهائي للديمقراطية كنظام وحيد يشمل العالم؛ بذلك ينتهي التاريخ، لكنّ التراجعات بدأت من روسيا، بانتهاج نظام ليس دكتاتوريًا ولا ديمقراطيًا، كان مزيجًا منهما. وهو ما سوف تسير على خطاه بعض الدول: مظهر ديمقراطي وفي الحقيقة دكتاتوري، وكأن الديمقراطية تتلخّص ببرلمان يمكن السيطرة عليه، وانتخابات قابلة للتزوير. والأسوأ تعالي أصوات العنصريات في أغلب بلدان الديمقراطيات، فالحرّيات سمحت بإطلاق نيران العداوات على أنها حرّية رأي، ولو أدّت إلى سقوط ضحايا، أو إلى تغيير أنظمة حكم، ما شكّل تراجعًا عن قيَم حضارية عانت البشرية طويلًا حتى وضعت لها الأسس، بعد ثورات دامية وتجارب ومِحَن دفعت أثمانها باهظةً.
لم يسبق أن شهد العالم هذا القدر من الشعبوية ضد المهاجرين
كأنّ لكلّ حدثٍ ما يعاكسه، ليس من الضروري أن يكون ردًّا عليه. فالعالم كما يبدو لا يكسر قيوده، قدر ما يستعيد القديمة، كأنما الحنين يستجرّه إليها، أو يبتدع قيودًا جديدة. فالبشرية ليست في تقدُّمٍ دائم، بل في تقدُّم وتراجع. والتقدُّم مهدَّدٌ بالمخاوف، تأتي اليوم من الغرب الذي كان يشكّل ضمانة لحرّية الفرد، بينما هو يتنصّل منها، على أمل أن تكون حِكرًا عليه، وبينما يكاد يتخلّى عنها، قد تخسرها شعوبه، مع تزايد نزعات الكراهيات.
لم يشهد العالم هذا القدر من انتشار الشعبوية ضد المهاجرين؛ تبدو أشبه بجائحة لم تستثنِ بلدًا. لبنان مثلًا، رغم ما يجمعه مع السوريين من أواصر ــ أحدها النقمة على نظام قاسٍ عانى منه كلاهما. ففي البلد الشقيق تتصاعد دعوات عنصرية تطالب بطردهم مع توفير الاعتداء عليهم. كذلك في أوروبا، حيث استثمرت الأحزاب اليمينية المتطرّفة دعاياتها الانتخابية بالتخلُّص منهم في فرنسا وهنغاريا والنرويج والدنمارك وهولندا وأيضًا تركيا. ولم تقصّر غيرها من البلدان، فالدعوات الشعبوية المضادّة للمهاجرين قابلة للعدوى، تقدّم مادّة لتحميلهم خسائر وكوارث اقتصادية مع انتقادات استفزازية حضارية وأخلاقية مجحفة، ترافقها اعتداءات فردية متبادلة. وبدلًا من التعاطف معهم ومساعدتهم، تحرّض الأحزاب اليمينية عليهم، وتُظهر تأييدها للأنظمة الدكتاتورية التي كانت سبب مغادرتهم بلدانَهم.
طبعًا، لا بدّ من التأكيد على أن الكثير من الحكومات والأحزاب أبدت تعاطفها مع اللّاجئين، ولعبت أدوارًا مناهضة لطردهم وإيذائهم، ولولاهم لجرى إلقاؤهم في البحر، أو أعيدوا إلى بلدانهم رغمًا عنهم، مع معرفة أن الذي سيستقبلهم حواجزُ النظام، والاعتقال قيد التوقيف، ريثما يجري التحقيق معهم، بانتظار السجون والمحاكمات، وربما الإعدام أو احتجازهم سنواتٍ طويلة، إنْ لم يُضيّق عليهم ويُوضَعوا تحت المراقبة.
هذا القرن مرشّحٌ ليكون قرن الصراع بين مفاهيم الحرّية والتكافل الإنساني والتقدّم الحضاري الذي أحرزته البشرية، وبين تيّارات تحمل مجموعة من المفاهيم: من القومية المتشنّجة، والعزلة المتنفّجة، والثقافة المنحازة، والتفوّق الحضاري... ستتذرّع بها الأحزاب، وتجد مَن يستمع إليها، ولن يكون تفسيرُها يقلّ إن لم يجارِ ويشابه دعواتِ النقاء العرقي، تحت دعاوى قديمة مهزومة عن أعراقٍ عُليا حضارية ذات ثقافة متقدّمة، في مواجهة أعراقٍ دنيا ذات ثقافة متخلفة. هذه النزعات المريضة، تعمل عليها هويّاتٌ أنانية، يدعمها عِلمٌ مشبوه، وثقافة منحطّة، وعلمانية متحجّرة، ودعوات انعزالية.
إذا كان هذا ما يبشّر به القرن الواحد والعشرون، فقد خطا هذا القرن خطوات سريعة نحو تأصيل الهمجيّة.
* روائي من سورية