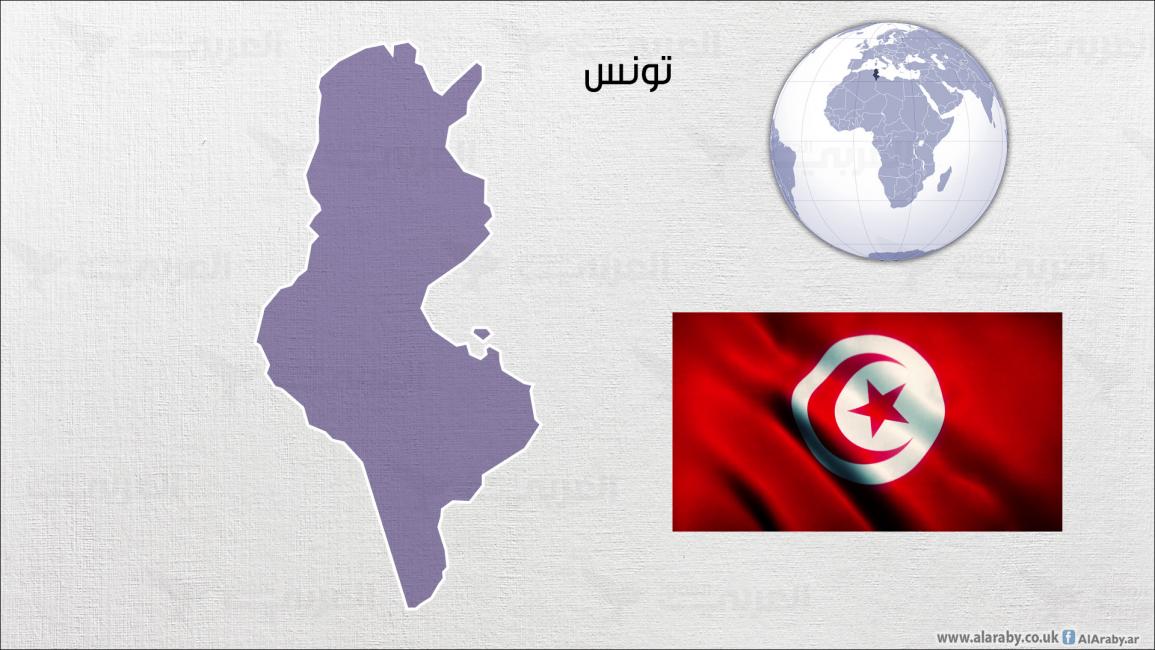بحثًا عن الجمهور التونسي المفقود
منذ إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قراراته التي تركز كل سلطات الدولة في يده، في 25 الشهر الفائت (يوليو/ تموز)، انشغل المجال العام العربي بمستقبل تونس السياسي، ومآلات خطة سعيّد الواضحة لتهشيم النظام الديمقراطي.
أول ما يتبادر إلى ذهن الحريصين على النظام التونسي الوليد السؤال: أين الناس؟ أين الجماهير التي تخرج لحماية التجربة الديمقراطية ومكتسبات الثورة قبل عشر سنوات؟ ويقترن السؤال طبعًا بصورة المتظاهرين الأتراك الذين وقفوا أمام دبابات المحاولة الانقلابية في تركيا في يوليو/ تموز 2016. علاوة على الفروق الأساسية بين المحاولة الانقلابية التركية و"مشروع" الرئيس (المنتخب) سعيّد، وبغض النظر عنها. هنا نجابه أولى العثرات في تفكيرنا بشأن الديمقراطية وعلاقة القطاعات الاجتماعية بها: الدفاع عن الديمقراطية اجتماعيًا، والاستعداد للتضحية لأجلها، لا يحدثان لمجرّد الإيمان بالقيم الثاوية فيها. الحريات العامة مثلًا مسألة ملحّة عند طبقات اجتماعية وشرائح مهنيّة محدّدة لا تقوم لنمط حياتها ونشاطها قائمة بدونها، ولكنها ليست همًا اجتماعيًا شاملًا في الديمقراطيات الراسخة (كما رأينا في الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب) بلْه الديمقراطيات الوليدة. الدفاع عن الديمقراطية من أسفل وبمواجهة السلطة يحتاج على الأقل أحد أمرين: تكوين الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي توسّع قواعد الديمقراطية في المجتمع، واتفاق النخب السياسية الديمقراطية على مواجهة المحاولات الانقلابية وقدرتها على حشد الجماهير تصديًا لها. من هذه الزاوية، لا تبشّر الحالة التونسية بالخير؛ لأسباب موضوعية وذاتية.
القوى الديمقراطية تكتفي حتى الآن بتسجيل الموقف والبحث، الصادق والوطني، عن تهدئةٍ أمام طرف من الواضح أنه لا يريد أكثر من هذا السلوك من خصومه
لم تنجز القوى السياسية الديمقراطية، طوال عشر سنوات، تقدمًا في حل المسألة الاجتماعية - الاقتصادية (البطالة، وفروق التنمية بين الداخل والساحل، على سبيل المثال)؛ أي أنها عجزت عن ربط الجماهير بالديمقراطية عبر التنمية، وهو ربط غير سببي بالطبع؛ فلا علاقة ضرورية للديمقراطية بالتنمية تاريخيًا، وكثير من الاقتصادات الصناعية والمجتمعات الحديثة في عصرنا بنتها ديكتاتوريات، بل وحتى فاشيّات، وليس أنظمة ديمقراطية، ولكنه ربط ضروري في الحالة العربية تصليبًا للديمقراطية الناشئة، واحترامها في الثقافة السياسية للمجتمع. كما أن القوى الديمقراطية التونسية لم تظهر سرعة الحركة وتقدير خطورة الموقف بحشد الناس للمواجهة، إما إشفاقًا من مغبّات الصراع أو عجزًا عن التواصل مع القطاعات الشعبية ومطالبتها بالتضحيات، وهذا أكثر ما يثير القلق في الحدث التونسي برمته. القوى الديمقراطية تكتفي حتى الآن بتسجيل الموقف والبحث، الصادق والوطني، عن تهدئةٍ أمام طرف من الواضح أنه لا يريد أكثر من هذا السلوك من خصومه، حتى يمضي في مخططه. وسعيّد ليس ساذجًا ليتوقع أن تقف معه القوى البرلمانية التي تضربها قراراتُه، على الأقل في بداية الصراع، ويكفيه ألا تذهب إلى المواجهة عبر الشارع.
لم تصطفّ قوة سياسية وازنة مع قرارات الرئيس سعيّد حتى كتابة هذا المقال، وحتى ما يقال عن دور للجيش يقع بين المبالغات الفجّة وتأثير الصدمة المصرية التي لم يستفق منها المجتمع السياسي في مصر كما ثبت مرّة جديدة من تعليقات المعارضين المصريين على مجريات الأحداث في تونس. أما عمليًا، فالجيش (يجب الحذر منه دائمًا) يتصرف بوصفه جيشًا مهنيًا يخصع للسلطة المدنية؛ خصوصا وأن ديباجة كل ما يفعله الرئيس دستوري، بغض النظر عن تهافتها بحسب القانونيين الذين علقوا على مستوى دستورية قراراته، وليست وظيفة الجيش تفسير الدستور. خطورة مبالغة القوى السياسية الكبيرة في لعب دور الحكيم هي في أن الوقت لصالح سعيّد، وليس في صالحها؛ فجهاز الدولة والتشكيلات السياسية الكبرى والتنظيمات المدنية القُطرية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يصطف مع سعيّد تمامًا، ولكنه لم يأخذ المسافة نفسها منه أيضًا؛ بعضها ممتعض، وبعضها يريد لعب دور الوسيط، والآخر يقف في الوسط متربصًا ينتظر إلى أين ستتحرّك الأمور.
منذ بداية "انقلابه على الدستور"، حشد سعيّد أنصاره وأنزلهم الشارع تخويفًا للجميع من مغبّة إنزال معارضيه حشودهم و"العنف الذي سيفجره"
سيكون من الصعب على "الطرفين"، الرئيس والقوى الديمقراطية، الانتصار في هذه المعركة بدون استقطاب هذه القوى المتردّدة، الواقفة في الوسط، إلى صفّه. لا يضيّع سعيّد الوقت. منذ بداية "انقلابه على الدستور"، حشد أنصاره وأنزلهم الشارع تخويفًا للجميع من مغبّة إنزال معارضيه حشودهم و"العنف الذي سيفجره"، ويجري تغييرات وتعيينات في مختلف أجهزة الدولة المدنية والأمنية، محاولًا زحزحة الأمور وتغيير توازن القوى والاصطفافات التي لا ترجّح كفته ولا تؤهله لحسم الصراع نهائيًا، ويصدر قراراتٍ تلو أخرى منذ 25 يوليو تسحق البرلمان سحقًا. ومن الواضح أنه يتحصل على دعم إقليمي (سعودي - مصري على الأقل) ولا يتحصل خصومه على دعمٍ مماثل. وإذا استمر في استكمال هذه الخطوات وتطويرها بدون أن تتفق القوى الديمقراطية على مجابهته، بحشد قواعدها وجماهير الشعب التونسي إلى الشارع (إذا كانت قادرة على ذلك بالأساس)، فإن تطاول الزمن سيمكّن الرئيس من تصوير الصراع على مستقبل تونس إلى مجرّد خلاف قانوني في تأويل النص الدستوري. كما أنه سيتمكّن من شق معسكر معارضيه (أو بالأحرى معسكر غير المصطفّين معه) داخل جهاز الدولة وفي المجتمع السياسي، وكلما كان معسكره أوسع تطور الدعم الإقليمي له كمًا وكيفًا وجرأةً، وهكذا سيُحسم الصراع لصالحه وينتهي الأمر.
من هذا التحليل السريع، تبدو أمامنا ثلاثة مخارج حفاظًا على الديمقراطية: تراجع الرئيس عن قراراته بالضغط الداخلي بمستواه الراهن، ضغط دولي للرجوع إلى المسار الديمقراطي والدستوري، ومجابهة قرارات الرئيس شعبيًا بتظاهراتٍ توسّع معسكر معارضيه، وتزيد من حالة الاستقطاب في الصراع ضده، بحيث يُجبَر على التراجع عن محاولته الانقلابية عبر مخارج لائقة، مثل عقد حوار وطني، ولكن بشروط وضمانات معينة بالطبع، فلا عاقل سيثق بعد الآن بهذا الرئيس. لا أقول إن المخرج الثالث، المواجهة الشعبية السلمية، مضمون النجاح، ولا إن حسابات القوى الحزبية الديمقراطية ومخاوفها كلها خاطئة، ولكنه أفضل (وأرحم) من التعويل على المخرجيْن الأول والثاني؛ هما، علاوة على ضعفهما (وليس استحالتهما)، من علامات البؤس والرثاثة التي لا تليق بمجتمعٍ افتتح حقبةً ثوريةً لأمةٍ بأكملها حلمت بالديمقراطية والعدالة والسيادة.