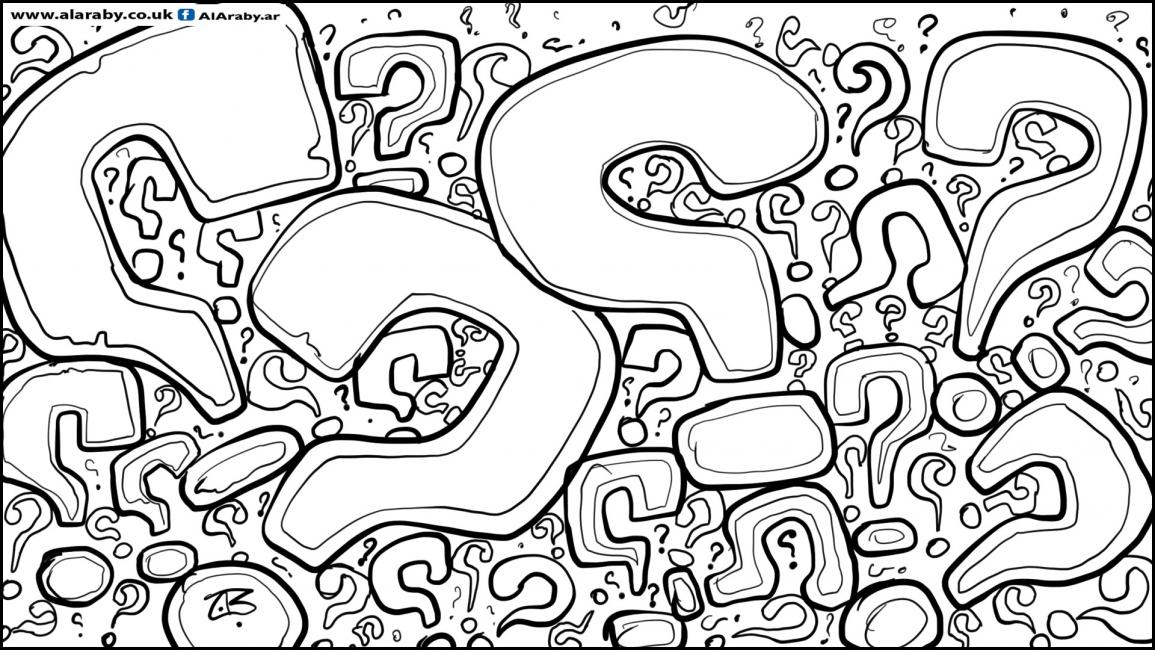عن الأسئلة التافهة وأصحابها

لا تصنع الأنظمة السياسية أنماط تديّن... يمكنها ذلك، ولديها أدواته، لكنّها لا تتكبّد مشقته، أو مخاطرته، إنّما تستثمر في أنماطٍ موجودةٍ بالفعل، ترفع أقواماً وتضع آخرين، تزيح المتن لصالح الهامش أو العكس، وفق مصالحها أو إكراهاتها، خطاب رسمي على السطح، وآخر، أكثر من رسمي، في العمق، تمنحه السلطة مساجدها، وتشتمه في مسلسلاتها، تسمح له بتلقّي تمويلاتٍ خارجية، من حلفائها، ثم تزايد عليه وعلى حلفائها. تتعدّد وسائل اللعبة، وحيلها، وخططها، لكن الهدف واحد، التسديد في مرمى المجتمع لصالح من يحكمونه. بدأت اللعبة في مصر مع الاحتلال البريطاني، واستفاد منها فاروق الأول في اللعب مع حزب الوفد بالإخوان المسلمين، وردّها "الوفد" بالطريقة نفسها، لكنها تحولت مع أنور السادات من اللعب بالورق إلى النار التي التهمت السادات نفسه، ربما لأنّه لعبها بقواعد الولايات المتحدة التي ظنّ، مبالغة منه، أنّ 99% من أوراق اللعبة معها، فسلّم نفسه.
بعد ثورات الربيع العربي، وجدت السلطة نفسها أمام رافدٍ جديدٍ للمعلومات، لم تفهمه، أو تحسب حسابه، وهو وسائل التواصل الاجتماعي. درسته، وفتحت جيوباً، منها الديني، طبعاً، وصار لديها "وعّاظ سوشيال ميديا" بعضهم بالتنسيق، تصنعهم في أجهزتها، ثم تطرحهم بوصفهم أبطالاً، وأحياناً معارضين، وضد توجّه الدولة (!)، وآخرين "تسمح" لهم بالوجود، من دون تعقّب، أو اتفاق، ذلك لأن ما لديهم كاف، من دون تدخّل أو تنسيق أمني، أن يحقق المطلوب وزيادة.
أحد أهم خطط اللعبة المجرّبة والمضمونة إعادة طرح الأسئلة التافهة، بعد منحها أبعاداً عميقة ومركّبة وخطيرة، هل يجوز تهنئة النصارى بالكريسماس؟ يأتي السؤال من جراب الحاوي نفسه، الذي شغلنا ثلاثة عقود بأسئلة: هل يجوز كشف وجه المرأة... حلق لحية الرجل... إسبال الإزار... لبس البنطلون... الشرب واقفاً... التبول واقفاً؟ ومئات غيرها، ومثلها، لا تقل تفاهة وبديهية، منتهية الصلاحية، الخلاف حولها "متفّق عليه" والآراء حولها معروفة، ومحفوظة، وتسمح بأن يأخذ كلٌّ ما يطمئن إليه، وينتهي المشكل الذي لم يكن يصحّ أن يبدأ أصلا، لكن أصحاب الأسئلة التافهة، والخطابات التافهة، والقضايا التافهة، نجحوا في تحويل هذه اللا أسئلة إلى أسئلة العصر، وتحويلها من فرعياتٍ إلى كليات، ومن متغيّرات إلى ثوابت، ومن مناطق الخلاف إلى "الإجماع المتخيّل". وإذا حاول أحدهم أن يصحّح المسار، أو يختلف، بوصفه من أهل الاختصاص، (شيخ الأزهر مثلاً!)، فهو جاهل بالضرورة، أو عالم سلطان، أو منبطحٌ أمام الغرب، أو متأثر بالثقافة الغالبة، أو جزء من مؤامرة، أو هو المؤامرة كلها، وهكذا.
أصحاب الأسئلة التافهة موجودون، طوال الوقت، أرادت السلطة أم لم تُرد، لكنهم يتحوّلون من موجودين إلى مؤثّرين حين تسمح السلطة بذلك، الدولة، خصوصاً الاستبدادية، هي المسؤول الأول عن تدفق المعلومات، ولا أحد يمكنه الوصول والتأثير، من دون رخصتها، أو "تمريرها"، وهو ما ينطبق على الخطابات الدينية وغيرها، الشيوخ وغيرهم، الإسلاميين وغيرهم، سواء عرف "الموظّف" أم لم يعرف، فهو يخدم، أن يستخدم، بإخلاص، ووجودُه مرهونٌ بتحقيقه الفائدة من ورائه. وهي ليست، كما يبدو، شغل الناس أو إلهاءهم فحسب، إنما صرفهم عن الأسئلة الواجبة، وتأخيرهم خطوتين إلى الخلف مقابل كل خطوةٍ إلى الأمام، وإعادتهم إلى ما قبل صفر المحاولة للتقدّم، وإنهاكهم، وتعميق خلافاتهم، وتحويلها إلى نزاعاتٍ وعداواتٍ وثاراتٍ موروثة، من جيلٍ إلى جيل، ومن تجربةٍ إلى أخرى، راسخة، متجذّرة، لا يُجدي معها اتفاقٌ أو اصطفافٌ أو ثوراتٌ، حرب أهلية يومية (في عالم الأفكار)، بين أبناء البلد الواحد، والمصلحة الواحدة، لا تسمح لهم بإنجاز شيء، أو الالتفات عن الحرب إلى سواها، أو حتى إمكانية الاستجابة لخطابات التهدئة والترشيد، ذلك لأنّ المحدّد الذي يحكم الخطاب كله هو "التشويه" تشويه التراث باختزاله، وتشويه الواقع بابتذاله، وتشويه المخالف بوصمه وتجريده من دينه وهويته ونزاهته. وسواء كان قتل "الفعل" متعمّداً، مع سبق الإصرار والترصد، أو كان خطأ، فهو في الحالتين ميّت.