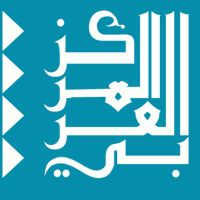24 أكتوبر 2024
"كامب ديفيد" الأميركية - الخليجية شكوك باقية وأولويات متباينة
"كامب ديفيد" الأميركية الخليجية.. أولوية إيران، ولكن كيف؟ (Getty)
استضاف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميرلاند الأميركية، في 14 مايو/أيار 2015، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد جاءت هذه القمة الأميركية – الخليجية في سياق محاولات إدارة أوباما احتواء القلق الخليجي المتنامي إزاء تداعيات توصّل مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (5+1) إلى اتفاقٍ نووي نهائي مع إيران أواخر يونيو/حزيران المقبل. وتخشى دول الخليج العربية أن يؤدي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وإعادة أموالها المحتجزة في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق، إلى زيادة جرأتها في دعم حلفائها في كلٍ من العراق وسورية واليمن ولبنان. كما تخشى هذه الدول أن يتركها الانكفاء الأميركي عن منطقة الشرق الأوسط مكشوفةً أمام أي تغوّل إيراني محتمل، خصوصاً أنّ الاتفاق النووي النهائي سيُبقي، على الأرجح، على البنية التحتية النووية الإيرانية. وقد حاولت إدارة أوباما جاهدة طمأنة الحلفاء الخليجيين بالتزامها أمنهم، عبر ترتيبات أمنية وعسكرية متفق عليها، غير أنّ الضمانات التي قدمتها واشنطن في القمة لم تصل إلى درجة توقيع معاهدةٍ للدفاع المشترك. وفيما كانت دول الخليج تحاول انتزاع التزامات أميركية أكثر تحديدًا حيال أمنها، سعت إدارة أوباما إلى انتزاع موافقة خليجية على اتفاقٍ نووي مع إيران، لتعزيز موقفها أمام الكونغرس، المتشكّك في النيات الإيرانية، وفي التزام طهران أيّ اتفاق يمكن التوصل إليه.
تقلّص الثقة بالحليف الأميركي
لم يكن التوصّل إلى عقد القمة الخليجية - الأميركية أمرًا سهلًا؛ إذ غاب عن القمة أربعة زعماء خليجيين من أصل ستة. وإذا كان غياب سلطان عُمان ورئيس دولة الإمارات مفهومًا لأسباب صحية، فإنّ غياب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بقي في الرياض، للإشراف على الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حينها في اليمن، لا يمكن فهمه خارج سياق الشكّ والإحباط الخليجيين من إدارة أوباما. ودليلاً على التوتّر غير المعلن في العلاقات، أعلن البيت الأبيض، قبل أسبوع من عقد القمة؛ أي في الثامن من أيار/ مايو، أنّ العاهل السعودي سيشارك في القمة، غير أنّ الرياض أعلنت، بعد يومين من ذلك، عن إيفاد كلٍ من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور القمة، بدلًا من الملك.
ولا تعدّ تداعيات الاتفاق النووي المزمع التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى مصدر القلق الوحيد للدول الخليجية، بل ثمة قلقٌ خليجيٌ، أيضًا، من تراجع التأثير الأميركي في المنطقة، ومحاولات إيران ملء الفراغ الناجم عن ذلك في مناطق عديدة؛ كما في العراق وسورية واليمن. ويعدّ هذا أحد الأسباب التي دفعت دول الخليج العربية، بقيادة السعودية، إلى أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن واشنطن؛ فهي ترى أنّ الولايات المتحدة رهنت كل شيء في المنطقة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وبالتوصل إلى اتفاقٍ نووي مع طهران.
تباين في الأولويات
يمكن القول، من خلال التصريحات المتباينة للطرفين، إنّ ثمة خلافًا حول ترتيب الأولويات وكيفية التعاطي معها؛ فالدول الخليجية تسعى إلى الحصول على قائمة من الضمانات الأمنية التي يمكن الاعتماد عليها، لمواجهة أي توسّع إيراني مباشرٍ أو غير مباشرٍ، عبر وكلائها في المنطقة، في حال رُفعت العقوبات عنها، بموجب اتفاقٍ نووي، لا سيما إذا بدأت بتسليح نفسها بأسلحة أكثر تقدمًا. في حين تريد الولايات المتحدة من حلفائها الخليجيين أن يكونوا داعمين مثل ذلك الاتفاق، مع منحهم ضمانات أمنية وعسكرية محدودة. ولعل ما يقلق الحلفاء الخليجيين موقف أوباما، ولغته المواربة تجاه إيران، وخصوصاً مع رفض إدارته توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مجلس التعاون؛ فقد كان لافتًا تصريح أوباما، في المؤتمر الصحافي، بُعيد انتهاء أعمال قمة كامب ديفيد، إذ قال: "دعوني أكون واضحًا جدًا هنا: الغرض من أي تعاون استراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إيران، أو حتى تهميش إيران"
ولأنّ أي اتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران سيبقي على البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة، فضلًا عن احتفاظها بأجهزة طرد مركزي ذات قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم 15 عامًا، ولأنّ احتفاظها بمهاراتها التقنية النووية (know-how) وقدرتها على تخصيب اليورانيوم سوف يمكّنها من تصنيع قنبلة نووية في المستقبل إذا قررت ذلك، فإنّ دولاً خليجية ألمحت إلى أنها قد تسعى إلى تطوير برامجٍ نوويةٍ خاصةٍ بها. وبهذا، فإنّ أكثر ما يقلق إدارة أوباما هو إطلاق سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، خصوصًا مع إعلان السعودية أنها ستسعى إلى الحصول على قدرات نووية مساوية لأي قدرات نووية تمتلكها إيران بموجب أي اتفاقٍ نهائي. ومع أنّ الولايات المتحدة تعارض حصول سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، فإنها لا تقدِّم، في الوقت نفسه، ضمانات كافية وذات موثوقية عالية لحماية دول الخليج العربية، في حال امتلكت إيران سلاحًا نوويًا في المستقبل، ومثال ذلك أنّ إدارة أوباما رفضت أن تشمل الخليج العربي ضمن مظلتها الحمائية النووية.
وبرز تباين آخر مهم بين الطرفين في الملفين، السوري واليمني؛ فالدول الخليجية تريد دعمًا أميركيًا أوسع في سورية، لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ووقف الصراع الذي دمّر البلاد وشرّد أكثر من نصف سكانها، في حين يرى أوباما أنّ الصراع في سورية "ربما لن ينتهي" قبل أن يغادر هو نفسه السلطة. أما في الموضوع اليمني، فقد دعا البيان الختامي الصادر عن القمة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك والانتقال من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية عبر مؤتمر الرياض. والمعروف أنّ الولايات المتحدة هي من ضغطت من أجل الهدنة التي أعلنها التحالف العربي مدة خمسة أيام (12-18/5/ 2015) مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تعهّدت بالتصدي "لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة"، سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فذلك لا يبدو مؤكدًا في ظل الغموض والتردد الأميركي في سورية واليمن، وتركيزها على محاربة تنظيمي "داعش" والقاعدة، وهو ما يضاعف القلق الخليجي إزاء المواقف الحقيقية للحليف الأميركي.
إيران جوهر الخلاف
شكّل تأمين دعم دول الخليج، أو على الأقل، عدم إبداء معارضة قوية لاتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران في يونيو/حزيران المقبل، الدافع الرئيس وراء الدعوة الأميركية لعقد قمة كامب ديفيد. وعلى الرغم من أنّ البيان الختامي للقمة حقّق بعض ما أرادته الإدارة الأميركية؛ في نصّه على موافقة دول الخليج العربية على أنّ "اتفاقًا شاملًا يمكن التحقّق من تنفيذه" مع طهران سيكون في مصلحتهم، فإنّ أوباما لم يتمكّن من تأمين دعمٍ خليجي غير مشروطٍ لمثل هذا الاتفاق المفترض، ولا حتى لاتفاق الإطار الذي تم توقيعه سابقًا. وقد اعترف أوباما نفسه بذلك، عندما قال، في المؤتمر الصحافي الذي تلا القمة إنّ مستشاريه أطلعوا المسؤولين الخليجيين على تفاصيل الاتفاق المحتمل مع إيران، لكنه لم يطلب منهم أن "يوقعوا" للموافقة عليه، كما أنه أقر بمشروعية بواعث القلق لدى الدول الخليجية حول تخفيفٍ محتملٍ للعقوبات على إيران، وما يمكن أن يؤدي إليه من تعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وحسب وزير الخارجية السعودي، فإنّ القادة العرب تلقوا تطمينات بأنّ هدف أي اتفاق نهائي هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، أو امتلاك القدرة على تحقيق ذلك، وقطع كل الطرق بهذا الاتجاه، لكنه أضاف إنه من المبكر تحديد موقفٍ بقبول الاتفاق. وتكمن المفارقة في أنّ أوباما نفسه يقرُّ بأنّ إيران، سواء أكان هناك اتفاق معها أم لا، ستبقى تشكِّل تهديدًا لاستقرار المنطقة؛ ما يعيد إنتاج الهواجس الخليجية إزاء مدى الاعتماد على الوعود والضمانات الأميركية غير الحاسمة.
علاقات أمنية دون الطموح
شكّلت مسألة الشراكة الأمنية والدفاعية أحد أهم الملفات التي ناقشها الطرفان، الأميركي والخليجي، في قمة كامب ديفيد. فالدول الخليجية جاءت إلى القمة، وهي تطمح إلى الحصول على علاقات دفاعية أوثق، تصل إلى حدِّ معاهدةٍ للدفاع المشترك، وهو ما أوضحت إدارة أوباما سلفًا أنها غير متحمسةٍ لتقديمه. وجادل مسؤولو إدارة أوباما بأنّ معاهدةً مكتوبةً بهذا الشأن لن تكون مجديةً، وهي غير ضروريةٍ، وبأنّ تأكيدات الرئيس أوباما على التزام الولايات المتحدة أمن الخليج تعدُّ كافية. وبالفعل، نصّ البيان الختامي للقمة على أنّ الولايات المتحدة "تتشارك مع حلفائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ... في مصلحة حيوية، تتمثّل في دعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أعضاء المجلس ضد أي عدوانٍ خارجي. إنّ سياسة الولايات المتحدة تقوم على استخدام كل عناصر القوة (بما في ذلك القوة العسكرية) لحماية مصالحها في منطقة الخليج، وردع أي عدوان خارجي على حلفائها وشركائها ومجابهته". وتتلخّص الإجراءات الأميركية المقصودة، والتي جاءت في ملحقٍ خاصٍ، في: تطوير نظام دفاعي صاروخي باليستي مشترك ومتكامل بين دول مجلس التعاون كلها، بما في ذلك نظام إنذار مبكر بمساعدة فنية أميركية، وتركيز مبيعات الأسلحة وتسريعها، وزيادة التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية وضد الإرهاب، وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية ضد أعمال القرصنة، وتعزيز الأمن البحري، وتدريب القوات الخاصة والأجهزة الاستخباراتية الخليجية.
وتتطلب جميع الإجراءات السابقة جهدًا خليجيًا ذاتيًا بدعم أميركي، ولا تدخل هذه الإجراءات، عمليًا، في سياق دفاعٍ أميركي تلقائي وفوري عنها، في مواجهة أيّ أخطار خارجية. وأقصى ما تفكّر الولايات المتحدة في عرضه على الدول الخليجية هو وضع "حليفٍ رئيسٍ غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تتيح للدول المنضوية تحت هذا الوضع حقّ الحصول على مساعدات وتدريبات متاحة لأعضاء حلف الناتو فحسب، لكنها لا تصل إلى حدّ الدفاع المشترك.
خلاصة
أصبح من الواضح لدى دول الخليج العربية، بعد قمة كامب ديفيد، أنّ إدارة أوباما لا يعنيها، في هذه المرحلة، إلا التوصّل إلى اتفاقٍ نووي مع إيران، يجعلها شريكًا في الحرب على تنظيم "داعش". وفي سبيل ذلك، هي مستعدة للتغاضي، ولو لبعض الوقت، عن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية. وتسعى إدارة أوباما إلى الحصول على مساعدة دول الخليج العربية في إقناع الكونغرس بقبول هذه السياسة من جهة، كما تريد منها القبول بمهادنة إيران وعدم التصعيد ضد سياسات التغوّل التي تتّبعها في المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه، تريد إدارة أوباما إيصال رسالةٍ ضمنيةٍ إلى الخليجيين بأنّ الدفاع عن مصالحهم وأمنهم غداً يقع على عاتقهم، ويعتمد بشكلٍ رئيسٍ على إمكاناتهم الذاتية، وأنّ دور الولايات المتحدة مكمل للدور الذاتي الخليجي. وفي هذا السياق، يمكن فهم حجم الاستياء الخليجي من سياسات إدارة أوباما في المنطقة، وفهم قلقهم تجاه مفاوضاتها مع إيران؛ وهو ما يتطلب، في المحصلة، أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن انتظار الضوء الأخضر الأميركي، كما جرى في اليمن.
وبناء عليه، يتطلب اعتماد دول الخليج على نفسها للتصدي للتحديات الكبرى في المنطقة، كالتدخلات الإيرانية، مواجهتها بوسائل عدة؛ فكما لا يجري التدّخل الإيراني في شؤون المنطقة عبر الاجتياح المباشر، وإنما عبر أطرافٍ محلية، فإنّ مواجهته لا تتطلب الاستعدادات العسكرية فحسب، مع أهميتها، وإنما تتطلب، أيضًا، بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية، تساهم في تماسك المجتمعات العربية في الخليج والمشرق العربي عمومًا. ومن هنا، فإنّ أي مواجهة عسكرية مستقبلية تتطلب تعزيز عناصر القوة الذاتية، ورفع مستوى التنسيق بين دول الخليج، ومصارحة المجتمعات الخليجية بأنّ تعزيز عناصر القوة مجتمعة في مصلحة سيادة دولها، ولتقليص اعتمادها على الخارج. تحقيق هذا الهدف ممكنٌ، لكنه يتطلب ثمنًا وتغييرًا في الثقافة السائدة، وفي نمط الحياة التي اعتادت عليه فئات واسعة من هذه المجتمعات.