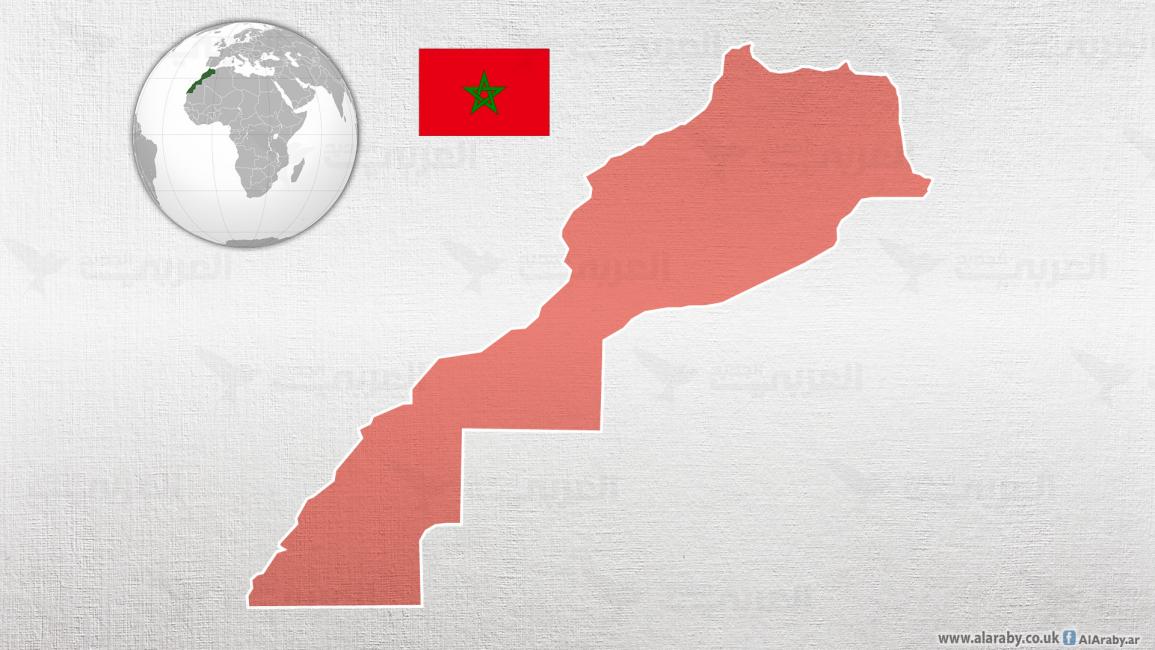مؤسسة الجابري ... المغرب إلى أين؟
كأنّك تقفُ على جبلٍ لا ترى مَن تحتهُ، ولا من هو على قمّته. أنتَ سحابةٌ بين السّحاب، حقيقة لا مجازاً، حين تشعر بخفّة بعد تحقّق حلم عزيز. بل لأنّك صعدتَ هذا الجبل الصّعبة تضاريسه، الحادّة صخوره، من أجل أن تصل إلى شيء لا بد منه. وليس لأنّك متسلّق جبال، ولا مُحبّ للمشي بين الجبال والغابات.
هكذا يشعر من يكترث بوضع البلاد في المغرب. لا أحد يعرف مكانه بين بداية الجبل ونهايته، ولا ما بعد كل خطوة يخطوها. ولا يعرف من وصل إلى القمة، رغم أنه واثقٌ من شيء واحد، أنه من الذين يحاولون الصعود، والذين لم يعودوا يعرفون خريطة البلاد السياسية، ولا موقع كل طرف فيها.
في الأسبوع الماضي، طرحت مؤسسة محمد عابد الجابري، (تأسست عام 2011)، أسئلة شائكة لمحاولة توضيح الخريطة، على أسماء فاعلة، لها رؤية وتصور وتأثير، وما يكفي من الشجاعة للتصدّي لمشكلات يهرُب منها الآخرون هروبهم من الوباء. هذه الأسماء وبعد سلسلة من الندوات، التَأَمَت في لقاء ختامي من أجل البحث عن مخرجات لأطروحاتٍ، تساعد على فهم القادم من الأيام.
في المحور السياسي، وُصفت المرحلة الحالية بـ"الأمنية"، من خلال بُروز قوة جهاز الأمن على أكثر من صعيد، حتى صار المسؤول عن الجهاز الأمني، شخصية عمومية حاضرة في الإعلام، وعلى الجبهات الرئيسية للبلاد في الداخل والخارج. كما أن المواجهة الصدامية العنيفة للسلطة مع الأصوات المعارضة دليلٌ آخر على سبل التعامل الأمني البعيد عن منطق احترام الحريات والحقوق، والنائي عن الديمقراطية المأسوف على شبابها. مثل ما شهدناه مع الصحفيين الذين حُكموا بتهم غير مسنودة بأدلة قوية. وما زالوا يقضون سنواتٍ تلو أخرى، من دون أي بوادر انفراج بمناسبة أي عذرٍ يتيح إغلاق هذا الملف.
إذن، أين يتّجه المغرب في الأيام الضبابية هذه؟ تصعب الإجابة عن هذا السّؤال، رغم كل ما سبق، لكن مقابل ذلك طرح الأكاديمي والوجه اليساري البارز، محمد الساسي، سؤالا: مع من سنتحاور لنعرف وجهة القطار؟ إذا كنّا لا نعرف الطرف الذي يوجد على جهة السُّلطة، مع تعدّد الأجهزة التي نسمع عن صراعاتها فقط. وما من جهةٍ بينها تبحث عن الانفراج والانفتاح على الأحزاب، التي ما زالت في المعارضة، أما الأحزاب الأخرى فقد تم طيّها تحت إبطِ السلطة منذ فترة. ولهذا ما من حلّ في الأفق سوى انتظار أزمة قوية، تعصف بالوضع الحالي، وتعيد ترتيب المشهد مرّة أخرى، لتعود السياسة في المغرب إلى الحياة، وتعود لها الدينامية المفقودة.
وجهة نظر السّاسي واقعية في تشاؤمها، لكن إذا تعلمنا من العقود الماضية شيئا، فهو أن التغيّر لا يمكن التكهّن بمنبعه ولا بمصيره. وأسهمت أصواتٌ أخرى في تحليل الواقع المحبط، حيث أجمعت على أن المشهد خانق، والحلول غير واضحة، ولا أمل في الأفق.
اجتماعياً، كان المتحدّثون أكثر تشاؤماً مما ظننّا، لأنّهم على عكس السياسيين يتكلمون بالأرقام، والأرقام تصف بدقّةٍ ما يحدث والقادم من الأشياء. وبدلاً من أن تكون الدولة من يموّل الشّعب، صار الشعب يمول الدولة. وما الزيادات في السنوات الأخيرة في أسعار الغاز والنفط إلا وسيلة لملء خزينة الدولة، التي كادت تغلي وتخلو من المال الذي مثل الزيت والغاز نفسه، لا حركة على الأرض من دونه.
الخلاصة هي سيطرة اقتصاد الريع الذي تستفيد منه طبقة مرتبطة بالسلطة ودواليبها، وازدياد النفوذ الاقتصادي الأجنبي. والفاعلون في الاقتصاد في دار أخرى غير التي تقيم فيها، فالبنوك لا تساهم في التنمية، بل تفضّل استغلال الودائع لتمويل قطاعاتٍ غير منتجة، تخدم القلة من أصحاب المال. كما أن كثيرين من هؤلاء توجهوا إلى الاستثمار في وسائل النقل الخاص، عندما رفعت الدولة يدها عن ذلك القطاع، بينما هناك حاجة ماسّة لدعم شبكة النقل العمومي وتوسعتها لتتنفس المدن.
آخر نقطة هي الاعتماد الكبير للسياسات الحكومية على عوامل الطقس، لتسجيل سنة اقتصادية جيدة. وما من نقطة تفيض الكأس الذي يسيح منذ فترة طويلة، وزلقنا فيه حتى صار الانزلاق أسلوب حياة، فيما لم نعرف بعد إلى أين يتوجّه بكأسه الفائضة، وبنا معشر المنزلقين.