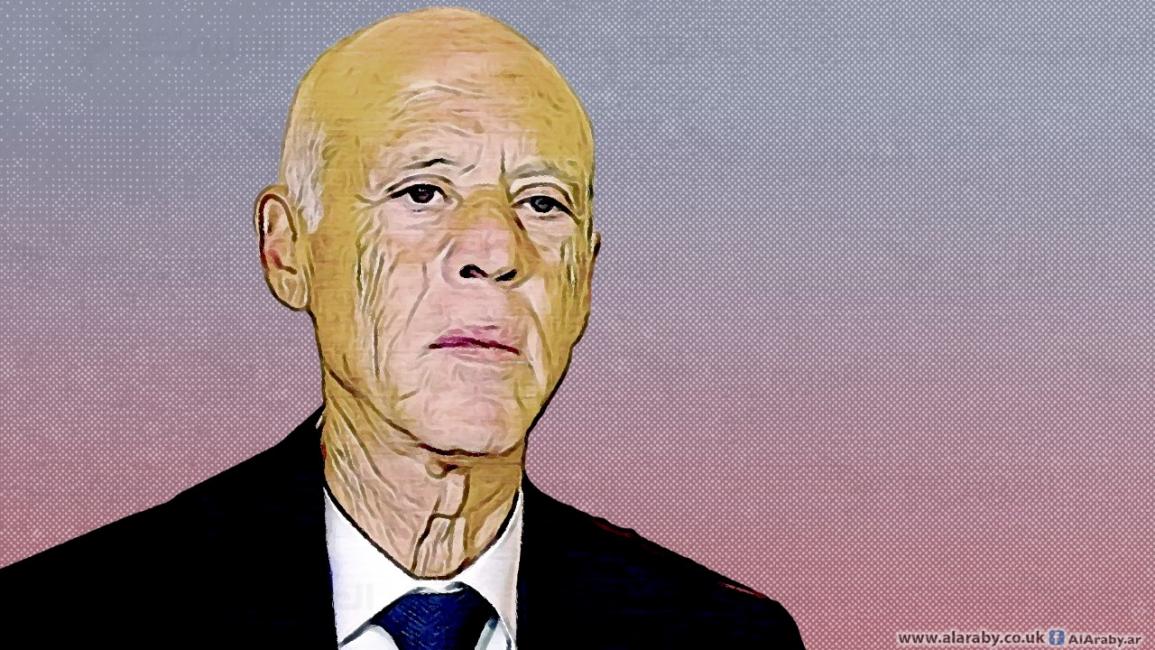مواطن شريف اسمه قيس سعيّد
المسافة بين قيس سعيّد، المرشح الذي تملق ثورة الياسمين وتسلقها، وزعم إنه حال فوزه لن يسكن قصر قرطاج، وبين الرئيس قيس سعيّد الذي صاح: الكل فاسد إلا أنا، معلنًا موت الثورة ومخرجاتها، هي ذاتها المسافة بين المواطن العادي، الطبيعي، والمواطن الشريف، ذلك الصنف من المواطنين الذي يتحوّل، في لحظة واحدة، من الترحيب بالثورة، إلى طعنها وحرقها، خدمة لمن يكرهونها.
قيس سعيّد، ذلك الشخص الذي درس القانون ثم قام بتدريسه، كما يشاع، هو ذاته الشخص الذي يعلن الحرب على أبي القوانين كلها، وهو الدستور، بل ويطلق عليه قطعانًا من المواطنين الشرفاء تهتف: يسقط الدستور، وتسقط الثورة نفسها.
هذا المشهد البائس لمتظاهرين تونسيين، محشودين بمعرفة الماكينة الرئاسية، وهم يحتفلون بحرق الدستور أمام عدسات التصوير، وكأنهم في طقسٍ قوميٍّ جليل، منقول حرفيًا من أزمنة الاستبداد والطغيان، حين تضجّ السلطة المستبدّة بكل ما يقيد حركتها من نصوص دستورية وقانونية، مختبئة مثل لص أنيق خلف مجموعاتٍ من الصغار، يرفعون مطلبًا وحيدًا، هم بالضرورة لا يفهمون مضمونه، وهو حماية الوطن من الدستور، الذي يهدد مستقبله ويعطل قائده عن النهوض به.
هذا ما جرى مرتين في القاهرة، في عصريْن مختلفيْن، لعب فيهما الطغيان برؤوس الحاكمين: الأولى كانت في العام 1954 عندما قرّر جمال عبد الناصر أن يتخلص من محمد نجيب، ويعيد هندسة مجلس قيادة الثورة، على النحو الذي يجعله صاحب السلطة المطلقة.
في ذلك الوقت أخرجت تظاهرات تجوب القاهرة هاتفة: يسقط الدستور.. تسقط الديمقراطية والحرية .. يعيش الجيش .. يعيش الزعيم، ثم تصل إلى مبنى مجلس الدولة، لمحاصرة رئيسه الرافض تعديل الدستور، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، حتى تتمكّن الجموع من اقتحام بوابة المجلس المغلقة بالسلاسل الحديدية والجنازير، وتصبح على بعد خطوات من رئيسه، وهنا يظهر العسكري الثائر طالبًا من رئيس المجلس الخروج للجماهير الغاضبة لامتصاص غضبها، وما أن يخرج حتى يتحوّل إلى فريسةٍ سهلة، ويتلقى الركلات والصفعات والشتائم، بوصفه "الخائن الجاهل" فيظهر ضابط الجيش منقذًا لحياته، فيخرج ملفوفًا في سجادة إلى بيته.
هذه القصة التي سبق أن توقفت عندها، وضمتها صفحات الحكاية كتاب الباحث عمرو الشلقاني "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805 - 2005" تكرّرت بتفاصيلها، تقريبًا، عندما قرّر عبد الفتاح السيسي أن يجري جراحة كبيرة للدستور، بحيث يتخلّص من المواد والنصوص التي تجعل منه الحاكم الأوحد، الأعلى من الدستور والقانون، والذي يحق له الترشح للرئاسة مرات ومرات.
الفروق بين لحظتي 1954 و2019 تتعلق بالشخوص، لا بالأحداث، إذ أطيح رجل القانون المستشار هشام جنينة، بعد التعدي عليه وإهانته، كما جرى مع سلفه السنهوري، فيما أسندت أدوار المواطنين الشرفاء، الهاتفين بضرورة إسقاط الدستور، إلى إعلاميين وأساتذة علوم سياسية، تخرجوا في أميركا، التي توصف بواحة الديمقراطية، من نوعية المعتز بالله عبد الفتاح، الذي رفع شعار إلى الجحيم بالديمقراطية إذا كانت ستعطل مسيرة الزعيم الملهم ورؤيته التنموية.
بعض هذه المشاهد تجده في الحالة التونسية الآن، إذ لا يخجل أساتذة قانون وسياسيون من إظهار الاحتقار والكراهية للدستور والقانون، مرددين أيضًا: الدستور ليس مقدسًا.. ليذهب إلى الجحيم.
قلت سابقًا، إن هؤلاء "المواطنين الشرفاء" لا يظهرون إلا في أجواء الفساد السياسي، والاستبداد والطغيان في الحكم، ليكتسب لفظ "الشرف" هنا مدلولاتٍ قبيحة ومنحطة، فيتحوّل إلى مدية في يد قاتل، أو مطواةٍ في يد بلطجي، تسبغ عليه السلطة الفاسدة صفات البطولة والوطنية الزائفة.
وتتطور المسألة، في تصاعد درامي مثير، حتى تأتي لحظة التوحد بين الطاغية الذي يستخدم هذا السلاح (المواطنين الشرفاء) والسلاح ذاته، لينتهي الأمر بالحاكم، وقد صار "مواطناً شريفاً" بكل دلالات القبح الأخلاقي والانهيار الاجتماعي، والتدنّي السياسي في المصطلح.
وأظن أن قيس سعيّد بات مستحقًا هذه الرتبة، عن جدارة واستحقاق، وخصوصًا بعد أن ظهر ممسكًا بميكروفون ليعلن أنه سوف يلفق تهمة لكل من يعارض استبداده وانقلابه على الدستور، والثورة، ولم لا؟ وهو لا يتورع عن القول إن منصّاته جاهزة لإطلاق الصواريخ على الفاسدين، والذين هم بنظره المعارضون لسلطته المطلقة.