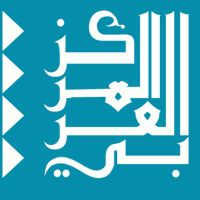24 أكتوبر 2024
التحرير بالتدمير.. الرمادي "نموذجاً" في الحرب على داعش
قوة عراقية تتقدم في شرق الرمادي (2 فبراير/ 2016/أ.ف.ب)
بعد مرور نحو شهرين على إطلاق المعركة لاستعادتها، لم تتمكن القوات العراقية المسنودة بغطاء جوي أميركي كثيف، حتى الآن، من بسط كامل سيطرتها على مدينة الرمادي؛ إذ لا تزال بضعةُ أحياء منها تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتشهد أجزاء أخرى من المدينة معاركَ كَرٍّ وفرٍّ بين الطرفين. مع ذلك، بدأت الولاياتُ المتحدة التي تقود التحالف الدولي لمواجهة داعش تتحدث عن بدء الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل، على الرغم من الإقرار بأنّها معركة ستكون معقدة وصعبة، وتحتاج إلى وقت طويل للتهيئة لها.
الاستعداد لماذا؟
في الآونة الأخيرة، تكثّفت التصريحات الأميركية، وخصوصا الصادرة عن وزارة الدفاع "البنتاغون"، بشأن توسيع الاستعدادات العسكرية في إطار الحرب على داعش، إذ أعلنت الوزارة أنّها ستبدأ في نشر الفرقة 101 المحمولة جواً، أواخر فبراير/شباط الجاري (علمًا أنّ مصادرَ عسكرية عراقية أعلنت أنّ نشر 1800 عنصر من هذه الفرقة بدأ بالفعل، في قاعدتَي عين الأسد والحبانية في محافظة الأنبار). ومع أنّ وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنّ نشر هذه الفرقة لا يمثّل زيادة في عديد القوات الأميركية في العراق، وأنّها ستستبدل بقوات أخرى موجودة في العراق، وأنّ مهمات هذه الفرقة ستبقى محصورة في إطار التدريب والاستشارة، يجري تأويل نشر هذه الفرقة، بوصفه دليلاً على توسيع الجهد العسكري الأميركي، في إطار محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"؛ فهذه الفرقة هي من قوات النخبة في الجيش الأميركي، وقد شاركت في حروب عدة، منها الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، وهي، في العادة، تنفّذ مهمات إسناد ومهمات هجومية، مدعومة بطائرات الهليكوبتر المقاتلة.
فضلاً عن ذلك، يتحدث التحالف الدولي عن تدريب نحو عشرين ألف مقاتل من أبناء ما درج الاحتلال الأميركي على دعوتها "العشائر السنية"، ليكونوا جزءًا من القوة المقاتلة لتنظيم "الدولة الإسلامية". ومع أنّ مشاركة وحداتٍ من هذه القوة في "تحرير" الرمادي غير واضحة، فالأكيد أنّ معركة الرمادي اعتمدت على عنصرين أساسيَين: القوات العراقية، والمقاتلون المحليون. ولذلك، كانت البلاغاتُ الرسمية العسكرية العراقية عن معركة الرمادي تستعمل تعبير "القوات المشتركة"، في الإشارة إلى التركيبة المؤلفة من هذين العنصرين.
من جهة أخرى، ما زالت ماهية هذه القوات المحلية التي يجري تشكيلها وتأهيلها غير معروفة؛ فهل هي بقايا تنظيمات الصحوة السابقة التي أنشأها الأميركيون عام 2007، في إطار ما عُرف بـ "خطة بترايوس"؟ أم هي ممّن يُعرف بـ "الصحوة الجديدة"، وهي التنظيمات التي أعاد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، إحياءَها، بعد اندلاع حركة الاحتجاج في الأنبار والمحافظات السنّية، مطلع 2013، وسيطرة داعش على مساحات واسعة من محافظة الأنبار؟ أم هي مجموعة مختارة من عشائر الأنبار المختلفة؟ أم عناصر اختيرت بعملية تطوّع مفتوح؟
ويبدو أنّ الأميركيين كانوا يعملون بهدوء، وبصورةٍ غير معلنة، في بناء هذه القوة، حتى لا يخضع بناؤها للسجال السياسي بين الأطراف العراقية؛ ذلك أنّ التصور الأميركي للحرب على داعش يفترض أنّ هذه الحرب يجب أن تستند، أساساً، إلى قواتٍ ومقاتلين من داخل المجتمع المحلي السنّي. وقد تبلورت هذه الفكرة في ما عُرف بـ "الحرس الوطني". وهي منظومةٌ قتالية، نصّ عليها البرنامج الذي تشكّلت، بموجبه، حكومةُ حيدر العبادي، في سبتمبر/أيلول 2014، وكان ينبغي إعلانها بعد ثلاثة أشهر من منح البرلمان الحكومةَ الثقة، لتكون مؤسسة أمنية رسمية ثالثة، إلى جانب الجيش والشرطة. ولكن، أُجهضت هذه الفكرة، ولم يرَ الحرس الوطني النور، بسبب الخلاف الذي ثار على طبيعته، وتركيبته، ومهماته وحدودها، والجهة التي ستشرف عليه، وعلاقته بوزارة الدفاع والمؤسسات المركزية في بغداد من جهة، وبالحكومات المحلية من جهة أخرى. والواقع أنّ السبب الرئيس وراء إجهاض الفكرة هو خوف القوى الشيعية السياسية الحاكمة من إمكانية تحوّل الحرس الوطني إلى "ميليشيا"، أو قوة عسكرية، تمثّل أداة إسناد لمطالب سياسية "سنية"، أو تهدّد الحكم المركزي في بغداد، أو توظّفها قوى إقليمية. إنّه خوف قوى طائفية سياسية مسلحة في إطار الدولة من تبلور طائفيةٍ سياسيةٍ مقابلةٍ مسلحة في إطار الدولة أيضًا.
ولذلك، وبسبب ممانعة حكومة العبادي في تشكيل الحرس الوطني، بل ممانعتها في تسليح مقاتلي العشائر، لجأت الولايات المتحدة إلى بناء هذه القوات، بصورةٍ غير معلنة، لتضم، على الأرجح، خليطاً من عناصر "الصحوة الجديدة"، ومقاتلين عشائريين، ومتطوعين.
نموذج عامّ لمحاربة داعش؟
على الرغم من أنّ معركة تحرير الرمادي لم تُستكمل بعد مرور نحو شهرين على انطلاقتها، يتّجه "البنتاغون" إلى جعل معركة تحرير الرمادي نموذجا(model) للحرب على داعش. ولذلك، كان الإسهام الأميركي في هذه المعركة كبيراً: نحو 700 ضربة جوية، فضلًا عن التدريب والتسليح والتخطيط.
من هنا، يصحّ القول إنّ معركة الرمادي معركة أميركية، بهذا المعنى، وهي، بهذا المعنى أيضاً، تطبيق للإستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والتي تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: الغارات الجوية الكثيفة، والاعتماد على قوات خاصة محدودة (مع إمكانية تنفيذ مهمات نوعية خاصة ومحددة)، ودعم قوات محلية وتأهيلها لخوض المعارك البرية والسيطرة على الأرض التي يخليها الخصم..
تحاول الإدارة الأميركية تقديم هذا النموذج بوصفه نموذجاً عاماً لقتال داعش، في أيّ مكان. ولذلك، حين تصاعد النقاش، في الأيام الأخيرة، عن إمكانية تدخّل عسكري غربي في ليبيا لمواجهة داعش، طرحت الولايات المتحدة الرؤية نفسها..
إقليمياً، يحاول النموذج الأميركي أن يثبت جدارته في سياق تنافس قوى مختلفة ومتناقضة في هذه الحرب، ولا سيما النموذج الروسي الذي، وإنْ كان لم يثبت نجاحاً بعد، ولم يستهدف داعش أصلاً حتى الآن بصورة أساسية، فإنّه يعتمد على غاراتٍ جويةٍ مكثفة، وميليشيات أجنبية، للسيطرة على الأرض. وعراقياً، هناك نموذج استخدام الميليشيات الشيعية التي أسهم الإيرانيون في بنائها، وتَمثّل في معركة "تحرير" تكريت ومحافظة صلاح الدين. يستند هذا النموذج إلى ميليشيا الحشد الشعبي، ولم يكن فيه للجيش النظامي ولا للمقاتلين المحليين، دورٌ أساسي. ومع ذلك، لم ينجح في دحر داعش من تكريت، في إبريل/نيسان 2015، من دون الدعم الجوي الأميركي المكثف. وقد أعقبت هذه العملية حملة انتقام من السكان واسعة، قامت بها الميليشيات.
أمّا النموذج الأميركي فيستند إلى قوات مختلطة (مزيج) من مقاتلين محليين والجيش النظامي، في حين يجري استبعاد مقاتلي الحشد الشعبي الذين قد تثير مشاركتهم حساسياتٍ طائفية، على نحو ما حدث في معركة تكريت، وما شهده الجدال المتصاعد عن إمكانية مشاركتهم في معركة تحرير الأنبار.
ومن جهة أخرى، ينبني التصور الإستراتيجي الأميركي لمواجهة داعش (وجزء كبير منه مستمد من تجربة قتال تنظيم "القاعدة" في العراق ما بعد 2003) على أنّ العنصر الأهمّ في هذه المواجهة هو تفكيك الحاضنة الاجتماعية لداعش، وأنّ المجتمع المحلي هو الوحيد القادر على هزيمة هذا التنظيم، بحسب ما أثبتت التجربة مع "القاعدة"، وذلك عبر إيجاد مصالح متعارضة بين داعش والمجتمع المحلي.
وبالقدر نفسه، تمثّل معركة الرمادي، في المنظور الأميركي، نموذجاً سياسياً، إلى جانب كونها نموذجاً عسكريًا؛ فالاعتماد على الجيش النظامي، بوصفه طرفاً رئيساً في المعركة، سيحمي المعركة من الحساسيات الطائفية المتوقَّعة. وأكثر من ذلك، سيكون دحر داعش من الرمادي دعماً لموقف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، والتيار الشيعي "المعتدل" الذي لا يزال ضعيفاً في مواجهة التيار الشيعي السياسي القريب من إيران، والذي يتمثّل بالحشد الشعبي، والتنظيمات السياسية القريبة منه، ولا سيما تيار المالكي الذي استطاع تعبئة جزء كبير من الشارع الشيعي في العراق، بعد تصدّره الحرب على داعش، وتقديمه لها بوصفها صراع وجود.
وهكذا، يمثّل "النصر" في الرمادي، من دون مشاركة الحشد الشعبي، دعماً لسياسات العبادي. ويعني هذا في المنظور الأميركي، أيضاً، ضرورة دعم حكومة مركزية قوية، يقودها طرف شيعي "معتدل"، قادرٌ على بناء توافقات مع الأفرقاء العراقيين. علمًا أنّ العبادي مازال يفتقر إلى إنجازاتٍ تُذكر على هذا الصعيد، بعد انقضاء نحو سنة ونصف على تشكيل حكومته، وستة أشهر على إطلاق مبادرته الإصلاحية؛ إذ لم يتحقق من البرنامج الحكومي أيٌّ من الفقرات الكفيلة بتفعيل المشاركة السنية في مؤسسة السلطة. ويبدو أنّ القاعدة التي دعمت العبادي، من جمهورٍ وتنظيمات ومؤسسة دينية، بدأت تتآكل، نتيجة عدم قدرته على تحقيق تقدّمٍ لجهة تنفيذ إصلاحاته الموعودة.
تغليب المقاربة الأمنية
على الرغم من انعكاسات هذه الإستراتيجية سياسيًا على المشهد العراقي، عبر تقوية موقف تيار "الاعتدال" الشيعي، وإشراك "السنّة"، وتمكينهم من إدارة مجتمعاتهم المحلية، تشير المعطياتُ إلى أنّ الولايات المتحدة بدأت تغلّب المقاربةَ العسكرية لمواجهة داعش، على حساب المقاربة السياسية/ المدنية - العسكرية التي شكّلت أساس رؤيتها. يحدث هذا حتى داخل إدارة الرئيس باراك أوباما الذي يبدو، إلى الآن، زاهدًا في رفع مستوى تدخّله العسكري في المنطقة. ولعلّ اتجاه وزارة الدفاع الأميركية إلى بناء قوات محلية، خارج إطار فكرة "الحرس الوطني"، هو جزء من تغليب هذه المقاربة الأمنية.
ومع تراجع واشنطن عن فلسفتها الأولى لمواجهة "داعش"، بوصف ظهوره يمثّل تعبيراً عن أزمة نظام سياسي، ومن ثم، ينبغي معالجة الجذور السياسية للأزمة، إذا كان من سبيلٍ للقضاء على داعش، ومع تراجع الحديث عن إصلاحٍ سياسي في العراق، يتعامل مع مشكلة المشاركة السنّية في مؤسسة السلطة، بوصفها مفتاح الاستقرار في العراق، تكون المقاربةُ العسكرية لمواجهة داعش حلاً مؤقتًا، قد يحقق مكاسب آنية، وانتصارات عسكرية، لكنّه بالتأكيد لن يستطيع بناء السلام، فيبقى البابُ مفتوحاً لعودة داعش، بوجوهٍ أخرى وأسماء أخرى، كما حصل مع القاعدة سابقاً.
وحتى استمرار المكسب العسكري نفسه لا يبدو مقنعاً؛ ذلك أنّ صورة الرمادي بعد التحرير كشفت عن تدمير 80% من مباني المدينة ومنشآتها وبنيتها التحتية، وهو ما بات يسمّى "نموذج كوباني في التحرير"؛ أي تحرير مدينةٍ بتسليمها مدمّرة بالكامل. ويرى طيفٌ واسع من المجتمع السنّي في العراق أنّه لا يوجد فرق كبير بين انتقاماتٍ تمارَس ضده عقب تحرير مدنه من داعش، وتدمير مدنه بالكامل في أثناء تحريرها.
لكن، حتى لو تجاوزنا مركزية المسار السياسي لمواجهة داعش، فإنّ السؤال المهمّ هنا هو: هل يمكن إقناع أبناء الموصل بجدوى المقاربة العسكرية لتحرير مدينتهم، إذا كان مصيرها سيكون كمصير كوباني والرمادي؛ محرّرة. ولكن، بخرابٍ كامل، وهي خلافاً للرمادي وكوباني، واحدة من أعرق الحواضر الإسلامية؟
الاستعداد لماذا؟
في الآونة الأخيرة، تكثّفت التصريحات الأميركية، وخصوصا الصادرة عن وزارة الدفاع "البنتاغون"، بشأن توسيع الاستعدادات العسكرية في إطار الحرب على داعش، إذ أعلنت الوزارة أنّها ستبدأ في نشر الفرقة 101 المحمولة جواً، أواخر فبراير/شباط الجاري (علمًا أنّ مصادرَ عسكرية عراقية أعلنت أنّ نشر 1800 عنصر من هذه الفرقة بدأ بالفعل، في قاعدتَي عين الأسد والحبانية في محافظة الأنبار). ومع أنّ وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنّ نشر هذه الفرقة لا يمثّل زيادة في عديد القوات الأميركية في العراق، وأنّها ستستبدل بقوات أخرى موجودة في العراق، وأنّ مهمات هذه الفرقة ستبقى محصورة في إطار التدريب والاستشارة، يجري تأويل نشر هذه الفرقة، بوصفه دليلاً على توسيع الجهد العسكري الأميركي، في إطار محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"؛ فهذه الفرقة هي من قوات النخبة في الجيش الأميركي، وقد شاركت في حروب عدة، منها الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، وهي، في العادة، تنفّذ مهمات إسناد ومهمات هجومية، مدعومة بطائرات الهليكوبتر المقاتلة.
فضلاً عن ذلك، يتحدث التحالف الدولي عن تدريب نحو عشرين ألف مقاتل من أبناء ما درج الاحتلال الأميركي على دعوتها "العشائر السنية"، ليكونوا جزءًا من القوة المقاتلة لتنظيم "الدولة الإسلامية". ومع أنّ مشاركة وحداتٍ من هذه القوة في "تحرير" الرمادي غير واضحة، فالأكيد أنّ معركة الرمادي اعتمدت على عنصرين أساسيَين: القوات العراقية، والمقاتلون المحليون. ولذلك، كانت البلاغاتُ الرسمية العسكرية العراقية عن معركة الرمادي تستعمل تعبير "القوات المشتركة"، في الإشارة إلى التركيبة المؤلفة من هذين العنصرين.
من جهة أخرى، ما زالت ماهية هذه القوات المحلية التي يجري تشكيلها وتأهيلها غير معروفة؛ فهل هي بقايا تنظيمات الصحوة السابقة التي أنشأها الأميركيون عام 2007، في إطار ما عُرف بـ "خطة بترايوس"؟ أم هي ممّن يُعرف بـ "الصحوة الجديدة"، وهي التنظيمات التي أعاد رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، إحياءَها، بعد اندلاع حركة الاحتجاج في الأنبار والمحافظات السنّية، مطلع 2013، وسيطرة داعش على مساحات واسعة من محافظة الأنبار؟ أم هي مجموعة مختارة من عشائر الأنبار المختلفة؟ أم عناصر اختيرت بعملية تطوّع مفتوح؟
ويبدو أنّ الأميركيين كانوا يعملون بهدوء، وبصورةٍ غير معلنة، في بناء هذه القوة، حتى لا يخضع بناؤها للسجال السياسي بين الأطراف العراقية؛ ذلك أنّ التصور الأميركي للحرب على داعش يفترض أنّ هذه الحرب يجب أن تستند، أساساً، إلى قواتٍ ومقاتلين من داخل المجتمع المحلي السنّي. وقد تبلورت هذه الفكرة في ما عُرف بـ "الحرس الوطني". وهي منظومةٌ قتالية، نصّ عليها البرنامج الذي تشكّلت، بموجبه، حكومةُ حيدر العبادي، في سبتمبر/أيلول 2014، وكان ينبغي إعلانها بعد ثلاثة أشهر من منح البرلمان الحكومةَ الثقة، لتكون مؤسسة أمنية رسمية ثالثة، إلى جانب الجيش والشرطة. ولكن، أُجهضت هذه الفكرة، ولم يرَ الحرس الوطني النور، بسبب الخلاف الذي ثار على طبيعته، وتركيبته، ومهماته وحدودها، والجهة التي ستشرف عليه، وعلاقته بوزارة الدفاع والمؤسسات المركزية في بغداد من جهة، وبالحكومات المحلية من جهة أخرى. والواقع أنّ السبب الرئيس وراء إجهاض الفكرة هو خوف القوى الشيعية السياسية الحاكمة من إمكانية تحوّل الحرس الوطني إلى "ميليشيا"، أو قوة عسكرية، تمثّل أداة إسناد لمطالب سياسية "سنية"، أو تهدّد الحكم المركزي في بغداد، أو توظّفها قوى إقليمية. إنّه خوف قوى طائفية سياسية مسلحة في إطار الدولة من تبلور طائفيةٍ سياسيةٍ مقابلةٍ مسلحة في إطار الدولة أيضًا.
ولذلك، وبسبب ممانعة حكومة العبادي في تشكيل الحرس الوطني، بل ممانعتها في تسليح مقاتلي العشائر، لجأت الولايات المتحدة إلى بناء هذه القوات، بصورةٍ غير معلنة، لتضم، على الأرجح، خليطاً من عناصر "الصحوة الجديدة"، ومقاتلين عشائريين، ومتطوعين.
نموذج عامّ لمحاربة داعش؟
على الرغم من أنّ معركة تحرير الرمادي لم تُستكمل بعد مرور نحو شهرين على انطلاقتها، يتّجه "البنتاغون" إلى جعل معركة تحرير الرمادي نموذجا(model) للحرب على داعش. ولذلك، كان الإسهام الأميركي في هذه المعركة كبيراً: نحو 700 ضربة جوية، فضلًا عن التدريب والتسليح والتخطيط.
من هنا، يصحّ القول إنّ معركة الرمادي معركة أميركية، بهذا المعنى، وهي، بهذا المعنى أيضاً، تطبيق للإستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والتي تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: الغارات الجوية الكثيفة، والاعتماد على قوات خاصة محدودة (مع إمكانية تنفيذ مهمات نوعية خاصة ومحددة)، ودعم قوات محلية وتأهيلها لخوض المعارك البرية والسيطرة على الأرض التي يخليها الخصم..
تحاول الإدارة الأميركية تقديم هذا النموذج بوصفه نموذجاً عاماً لقتال داعش، في أيّ مكان. ولذلك، حين تصاعد النقاش، في الأيام الأخيرة، عن إمكانية تدخّل عسكري غربي في ليبيا لمواجهة داعش، طرحت الولايات المتحدة الرؤية نفسها..
إقليمياً، يحاول النموذج الأميركي أن يثبت جدارته في سياق تنافس قوى مختلفة ومتناقضة في هذه الحرب، ولا سيما النموذج الروسي الذي، وإنْ كان لم يثبت نجاحاً بعد، ولم يستهدف داعش أصلاً حتى الآن بصورة أساسية، فإنّه يعتمد على غاراتٍ جويةٍ مكثفة، وميليشيات أجنبية، للسيطرة على الأرض. وعراقياً، هناك نموذج استخدام الميليشيات الشيعية التي أسهم الإيرانيون في بنائها، وتَمثّل في معركة "تحرير" تكريت ومحافظة صلاح الدين. يستند هذا النموذج إلى ميليشيا الحشد الشعبي، ولم يكن فيه للجيش النظامي ولا للمقاتلين المحليين، دورٌ أساسي. ومع ذلك، لم ينجح في دحر داعش من تكريت، في إبريل/نيسان 2015، من دون الدعم الجوي الأميركي المكثف. وقد أعقبت هذه العملية حملة انتقام من السكان واسعة، قامت بها الميليشيات.
أمّا النموذج الأميركي فيستند إلى قوات مختلطة (مزيج) من مقاتلين محليين والجيش النظامي، في حين يجري استبعاد مقاتلي الحشد الشعبي الذين قد تثير مشاركتهم حساسياتٍ طائفية، على نحو ما حدث في معركة تكريت، وما شهده الجدال المتصاعد عن إمكانية مشاركتهم في معركة تحرير الأنبار.
ومن جهة أخرى، ينبني التصور الإستراتيجي الأميركي لمواجهة داعش (وجزء كبير منه مستمد من تجربة قتال تنظيم "القاعدة" في العراق ما بعد 2003) على أنّ العنصر الأهمّ في هذه المواجهة هو تفكيك الحاضنة الاجتماعية لداعش، وأنّ المجتمع المحلي هو الوحيد القادر على هزيمة هذا التنظيم، بحسب ما أثبتت التجربة مع "القاعدة"، وذلك عبر إيجاد مصالح متعارضة بين داعش والمجتمع المحلي.
وبالقدر نفسه، تمثّل معركة الرمادي، في المنظور الأميركي، نموذجاً سياسياً، إلى جانب كونها نموذجاً عسكريًا؛ فالاعتماد على الجيش النظامي، بوصفه طرفاً رئيساً في المعركة، سيحمي المعركة من الحساسيات الطائفية المتوقَّعة. وأكثر من ذلك، سيكون دحر داعش من الرمادي دعماً لموقف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، والتيار الشيعي "المعتدل" الذي لا يزال ضعيفاً في مواجهة التيار الشيعي السياسي القريب من إيران، والذي يتمثّل بالحشد الشعبي، والتنظيمات السياسية القريبة منه، ولا سيما تيار المالكي الذي استطاع تعبئة جزء كبير من الشارع الشيعي في العراق، بعد تصدّره الحرب على داعش، وتقديمه لها بوصفها صراع وجود.
وهكذا، يمثّل "النصر" في الرمادي، من دون مشاركة الحشد الشعبي، دعماً لسياسات العبادي. ويعني هذا في المنظور الأميركي، أيضاً، ضرورة دعم حكومة مركزية قوية، يقودها طرف شيعي "معتدل"، قادرٌ على بناء توافقات مع الأفرقاء العراقيين. علمًا أنّ العبادي مازال يفتقر إلى إنجازاتٍ تُذكر على هذا الصعيد، بعد انقضاء نحو سنة ونصف على تشكيل حكومته، وستة أشهر على إطلاق مبادرته الإصلاحية؛ إذ لم يتحقق من البرنامج الحكومي أيٌّ من الفقرات الكفيلة بتفعيل المشاركة السنية في مؤسسة السلطة. ويبدو أنّ القاعدة التي دعمت العبادي، من جمهورٍ وتنظيمات ومؤسسة دينية، بدأت تتآكل، نتيجة عدم قدرته على تحقيق تقدّمٍ لجهة تنفيذ إصلاحاته الموعودة.
تغليب المقاربة الأمنية
على الرغم من انعكاسات هذه الإستراتيجية سياسيًا على المشهد العراقي، عبر تقوية موقف تيار "الاعتدال" الشيعي، وإشراك "السنّة"، وتمكينهم من إدارة مجتمعاتهم المحلية، تشير المعطياتُ إلى أنّ الولايات المتحدة بدأت تغلّب المقاربةَ العسكرية لمواجهة داعش، على حساب المقاربة السياسية/ المدنية - العسكرية التي شكّلت أساس رؤيتها. يحدث هذا حتى داخل إدارة الرئيس باراك أوباما الذي يبدو، إلى الآن، زاهدًا في رفع مستوى تدخّله العسكري في المنطقة. ولعلّ اتجاه وزارة الدفاع الأميركية إلى بناء قوات محلية، خارج إطار فكرة "الحرس الوطني"، هو جزء من تغليب هذه المقاربة الأمنية.
ومع تراجع واشنطن عن فلسفتها الأولى لمواجهة "داعش"، بوصف ظهوره يمثّل تعبيراً عن أزمة نظام سياسي، ومن ثم، ينبغي معالجة الجذور السياسية للأزمة، إذا كان من سبيلٍ للقضاء على داعش، ومع تراجع الحديث عن إصلاحٍ سياسي في العراق، يتعامل مع مشكلة المشاركة السنّية في مؤسسة السلطة، بوصفها مفتاح الاستقرار في العراق، تكون المقاربةُ العسكرية لمواجهة داعش حلاً مؤقتًا، قد يحقق مكاسب آنية، وانتصارات عسكرية، لكنّه بالتأكيد لن يستطيع بناء السلام، فيبقى البابُ مفتوحاً لعودة داعش، بوجوهٍ أخرى وأسماء أخرى، كما حصل مع القاعدة سابقاً.
وحتى استمرار المكسب العسكري نفسه لا يبدو مقنعاً؛ ذلك أنّ صورة الرمادي بعد التحرير كشفت عن تدمير 80% من مباني المدينة ومنشآتها وبنيتها التحتية، وهو ما بات يسمّى "نموذج كوباني في التحرير"؛ أي تحرير مدينةٍ بتسليمها مدمّرة بالكامل. ويرى طيفٌ واسع من المجتمع السنّي في العراق أنّه لا يوجد فرق كبير بين انتقاماتٍ تمارَس ضده عقب تحرير مدنه من داعش، وتدمير مدنه بالكامل في أثناء تحريرها.
لكن، حتى لو تجاوزنا مركزية المسار السياسي لمواجهة داعش، فإنّ السؤال المهمّ هنا هو: هل يمكن إقناع أبناء الموصل بجدوى المقاربة العسكرية لتحرير مدينتهم، إذا كان مصيرها سيكون كمصير كوباني والرمادي؛ محرّرة. ولكن، بخرابٍ كامل، وهي خلافاً للرمادي وكوباني، واحدة من أعرق الحواضر الإسلامية؟