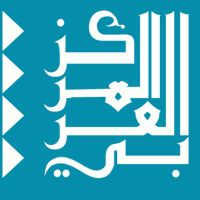24 أكتوبر 2024
لماذا كان انقلاب تركيا الأشدّ دموية أكثر الانقلابات فشلًا؟
متظاهرون أتراك ضد الانقلاب في اسطنبول (19يوليو/2016/Getty)
شهدت تركيا مساء يوم 15 يوليو/ تموز محاولة انقلاب عسكري، بدأت بقطع جسرَي البوسفور اللذين يربطان قسمي إسطنبول الآسيوي والأوروبي. ثم توالت الأنباء عن سيطرة الجيش على مطار إسطنبول ومقر التلفزيون الرسمي (TRT)، قبل أن تتمّ إذاعة البيان اليتيم للانقلاب، بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، وجاء فيه "إنّ القوات المسلحة التركية التي هي مكوِّن مؤسس للجمهورية، وأمانة من القائد العظيم أتاتورك"، وفي إطار "السلام في الوطن، السلام في العالم"، ... قامت بـ "السيطرة على مقاليد الحكم اعتباراً من الساعة 03:00 من صباح 16 تموز / يوليو بهدف تأسيس علاقاتٍ والتعاون بشكل أقوى مع المنظمات والمجتمع الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في العالم"، و"اعتباراً من التوقيت نفسه، تمّ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد". وبحسب مصادر الجيش التركي، يبدو أنّ كشف محاولة الانقلاب عصر يوم 15 تموز / يوليو أدىّ إلى تقديم موعدها بضع ساعات، إذ كان مقرّراً القيام بها عند الثالثة فجرًا في التوقيت المحلي، على أن تتمّ إذاعة بيان الانقلاب عند السادسة صباحاً. وثمة روايات أخرى.
الجيش والسياسة في تركيا
على مدى قرن تقريبًا، كان الجيش الفاعل الرئيس في الحياة السياسية التركية، وعدّ نفسه مؤسس الجمهورية وحامي قيمها. لذلك، كان تدخّله في السياسة أمراً مألوفاً. وقد حكم الجيش تركيا فعلياً منذ الانقلاب الذي وقع ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908. وأصبح، بعد هزيمة السلطنة في الحرب العالمية الأولى، جيش الجمهورية الذي دافع عن حدود تركيا الحالية، وحمى استقلالها، بقيادة أتاتورك، وحكمها مباشرة حتى عام 1946. ففي ذلك العام، قرّر الرئيس عصمت إينونو إعادة الحياة الدستورية، وإجراء انتخابات تعدّدية. لكن، بعد ذلك، قام الجيش بثلاثة انقلابات في الأعوام 1960 و1971 و1980؛ بمعدل انقلاب على رأس كلّ عقد. وقام الجيش أيضاً في 1997 بما أصبحت تعرف "عملية 28 فبراير"، أطاح بموجبها ائتلافًا حكوميًا بقيادة رئيس الوزراء الإسلامي في ذلك الوقت، نجم الدين أربكان، من دون أن يحرّك قوّاته.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2002، حاول حزب العدالة والتنمية مسايرة الجيش المتشكّك والتعايش معه، قبل أن يكشف في عام 2008 عن محاولة انقلابيةٍ، عُرفت باسم "قضية أرغنكون"، أو "المطرقة"، وضُبِط على أثرها مئاتٌ من ضباط الجيش الذين تمت إحالتهم على المحاكمة.
وفي عام 2013، وعلى إثر الخلاف الذي نشب بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحركة
الخدمة، وهي منظمة صوفية أشبه بالأخوية، تغلغلت في مفاصل المجتمع والدولة، أسّسها عام 1970 الداعية فتح الله غولن، جرى ردّ الاعتبار للجيش، بعد أن تبين أنّ معظم المتهمين في المحاولة الانقلابية لم يكونوا متورّطين فيها، بل اتهمتهم جماعة الخدمة التي كانت تُحكم سيطرتها على جهازَي الشرطة والقضاء، مستغلةً الفرصة لتعزيز نفوذها في المؤسسة العسكرية، وغيرها من أجهزة الدولة؛ بحيث بدأت بعدها حكومة "العدالة والتنمية" إعادة بناء الشرطة والدرك وإدخال عناصر موالية لها فيهما.
لكن، على ما يبدو، ظلّ جزء من الجيش غير راضٍ عن أداء حكومة العدالة والتنمية، وسياساتها الداخلية والخارجية، وبدا غير مستعد أيضاً للقبول بتزايد قوة حكومة مدنية منتخبة، وسيطرتها على الجيش، وتحديد دوره بالدفاع عن حدود البلاد، بدلاً من الاستمرار في محاولة التدخّل في السياسة. وقد قيّد عدم التوافق بين الحكومة والجيش السياسة التركية في سورية. وخلال الفترة الأخيرة، تعاظمت احتمالات القيام بانقلاب، لا سيما في ضوء تنامي التهديدات الأمنية، بعد أن أعلن كلٌ من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية الحرب على تركيا، فضلاً عن تزايد الخلافات التركية مع روسيا وإسرائيل ودول غربية عديدة، في مقدمتها الولايات المتحدة. واستباقاً لحملة تطهير جديدة في أوساط الضباط المشكوك في ولائهم، يقوم بها عادةً المجلس العسكري الأعلى (YAS)، عندما يصدر قائمة الترفيعات والتنقلات في أغسطس/ آب من كلّ عام، سرّع الانقلابيون، على ما يبدو، جهدهم لإطاحة حكومة "العدالة والتنمية". ويبدو أنّ الاتهامات الداخلية لسياسة أردوغان بالتسبّب في عزلة تركيا بين حلفائها التقليديين كانت من أسباب محاولة تركيا تسوية بعض الخلافات الخارجية، لتقليل أسباب التوتر الداخلي.
أسباب الفشل
على الرغم من توفر عوامل كثيرة لنجاح الانقلاب، مثل عنصر المباغتة، لناحية التوقيت على
الأقل، وردود الأفعال الدولية الضعيفة، وامتلاك المتمرّدين قوةً ناريةً كبيرة، مثل الطيران والدبابات التي نزلت إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة، في ضوء مشاركة مختلف صنوف الأسلحة وضباط كبار في الجيش التركي، فشلت المحاولة الانقلابية. وكان أبرز أسباب الفشل هو إجماع الطبقة السياسية والنخب الفكرية ووسائل الإعلام، وقطاعات عريضة من الشعب التركي، على رفض الانقلاب؛ فقد عارضته قوى المعارضة الرئيسة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري الذي يعدّ الوريث السياسي والفكري للتيار العلماني الأتاتوركي، وحزب الحركة القومية، وهو حزب قومي يميني متطرف، وحزب الشعوب الكردي الذي يعبّر عن رأيٍ عام كردي معارض بشدة الجيش التركي المسؤول عن سياسة تتريك الأكراد. وعلى الرغم من اختلافاتها الكبيرة مع الحزب الحاكم في السياسات والتوجهات الفكرية والأيديولوجية، عبّرت هذه الأحزاب عن رفضها الانقلاب.
وقد استنفر الانقلابيون كلّ القوى السياسية في البلاد ضدهم، بهجومهم على البرلمان، بحيث قصفته الطائرات سبع مرات متتالية غداة الانقلاب، وهي المرة الأولى التي يَستهدف فيها أيّ انقلاب عسكري البرلمان التركي الذي يعدّه أتراكٌ كثيرون رمزاً لحياتهم السياسية والحزبية وتجربتهم الديمقراطية. ورفضت وسائل الإعلام أيضاً، على اختلاف توجهاتها، الوقوف إلى جانب الانقلاب. لا بل يعود الفضل إلى وسائل إعلام تركية معارضة في إعطاء الفرصة لقادة الحزب والدولة للظهور على شاشاتها، وتوجيه رسائل من خلالها، بعد أن سيطر الانقلابيون على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكان لظهور الرئيس أردوغان في مكالمة هاتفية مصوّرة على قناة "سي أن أن تورك"، المملوكة لمجموعة دوغان، ذات التوجهات العلمانية المتشدّدة، أثر رئيس في إجهاض محاولة الانقلاب؛ إذ وجّه رسالةً إلى الشعب التركي، طالبه فيها بتحدّي إرادة الانقلابيين، والنزول إلى الشوارع للدفاع عن ديمقراطيته. وظهر على وسائل الإعلام أيضاً كلٌ من رئيس الحكومة، بنعلي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الحكومة السابق، أحمد داود أوغلو، وغيرهم من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، مطالبين الشعب التركي برفض الانقلاب والاحتشاد في الشوارع. وقام الشعب التركي بالدور الأكبر في إجهاض الانقلاب؛ إذ نزل الجمهور إلى الشارع، وتحدّى عنف الجيش الذي لم يتردّد بعض وحداته في إطلاق النار على المدنيين، علماً أنّ الانقلاب أدّى إلى سقوط 300 قتيل تقريبًا، كان نصفهم من المدنيين. وقامت بعض وحدات الجيش التي ظلّت على ولائها للحكومة المنتخبة، مثل الجيش الأول الذي أمّن الحماية لعودة الرئيس إلى إسطنبول، عبر مطار أتاتورك، ووحدات الشرطة والقوات الخاصة، بدور مهم في إجهاض الانقلاب.
ولفشل الانقلابيين في الوصول إلى الرئيس وقتله أو اعتقاله في مقر إقامته في مرمريس، دورٌ رئيس أيضًا في إفشال الانقلاب. فعادة تثبت الانقلابات العسكرية انتصارها للشعب باعتقال القيادة السياسية للدولة أو قتلها، لكي يستسلم الناس للأمر الواقع والحكام الجدد.
ويبدو أنّ القوى العسكرية التي شاركت في الانقلاب، أو أيّدته، كانت أكبر ممّا روّجته الحكومة أوّل وهلة. وكان لترويج فكرة أنّ الجيش غير مشارك أثرٌ كبير في ردة فعل الجمهور الذي تشجَّع وخرج إلى الشارع. ولكن الاعتقالات اللاحقة شملت قادة ثلاثة جيوش من أربعة، وقياداتٍ رئيسة في سلاح الطيران والبحرية والاستخبارات العسكرية. ومن ثمّ، لم يكن هذا انقلاب ضباطٍ قلائل من الرتب الوسطى والدنيا. كما أنّ الحكومة لم تجد سوى قوات الدرك والمخابرات، لتأتمر بأوامرها في الساعات الأولى.
وهذا يعني أنه ينتظر الحكومة عملٌ مكثفٌ ومتشعب في الجيش. وقد يعني ذلك إعادة هيكلته، والتأثير مؤقتاً على دور تركيا الإقليمي، فسوف تنشغل تركيا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، ولا سيما الجيش وأجهزة الدولة.
المواقف الدولية
مثّلت المواقف الدولية، وخصوصاً الموقف الأميركي، صدمةً بالنسبة إلى الحكومة التركية؛ إذ
كان متوقعاً أن يصدر عن الإدارة الأميركية موقفٌ فوري، يندّد بالانقلاب، ويدعم الحكومة الشرعية المنتخبة. لكن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري الذي سُئل عن موقفه من المحاولة الانقلابية الجارية في تركيا، في مؤتمر صحفي كان يعقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ختام زيارة له إلى موسكو مخصصة للبحث في التنسيق الروسي - الأميركي في سورية، اكتفى بالتعبير عن أمله "بأن يكون هناك استقرار وسلام واستمرار في تركيا". وما زاد الأمر سوءًا أنّ السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت بيانًا ليلة الانقلاب، رأت فيه أنّ ما يجري في تركيا "انتفاضة". وفي اليوم التالي، أصدر البيت الأبيض بياناً استنكر فيه المحاولة الانقلابية التي اتضح فشلها، ومحض فيه الدعم للحكومة التركية "المدنية والمنتخبة ديمقراطيًا"؛ وتضمّن البيان أيضًا حثًا لجميع الأطراف في الأزمة التركية على التصرّف في إطار القانون وضبط النفس وتجنّب العنف وسفك الدماء، وأيّ أفعال قد تؤدي إلى انعدام الاستقرار.
أثار هذا الموقف تساؤلاتٍ كثيرة بين المسؤولين الأتراك، بشأن حقيقة الموقف الأميركي ممّا جرى، ووصل الأمر إلى حدّ اتهام وزير العمل التركي الولايات المتحدة بأنّها "دبّرت" محاولة الانقلاب، بينما كتب أحد رؤساء تحرير الصحف القريبة من الحكومة مقالةً على الصفحة الأولى بعنوان "الولايات المتحدة تحاول اغتيال أردوغان". وقد نفت الإدارة الأميركية هذه الاتهامات، وعبّرت عن ذلك برفضها منح اللجوء السياسي لقائد قاعدة إنجرليك التركية الذي ألقي القبض عليه لاحقاً لدوره في التخطيط للانقلاب العسكري. بيد أنّ تركيا طالبت واشنطن أيضاً بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا، بوصفه المدبّر الفعلي للمحاولة الانقلابية. لكنّ واشنطن طالبت أنقرة بتقديم أدلةٍ على تورّطه. وعلى كل حال، وعلى الرغم من اهتمام أردوغان بتخفيف النبرة نحو الولايات المتحدة واعتماد لغة تصالحية، وتواصل أوباما المباشر معه، يتضح أنّ الولايات المتحدة لم تُبد حماسًا للحفاظ على النظام الديمقراطي في تركيا، ولم تكن لتأسف على إطاحة أردوغان.
ردة فعل الحكومة
على أثر فشل المحاولة الانقلابية الأكثر دمويةً في تاريخ الانقلابات التي شهدتها الجمهورية التركية منذ نشأتها عام 1923، اتخذت الحكومة التركية التي راعها حجم المشاركة فيها جملة إجراءاتٍ، تمخّض عنها اعتقال كلّ من يشتبه بتورّطه في المحاولة الانقلابية، أو الانتماء إلى جماعة الخدمة، أو طرده. وشمل العدد نحو 35 ألفًا تمّ طردهم أو اعتقالهم من ضباط الجيش والشرطة والجهاز القضائي. وتمّ تجميد عمل أكثر من 15 ألف موظف في وزارة التعليم، وأُقيل أكثر من 1500 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وسُحبت رخصة العمل من أكثر من 20 ألف مدرس في المدارس الخاصة. أمّا وزارة الداخلية فقد أعلنت أنّها جمّدت عمل نحو تسعة آلاف من منتسبيها، للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة، ومئات من قوات الدرك، كما عُزِل ولاةٌ ومفتشون ومستشارون في الوزارة، أو جُمِّد عملهم. وأبدت الحكومة رغبتها في إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُوقف العمل بها عام 2004، بوصفها جزءًا من حزمة الإجراءات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي للمضيّ في مفاوضات ضمّ تركيا إلى الاتحاد. وقد أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ "ثلاثة أشهر بموجب المادة 120 من الدستور"، وبرّر هذا الإعلان بأنه يأتي في ظل وجود حالة العنف والتعرض للحريات، وأكّد أنّ هذه الحالة لن تكون ضد الحقوق والحريات والديمقراطية، بل لتعزيزها.
جلبت هذه الإجراءات ردود أفعال ناقدة، بخاصة في أوساطٍ إعلامية وسياسية غربية، ووُجِّهت إلى الحكومة اتهاماتٌ بأنّها ربما تستخدم المحاولة الانقلابية الفاشلة ذريعةً للقيام بعملية اجتثاث كامل لخصومها في مختلف الأجهزة والمؤسسات، على نمط عملية "اجتثاث البعث" سيء الصيت التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها العراقيون، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين. لكن الحكومة تنفي، من جهتها، ممارسة عمليات تطهير وانتقام، وترى أنّ عمق تغلغل جماعة الخدمة في أجهزة الدولة ومؤسساتها يستدعي منها اتخاذ إجراءاتٍ تَحول نهائياً دون إمكانية حصول محاولة أخرى للانقلاب على الديمقراطية والشرعية التي يحدّدها الدستور وتقرّرها الإرادة الشعبية.
وعلى كل حال، إن تحميل حركة خدمة كلها المسؤولية عن الانقلاب قد يتحوّل إلى محاولة اجتثاث، فالحركة ليست صغيرة، وربما يتجاوز عدد اعضاؤها المليون. ولا بد من حصر تهمة الانقلاب بالمسؤولين عنه والمشاركين فيه، أما الحركة فالتعامل معها: تقييدها أو حلها أو غيره، لا يتطلب اتهام كل عضو فيها بالمسؤولية عن الانقلاب، أو تحويلها إلى جماعةٍ إرهابيةٍ واتباع أسلوب الاجتثاث معها.
وفي المرحلة المقبلة، سوف يتكشّف، إذا ما كانت الحكومة تقوم باجتثاث الخصوم السياسيين، أم هي عملية تحرير مفاصل الدولة من الكيان الموازي المتغلغل فيها. ويجب ألّا ننسى أنّ أصل مصطلح "الدولة العميقة" تركي، وقُصد به تحديدًا القوى الحقيقية الفاعلة داخل الدولة التركية، الأمنية بخاصة، وتديرها من وراء الكواليس، وتمنع حصول التحوّل الديمقراطي فيها. ولكن يقظة الرأي العام التركي والمجتمع المدني والأحزاب والإعلام هي التي ستمنع عملية تصفية أذرع الانقلاب من التحوّل إلى عملية اجتثاثٍ شاملةٍ معاديةٍ للديمقراطية، كما منعت الجيش من الانقلاب عليها. فالشعب التركي، بقواه الفاعلة وأحزابه ووسائل إعلامه الرئيسة، هو الذي أحبط الانقلاب العسكري، ودافع عن الديمقراطية، وليس الحكومات الأجنبية التي تبدي الآن حرصها على الديمقراطية.
خلاصة
ثمة عِبرٌ كثيرة تُستخلص من أحداث الانقلاب العسكري الخطير في تركيا، واستخلاصها مهمة الحكومة والشعب التركيَين والأحزاب التركية. ولكن المغزى الواضح عربيًا أنّه لو انقسم المجتمع التركي بين حزب العدالة والتنمية وخصومه لَما كان ممكنًا دحر الانقلاب والانتصار للنظام الديمقراطي. ولا يغيب حتى عن الذاكرة القصيرة كيف انقسمت مصر بين الإسلاميين وخصومهم، وكيف أودى هذا الاستقطاب بالتجربة الديمقراطية الوليدة والهشّة.
الجيش والسياسة في تركيا
على مدى قرن تقريبًا، كان الجيش الفاعل الرئيس في الحياة السياسية التركية، وعدّ نفسه مؤسس الجمهورية وحامي قيمها. لذلك، كان تدخّله في السياسة أمراً مألوفاً. وقد حكم الجيش تركيا فعلياً منذ الانقلاب الذي وقع ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908. وأصبح، بعد هزيمة السلطنة في الحرب العالمية الأولى، جيش الجمهورية الذي دافع عن حدود تركيا الحالية، وحمى استقلالها، بقيادة أتاتورك، وحكمها مباشرة حتى عام 1946. ففي ذلك العام، قرّر الرئيس عصمت إينونو إعادة الحياة الدستورية، وإجراء انتخابات تعدّدية. لكن، بعد ذلك، قام الجيش بثلاثة انقلابات في الأعوام 1960 و1971 و1980؛ بمعدل انقلاب على رأس كلّ عقد. وقام الجيش أيضاً في 1997 بما أصبحت تعرف "عملية 28 فبراير"، أطاح بموجبها ائتلافًا حكوميًا بقيادة رئيس الوزراء الإسلامي في ذلك الوقت، نجم الدين أربكان، من دون أن يحرّك قوّاته.
ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2002، حاول حزب العدالة والتنمية مسايرة الجيش المتشكّك والتعايش معه، قبل أن يكشف في عام 2008 عن محاولة انقلابيةٍ، عُرفت باسم "قضية أرغنكون"، أو "المطرقة"، وضُبِط على أثرها مئاتٌ من ضباط الجيش الذين تمت إحالتهم على المحاكمة.
وفي عام 2013، وعلى إثر الخلاف الذي نشب بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحركة
لكن، على ما يبدو، ظلّ جزء من الجيش غير راضٍ عن أداء حكومة العدالة والتنمية، وسياساتها الداخلية والخارجية، وبدا غير مستعد أيضاً للقبول بتزايد قوة حكومة مدنية منتخبة، وسيطرتها على الجيش، وتحديد دوره بالدفاع عن حدود البلاد، بدلاً من الاستمرار في محاولة التدخّل في السياسة. وقد قيّد عدم التوافق بين الحكومة والجيش السياسة التركية في سورية. وخلال الفترة الأخيرة، تعاظمت احتمالات القيام بانقلاب، لا سيما في ضوء تنامي التهديدات الأمنية، بعد أن أعلن كلٌ من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية الحرب على تركيا، فضلاً عن تزايد الخلافات التركية مع روسيا وإسرائيل ودول غربية عديدة، في مقدمتها الولايات المتحدة. واستباقاً لحملة تطهير جديدة في أوساط الضباط المشكوك في ولائهم، يقوم بها عادةً المجلس العسكري الأعلى (YAS)، عندما يصدر قائمة الترفيعات والتنقلات في أغسطس/ آب من كلّ عام، سرّع الانقلابيون، على ما يبدو، جهدهم لإطاحة حكومة "العدالة والتنمية". ويبدو أنّ الاتهامات الداخلية لسياسة أردوغان بالتسبّب في عزلة تركيا بين حلفائها التقليديين كانت من أسباب محاولة تركيا تسوية بعض الخلافات الخارجية، لتقليل أسباب التوتر الداخلي.
أسباب الفشل
على الرغم من توفر عوامل كثيرة لنجاح الانقلاب، مثل عنصر المباغتة، لناحية التوقيت على
وقد استنفر الانقلابيون كلّ القوى السياسية في البلاد ضدهم، بهجومهم على البرلمان، بحيث قصفته الطائرات سبع مرات متتالية غداة الانقلاب، وهي المرة الأولى التي يَستهدف فيها أيّ انقلاب عسكري البرلمان التركي الذي يعدّه أتراكٌ كثيرون رمزاً لحياتهم السياسية والحزبية وتجربتهم الديمقراطية. ورفضت وسائل الإعلام أيضاً، على اختلاف توجهاتها، الوقوف إلى جانب الانقلاب. لا بل يعود الفضل إلى وسائل إعلام تركية معارضة في إعطاء الفرصة لقادة الحزب والدولة للظهور على شاشاتها، وتوجيه رسائل من خلالها، بعد أن سيطر الانقلابيون على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكان لظهور الرئيس أردوغان في مكالمة هاتفية مصوّرة على قناة "سي أن أن تورك"، المملوكة لمجموعة دوغان، ذات التوجهات العلمانية المتشدّدة، أثر رئيس في إجهاض محاولة الانقلاب؛ إذ وجّه رسالةً إلى الشعب التركي، طالبه فيها بتحدّي إرادة الانقلابيين، والنزول إلى الشوارع للدفاع عن ديمقراطيته. وظهر على وسائل الإعلام أيضاً كلٌ من رئيس الحكومة، بنعلي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غل، ورئيس الحكومة السابق، أحمد داود أوغلو، وغيرهم من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، مطالبين الشعب التركي برفض الانقلاب والاحتشاد في الشوارع. وقام الشعب التركي بالدور الأكبر في إجهاض الانقلاب؛ إذ نزل الجمهور إلى الشارع، وتحدّى عنف الجيش الذي لم يتردّد بعض وحداته في إطلاق النار على المدنيين، علماً أنّ الانقلاب أدّى إلى سقوط 300 قتيل تقريبًا، كان نصفهم من المدنيين. وقامت بعض وحدات الجيش التي ظلّت على ولائها للحكومة المنتخبة، مثل الجيش الأول الذي أمّن الحماية لعودة الرئيس إلى إسطنبول، عبر مطار أتاتورك، ووحدات الشرطة والقوات الخاصة، بدور مهم في إجهاض الانقلاب.
ولفشل الانقلابيين في الوصول إلى الرئيس وقتله أو اعتقاله في مقر إقامته في مرمريس، دورٌ رئيس أيضًا في إفشال الانقلاب. فعادة تثبت الانقلابات العسكرية انتصارها للشعب باعتقال القيادة السياسية للدولة أو قتلها، لكي يستسلم الناس للأمر الواقع والحكام الجدد.
ويبدو أنّ القوى العسكرية التي شاركت في الانقلاب، أو أيّدته، كانت أكبر ممّا روّجته الحكومة أوّل وهلة. وكان لترويج فكرة أنّ الجيش غير مشارك أثرٌ كبير في ردة فعل الجمهور الذي تشجَّع وخرج إلى الشارع. ولكن الاعتقالات اللاحقة شملت قادة ثلاثة جيوش من أربعة، وقياداتٍ رئيسة في سلاح الطيران والبحرية والاستخبارات العسكرية. ومن ثمّ، لم يكن هذا انقلاب ضباطٍ قلائل من الرتب الوسطى والدنيا. كما أنّ الحكومة لم تجد سوى قوات الدرك والمخابرات، لتأتمر بأوامرها في الساعات الأولى.
وهذا يعني أنه ينتظر الحكومة عملٌ مكثفٌ ومتشعب في الجيش. وقد يعني ذلك إعادة هيكلته، والتأثير مؤقتاً على دور تركيا الإقليمي، فسوف تنشغل تركيا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، ولا سيما الجيش وأجهزة الدولة.
المواقف الدولية
مثّلت المواقف الدولية، وخصوصاً الموقف الأميركي، صدمةً بالنسبة إلى الحكومة التركية؛ إذ
أثار هذا الموقف تساؤلاتٍ كثيرة بين المسؤولين الأتراك، بشأن حقيقة الموقف الأميركي ممّا جرى، ووصل الأمر إلى حدّ اتهام وزير العمل التركي الولايات المتحدة بأنّها "دبّرت" محاولة الانقلاب، بينما كتب أحد رؤساء تحرير الصحف القريبة من الحكومة مقالةً على الصفحة الأولى بعنوان "الولايات المتحدة تحاول اغتيال أردوغان". وقد نفت الإدارة الأميركية هذه الاتهامات، وعبّرت عن ذلك برفضها منح اللجوء السياسي لقائد قاعدة إنجرليك التركية الذي ألقي القبض عليه لاحقاً لدوره في التخطيط للانقلاب العسكري. بيد أنّ تركيا طالبت واشنطن أيضاً بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا، بوصفه المدبّر الفعلي للمحاولة الانقلابية. لكنّ واشنطن طالبت أنقرة بتقديم أدلةٍ على تورّطه. وعلى كل حال، وعلى الرغم من اهتمام أردوغان بتخفيف النبرة نحو الولايات المتحدة واعتماد لغة تصالحية، وتواصل أوباما المباشر معه، يتضح أنّ الولايات المتحدة لم تُبد حماسًا للحفاظ على النظام الديمقراطي في تركيا، ولم تكن لتأسف على إطاحة أردوغان.
ردة فعل الحكومة
على أثر فشل المحاولة الانقلابية الأكثر دمويةً في تاريخ الانقلابات التي شهدتها الجمهورية التركية منذ نشأتها عام 1923، اتخذت الحكومة التركية التي راعها حجم المشاركة فيها جملة إجراءاتٍ، تمخّض عنها اعتقال كلّ من يشتبه بتورّطه في المحاولة الانقلابية، أو الانتماء إلى جماعة الخدمة، أو طرده. وشمل العدد نحو 35 ألفًا تمّ طردهم أو اعتقالهم من ضباط الجيش والشرطة والجهاز القضائي. وتمّ تجميد عمل أكثر من 15 ألف موظف في وزارة التعليم، وأُقيل أكثر من 1500 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وسُحبت رخصة العمل من أكثر من 20 ألف مدرس في المدارس الخاصة. أمّا وزارة الداخلية فقد أعلنت أنّها جمّدت عمل نحو تسعة آلاف من منتسبيها، للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة، ومئات من قوات الدرك، كما عُزِل ولاةٌ ومفتشون ومستشارون في الوزارة، أو جُمِّد عملهم. وأبدت الحكومة رغبتها في إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُوقف العمل بها عام 2004، بوصفها جزءًا من حزمة الإجراءات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي للمضيّ في مفاوضات ضمّ تركيا إلى الاتحاد. وقد أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ "ثلاثة أشهر بموجب المادة 120 من الدستور"، وبرّر هذا الإعلان بأنه يأتي في ظل وجود حالة العنف والتعرض للحريات، وأكّد أنّ هذه الحالة لن تكون ضد الحقوق والحريات والديمقراطية، بل لتعزيزها.
جلبت هذه الإجراءات ردود أفعال ناقدة، بخاصة في أوساطٍ إعلامية وسياسية غربية، ووُجِّهت إلى الحكومة اتهاماتٌ بأنّها ربما تستخدم المحاولة الانقلابية الفاشلة ذريعةً للقيام بعملية اجتثاث كامل لخصومها في مختلف الأجهزة والمؤسسات، على نمط عملية "اجتثاث البعث" سيء الصيت التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها العراقيون، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين. لكن الحكومة تنفي، من جهتها، ممارسة عمليات تطهير وانتقام، وترى أنّ عمق تغلغل جماعة الخدمة في أجهزة الدولة ومؤسساتها يستدعي منها اتخاذ إجراءاتٍ تَحول نهائياً دون إمكانية حصول محاولة أخرى للانقلاب على الديمقراطية والشرعية التي يحدّدها الدستور وتقرّرها الإرادة الشعبية.
وعلى كل حال، إن تحميل حركة خدمة كلها المسؤولية عن الانقلاب قد يتحوّل إلى محاولة اجتثاث، فالحركة ليست صغيرة، وربما يتجاوز عدد اعضاؤها المليون. ولا بد من حصر تهمة الانقلاب بالمسؤولين عنه والمشاركين فيه، أما الحركة فالتعامل معها: تقييدها أو حلها أو غيره، لا يتطلب اتهام كل عضو فيها بالمسؤولية عن الانقلاب، أو تحويلها إلى جماعةٍ إرهابيةٍ واتباع أسلوب الاجتثاث معها.
وفي المرحلة المقبلة، سوف يتكشّف، إذا ما كانت الحكومة تقوم باجتثاث الخصوم السياسيين، أم هي عملية تحرير مفاصل الدولة من الكيان الموازي المتغلغل فيها. ويجب ألّا ننسى أنّ أصل مصطلح "الدولة العميقة" تركي، وقُصد به تحديدًا القوى الحقيقية الفاعلة داخل الدولة التركية، الأمنية بخاصة، وتديرها من وراء الكواليس، وتمنع حصول التحوّل الديمقراطي فيها. ولكن يقظة الرأي العام التركي والمجتمع المدني والأحزاب والإعلام هي التي ستمنع عملية تصفية أذرع الانقلاب من التحوّل إلى عملية اجتثاثٍ شاملةٍ معاديةٍ للديمقراطية، كما منعت الجيش من الانقلاب عليها. فالشعب التركي، بقواه الفاعلة وأحزابه ووسائل إعلامه الرئيسة، هو الذي أحبط الانقلاب العسكري، ودافع عن الديمقراطية، وليس الحكومات الأجنبية التي تبدي الآن حرصها على الديمقراطية.
خلاصة
ثمة عِبرٌ كثيرة تُستخلص من أحداث الانقلاب العسكري الخطير في تركيا، واستخلاصها مهمة الحكومة والشعب التركيَين والأحزاب التركية. ولكن المغزى الواضح عربيًا أنّه لو انقسم المجتمع التركي بين حزب العدالة والتنمية وخصومه لَما كان ممكنًا دحر الانقلاب والانتصار للنظام الديمقراطي. ولا يغيب حتى عن الذاكرة القصيرة كيف انقسمت مصر بين الإسلاميين وخصومهم، وكيف أودى هذا الاستقطاب بالتجربة الديمقراطية الوليدة والهشّة.