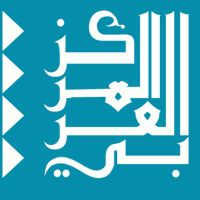24 أكتوبر 2024
إستراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب.. هل تحمل جديدًا؟
ترامب يعلن استراتيجية الأمن القومي الأميركي (18/12/2017فرانس برس)
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017، خطتها لما تعرف بـ "إستراتيجية الأمن القومي الأميركي". وتنطلق الخطة الجديدة من شعار حملة ترامب الانتخابية "أميركا أولًا". وتحدّد الإستراتيجية الجديدة مصادر التهديد لقوة أميركا وحلفائها في ثلاث مجموعات: القوى المنافسة وتحدّدها في روسيا والصين، والدول المارقة وتحدّدها في إيران وكوريا الشمالية، والمنظمات الإجرامية و"الجهادية الإرهابية" العابرة للحدود.
نقد مقاربات الإدارات السابقة
تُوجِّه الإستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب نقدًا مبطنًا إلى إدارات أميركية سبقتها، خصوصًا المقاربتين الأمنيتين القوميتين لإدارتَي سلفَيْه جورج بوش الابن وباراك أوباما. وتشمل انتقادات ترامب تركيز إدارات سابقة على "التعاون" مع الحلفاء، وأطراف دولية أخرى، على حساب المصالح الأميركية. ويذكر مثالًا على ذلك توقيع اتفاقيات تجارية دولية جائرة بحق الولايات المتحدة، والاستثمار في بناء دول أجنبية وإهمال البناء في الولايات المتحدة. كما أنه انتقد عدم إصرار الإدارات السابقة على أن يدفع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مخصّصاتهم للحلف كاملة؛ وهو ما سدّد ثمنه دافع الضرائب الأميركي والقوات العسكرية الأميركية. وانتقد كذلك عدم التصدّي لكوريا الشمالية مبكرًا، قبل أن تتحوّل إلى تهديد نووي حقيقي. وغمز من قناة "الصفقة الكارثية" مع إيران، عام 2015، فيما يتعلق ببرنامجها النووي، كما انتقد وضع قيود على إنتاج الطاقة أميركيًّا، وعدم تعزيز الأمن على الحدود الأميركية للحد من موجات الهجرة غير الشرعية. وانطلاقًا من نقده ذاك، أعلن أن إدارته ستعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة.
"التنافس" بين "دول ذات سيادة"
يقوم عماد الإستراتيجية الأمنية القومية الجديدة للولايات المتحدة على افتراض وجود تنافسٍ دوليٍّ على المصالح بين أطراف مختلفة، على أساس أن "السباق نحو القوة ثابتٌ تاريخيٌّ لا يتغير". وترى إدارة ترامب أن هذا التنافس يجب أن يكون بين دولٍ "ذات سيادة"، وأنه
"أفضل أمل لعالم يسوده السلام، وللمصالح القومية الأميركية". غير أن الإستراتيجية الجديدة تنبّه إلى أن التنافس اليوم تشارك فيه دول مارقة، مثل كوريا الشمالية وإيران، ومنظمات إرهابية وإجرامية عابرة للقارات. وحتى ضمن "الدول ذات السيادة"؛ تشكك المقاربة في دور دولتين مركزيتين، وهما روسيا والصين، على أساس أنهما لا تقبلان قواعد النظام الدولي القائم على النفوذ الأميركي. وتخلص الوثيقة إلى أن المجموعات الثلاث السابقة "تنافس في الساحات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما تستخدم التكنولوجيا والمعلومات لتسريع المنافسات، بهدف تغيير توازنات القوى الإقليمية لمصلحتها". وإزاء تلك التحدّيات، تؤكّد الإستراتيجية الجديدة أن الولايات المتحدة ستكون لديها الإجابة عن "تصاعد المنافسة الدولية سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا"؛ ذلك أنه "كما أن الضعف الأميركي يأتي بالتحدّيات، فإن القوة والثقة الأميركيتين تمنعان الحرب وتعزّزان السلام".
ركائز الإستراتيجية الجديدة
للتصدّي للتحديات السابقة في سياق "التنافس"، فإن الإستراتيجية الجديدة تنطلق من "الواقعية المبدئية"، وتسترشد بالمصالح القومية الأميركية، وتتطلب "دمج كل عناصر القوة القومية والمنافسة بكل وسيلة متاحة لنا". وتحدّد الإستراتيجية أربع ركائز لتحقيق ذلك، هي:
1.حماية الشعب الأميركي ونمط عيشه، ويتم ذلك من خلال:
• تعزيز أمن الحدود الأميركية، بما في ذلك بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، أو "إرهابيين" محتملين، وإعادة النظر في قوانين الهجرة وما فيها من ثغرات.
• الاستمرار في مواجهة "الجهاديين الإرهابيين" وهزيمتهم، هم وأيديولوجيتهم العنيفة، ومنع انتقالها إلى الولايات المتحدة، وانتشارها فيها، خصوصًا عبر الفضاء الإلكتروني.
• تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للقارات، كعصابات المخدّرات.
• تعزيز الأمن الإلكتروني الأميركي، في ظل الهجمات والقرصنة الإلكترونية المتصاعدة.
• الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية، ومنع وصولها إلى أعداء الولايات المتحدة، وتعزيز الدفاعات الأميركية للتصدّي لأي هجومٍ بأسلحة دمار شامل، بما في ذلك كوريا الشمالية.
2. تعزيز الازدهار الأميركي. بحسب ترامب، تعترف الإستراتيجية الأمنية القومية، لأول مرة، أن "الأمن الاقتصادي هو أمن قومي". ويضيف: "الحيوية الاقتصادية، والنمو، والازدهار الداخلي، هي ضرورات للقوة والتأثير الأميركيين الخارجيين"، ويتحقق ذلك من خلال:
• تحديث البنية التحتية الأميركية كاملة، من طرق وجسور ومطارات واتصالات وممرّات مائية.
• بناء علاقات اقتصادية خارجية عادلة ومتبادلة، ووضع حد للعلاقات التجارية المختلة والمجحفة بحق الولايات المتحدة.
• تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة، عبر رفع القيود عن استغلال مخزونات الطاقة الأميركية الوفيرة، بما في ذلك، الغاز الطبيعي، والفحم، والبترول، والطاقة المتجددة.
• الريادة في البحث العلمي، والتكنولوجيا، والاختراع.
3. الحفاظ على السلام عبر القوة. يرى ترامب أن "الضعف هو أقصر الطرق لوقوع الصراعات، والقوة التي لا تضاهى هي أنجع الوسائل للدفاع". ولذلك، فإن الإستراتيجية الجديدة تدعو إلى:
• تعزيز القدرات التنافسية الأميركية، في مجال الردع والأسلحة الحديثة، وأسلوب القيادة العسكرية ومقاربة الأخطار.
• تجديد القدرات العسكرية الأميركية، من حيث التسليح والصناعة والعمل الاستخباراتي، وفي مجال الحروب الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز السيطرة الأميركية في مجال الفضاء، ووقف أي اقتطاعاتٍ في الموازنة العسكرية، إذا كانت تؤثر سلبيًّا في ذلك.
• تعزيز القدرات التنافسية الدبلوماسية، وجعل الدبلوماسية الأميركية في خدمة المصالح القومية الأميركية، بما في ذلك المصالح الاقتصادية.
4. تعزيز النفوذ الأميركي في العالم.. يشدّد ترامب، في هذا البند، على أن النفوذ الأميركي على الصعيد العالمي مرتبط بقوة أميركا داخليًّا. كما أنه يشدّد على أن أميركا ستحافظ على تحالفاتها الدولية، شريطة أن يقوم الحلفاء أيضًا بالأدوار المطلوبة منهم، وأن يكون التعاون متبادلًا. وتفيد الوثيقة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن قيمها، من دون محاولة فرضها على أحد، وفي هذا نقد ضمني لفكرة تصدير الديمقراطية، أو التضامن مع قضايا مثل حقوق الإنسان في الخارج.
الشرق الأوسط في الإستراتيجية الجديدة
لم يغب الشرق الأوسط عن الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة، غير أن حضوره كان عبر أزماته. فبحسب هذه الإستراتيجية، تهدف الولايات المتحدة إلى أن لا يكون الشرق الأوسط "ملاذًا آمنًا أو أرضًا خصبة للإرهابيين الجهاديين، وأن لا تهيمن عليه أي قوةٍ معاديةٍ للولايات المتحدة، وبأن يبقى مصدرًا لاستقرار سوق الطاقة العالمي". وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط كان دائمًا على رأس الأجندة الأمنية القومية للولايات المتحدة، عبر إداراتها المتعاقبة، بما في ذلك إدارتَي بوش وأوباما، فإن إدارة ترامب تُحَمِّلُ، ضمنيًّا، إدارتيهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الإقليم والمتعلقة "بالتوسع الإيراني، وتنامي الأيديولوجيا الجهادية، والركود الاجتماعي والاقتصادي، والمنافسات الإقليمية التي هزّت الشرق الأوسط". ووفق تلك المقاربة، فإن إصرار إدارة بوش على إحداث تحول ديمقراطي في الشرق الأوسط، ومحاولة إدارة أوباما فك ارتباطها بهذه المنطقة، لم يحصّنا الولايات المتحدة من مشكلاتها. وعلى الرغم من ذلك، لا تقدّم إستراتيجية إدارة ترامب حلولًا لمشكلات الإقليم على نحو مختلف جوهريًّا عن الإدارات السابقة، بل إنها تغرق في توصيف المشكلات كما يلي:
• تمثّل المنطقة موطن المنظمات الإرهابية الأخطر في العالم، وأهمها "داعش" و"القاعدة"، وقد ساهمت هذه المنظمات في إحداث حالة من اللااستقرار في المنطقة.
• استغلت إيران هذه الحالة، لتوسيع نفوذها في المنطقة من خلال وكلائها وشركائها، وهي تواصل زعزعة استقرار المنطقة وإدامة العنف فيها. هذا فضلًا عن استمرارها في تطوير برنامج صواريخها الباليستية، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية، وشن الهجمات الإلكترونية، على الرغم من توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
• ليس الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي السبب الرئيس في أزمات المنطقة، بل التهديد الإيراني وتهديد التنظيمات الإرهابية (وهذا التحليل مماثل للموقف الرسمي الإسرائيلي).
• يدرك زعماء كثيرون في المنطقة هذه المعطيات، ويعملون مع الولايات المتحدة على مكافحة التطرّف والإرهاب، والتصدّي لجهود إيران التخريبية في المنطقة، وهم يرون في إسرائيل شريكًا في ذلك.
خلاصة
تتمثّل الإستراتيجية المعلنة في ورقةٍ تجمع بين الشعبوية القومية ومواقف اليمين المتشدّد في السياسة الخارجية، بما في ذلك لغة ومفردات تجنبت الإدارات السابقة استخدامها، ومواقف المؤسسة الحاكمة ومحاولاتها كبح نزوات الرئيس. وقد نجحت الإستراتيجية الجديدة، في رأي المدافعين عنها، في التوفيق بين تفادي السقوط في فخ الانعزالية، وعدم الانجرار إلى تحالفاتٍ دوليةٍ لا تكون الولايات المتحدة القائدة فيها، ولا يتقاسم الحلفاء الأعباء كما يفترض بهم. ويذهب هؤلاء إلى أنها تمثّل عودةً إلى نظرةٍ عالمية، توحي بحقبة "القوى العظمى" في القرن التاسع عشر، ضمن سياق المنافسة، وتكون الدبلوماسية في خدمتها، وليس تنظيمًا وإدارةً لنظام تعاوني بين الحلفاء. غير أن حلفاء أميركا قلقون من سياسات إدارة ترامب تجاه ملفات عديدة، منها التوتر المتصاعد مع كوريا الشمالية، فضلًا عن تهديد الاتفاق النووي مع إيران، وفي المواقف الضبابية من أزمة الخليج، وعدم وضوح العلاقة مع روسيا، والشكوك في الالتزام المطلق بأمن أوروبا، إضافة إلى العبث بمسيرة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المجمدة ... إلخ.
هذه كلها عوامل تثير شكوكًا لديهم حول موثوقية الحليف الأميركي، وقدرته على القيادة. وإضافة إلى ذلك، تقوم الإستراتيجية على التناقض عند الحديث عن "النظام الدولي"، إذ إنها تجادل بأنه أضرّ بالولايات المتحدة، ولكنها، في الوقت ذاته، تتهم روسيا والصين برفض النظام الدولي القائم ومحاولة تخريبه. وهو ما دفع بعض الناقدين إلى اتهام إدارة ترامب بالانضمام إلى تَيْنِكَ الدولتين، في رفض أسس النظام العالمي القائم حاليًا. وعلى الرغم من أن ترامب فاخر بأن الإستراتيجية الجديدة تمثّل ترجمة لأفكاره، فإن من يقارن الخطاب الذي كشف فيه عن هذه الإستراتيجية، بوثيقة الإستراتيجية نفسها، سيجد بينهما تناقضًا بينًا في عدد من الملفات. وهو ما يوحي أنها عكست توازنات المهنيين المحترفين والسياسيين والأيديولوجيين داخل إدارته. فمثلًا، لا تستخدم الوثيقة تعبير "الإرهاب الأصولي الإسلامي" الذي أورده ترامب في خطابه، بل تستخدم بدلًا منه "الجهاديين الإرهابيين". وفي حين تشير الوثيقة إلى روسيا نحو اثنتي عشرة مرة، وانتقدت تدخلها في شؤون البلدان الأخرى، وتتهمها بمحاولة إضعاف الولايات المتحدة، فإن ترامب لم يشر إلى روسيا إلا مرة، إلى جانب الصين، واصمًا كلتيهما بـ "القوى المنافسة".
باختصار، قد يكون ترامب مؤمنًا بأن الولايات المتحدة تخوض منافسة دولية، ليس مع الخصوم فحسب، بل مع الحلفاء كذلك. وقد يكون مقتنعًا بأن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي ينبغي لها أن تقود وتقرر عالميًّا، غير أن هذا لا يغير من الواقع شيئًا. فحتى الملفات الأهم لإدارة ترامب، وتحديدًا الملف النووي الكوري الشمالي، لا يمكنها حله من دون التعاون مع قوى "منافسة" وعلى رأسها الصين وروسيا. وهنا يكمن الفرق بين الشعارات الانتخابية و"الواقعية السياسية" التي تقول إدارة ترامب إنها تسترشد بها.
نقد مقاربات الإدارات السابقة
تُوجِّه الإستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب نقدًا مبطنًا إلى إدارات أميركية سبقتها، خصوصًا المقاربتين الأمنيتين القوميتين لإدارتَي سلفَيْه جورج بوش الابن وباراك أوباما. وتشمل انتقادات ترامب تركيز إدارات سابقة على "التعاون" مع الحلفاء، وأطراف دولية أخرى، على حساب المصالح الأميركية. ويذكر مثالًا على ذلك توقيع اتفاقيات تجارية دولية جائرة بحق الولايات المتحدة، والاستثمار في بناء دول أجنبية وإهمال البناء في الولايات المتحدة. كما أنه انتقد عدم إصرار الإدارات السابقة على أن يدفع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مخصّصاتهم للحلف كاملة؛ وهو ما سدّد ثمنه دافع الضرائب الأميركي والقوات العسكرية الأميركية. وانتقد كذلك عدم التصدّي لكوريا الشمالية مبكرًا، قبل أن تتحوّل إلى تهديد نووي حقيقي. وغمز من قناة "الصفقة الكارثية" مع إيران، عام 2015، فيما يتعلق ببرنامجها النووي، كما انتقد وضع قيود على إنتاج الطاقة أميركيًّا، وعدم تعزيز الأمن على الحدود الأميركية للحد من موجات الهجرة غير الشرعية. وانطلاقًا من نقده ذاك، أعلن أن إدارته ستعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة.
"التنافس" بين "دول ذات سيادة"
يقوم عماد الإستراتيجية الأمنية القومية الجديدة للولايات المتحدة على افتراض وجود تنافسٍ دوليٍّ على المصالح بين أطراف مختلفة، على أساس أن "السباق نحو القوة ثابتٌ تاريخيٌّ لا يتغير". وترى إدارة ترامب أن هذا التنافس يجب أن يكون بين دولٍ "ذات سيادة"، وأنه
ركائز الإستراتيجية الجديدة
للتصدّي للتحديات السابقة في سياق "التنافس"، فإن الإستراتيجية الجديدة تنطلق من "الواقعية المبدئية"، وتسترشد بالمصالح القومية الأميركية، وتتطلب "دمج كل عناصر القوة القومية والمنافسة بكل وسيلة متاحة لنا". وتحدّد الإستراتيجية أربع ركائز لتحقيق ذلك، هي:
1.حماية الشعب الأميركي ونمط عيشه، ويتم ذلك من خلال:
• تعزيز أمن الحدود الأميركية، بما في ذلك بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، أو "إرهابيين" محتملين، وإعادة النظر في قوانين الهجرة وما فيها من ثغرات.
• الاستمرار في مواجهة "الجهاديين الإرهابيين" وهزيمتهم، هم وأيديولوجيتهم العنيفة، ومنع انتقالها إلى الولايات المتحدة، وانتشارها فيها، خصوصًا عبر الفضاء الإلكتروني.
• تفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للقارات، كعصابات المخدّرات.
• تعزيز الأمن الإلكتروني الأميركي، في ظل الهجمات والقرصنة الإلكترونية المتصاعدة.
• الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية، ومنع وصولها إلى أعداء الولايات المتحدة، وتعزيز الدفاعات الأميركية للتصدّي لأي هجومٍ بأسلحة دمار شامل، بما في ذلك كوريا الشمالية.
2. تعزيز الازدهار الأميركي. بحسب ترامب، تعترف الإستراتيجية الأمنية القومية، لأول مرة، أن "الأمن الاقتصادي هو أمن قومي". ويضيف: "الحيوية الاقتصادية، والنمو، والازدهار الداخلي، هي ضرورات للقوة والتأثير الأميركيين الخارجيين"، ويتحقق ذلك من خلال:
• تحديث البنية التحتية الأميركية كاملة، من طرق وجسور ومطارات واتصالات وممرّات مائية.
• بناء علاقات اقتصادية خارجية عادلة ومتبادلة، ووضع حد للعلاقات التجارية المختلة والمجحفة بحق الولايات المتحدة.
• تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الطاقة، عبر رفع القيود عن استغلال مخزونات الطاقة الأميركية الوفيرة، بما في ذلك، الغاز الطبيعي، والفحم، والبترول، والطاقة المتجددة.
• الريادة في البحث العلمي، والتكنولوجيا، والاختراع.
3. الحفاظ على السلام عبر القوة. يرى ترامب أن "الضعف هو أقصر الطرق لوقوع الصراعات، والقوة التي لا تضاهى هي أنجع الوسائل للدفاع". ولذلك، فإن الإستراتيجية الجديدة تدعو إلى:
• تعزيز القدرات التنافسية الأميركية، في مجال الردع والأسلحة الحديثة، وأسلوب القيادة العسكرية ومقاربة الأخطار.
• تجديد القدرات العسكرية الأميركية، من حيث التسليح والصناعة والعمل الاستخباراتي، وفي مجال الحروب الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز السيطرة الأميركية في مجال الفضاء، ووقف أي اقتطاعاتٍ في الموازنة العسكرية، إذا كانت تؤثر سلبيًّا في ذلك.
• تعزيز القدرات التنافسية الدبلوماسية، وجعل الدبلوماسية الأميركية في خدمة المصالح القومية الأميركية، بما في ذلك المصالح الاقتصادية.
4. تعزيز النفوذ الأميركي في العالم.. يشدّد ترامب، في هذا البند، على أن النفوذ الأميركي على الصعيد العالمي مرتبط بقوة أميركا داخليًّا. كما أنه يشدّد على أن أميركا ستحافظ على تحالفاتها الدولية، شريطة أن يقوم الحلفاء أيضًا بالأدوار المطلوبة منهم، وأن يكون التعاون متبادلًا. وتفيد الوثيقة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن قيمها، من دون محاولة فرضها على أحد، وفي هذا نقد ضمني لفكرة تصدير الديمقراطية، أو التضامن مع قضايا مثل حقوق الإنسان في الخارج.
الشرق الأوسط في الإستراتيجية الجديدة
لم يغب الشرق الأوسط عن الإستراتيجية الأمنية الأميركية الجديدة، غير أن حضوره كان عبر أزماته. فبحسب هذه الإستراتيجية، تهدف الولايات المتحدة إلى أن لا يكون الشرق الأوسط "ملاذًا آمنًا أو أرضًا خصبة للإرهابيين الجهاديين، وأن لا تهيمن عليه أي قوةٍ معاديةٍ للولايات المتحدة، وبأن يبقى مصدرًا لاستقرار سوق الطاقة العالمي". وعلى الرغم من أن الشرق الأوسط كان دائمًا على رأس الأجندة الأمنية القومية للولايات المتحدة، عبر إداراتها المتعاقبة، بما في ذلك إدارتَي بوش وأوباما، فإن إدارة ترامب تُحَمِّلُ، ضمنيًّا، إدارتيهما مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الإقليم والمتعلقة "بالتوسع الإيراني، وتنامي الأيديولوجيا الجهادية، والركود الاجتماعي والاقتصادي، والمنافسات الإقليمية التي هزّت الشرق الأوسط". ووفق تلك المقاربة، فإن إصرار إدارة بوش على إحداث تحول ديمقراطي في الشرق الأوسط، ومحاولة إدارة أوباما فك ارتباطها بهذه المنطقة، لم يحصّنا الولايات المتحدة من مشكلاتها. وعلى الرغم من ذلك، لا تقدّم إستراتيجية إدارة ترامب حلولًا لمشكلات الإقليم على نحو مختلف جوهريًّا عن الإدارات السابقة، بل إنها تغرق في توصيف المشكلات كما يلي:
• تمثّل المنطقة موطن المنظمات الإرهابية الأخطر في العالم، وأهمها "داعش" و"القاعدة"، وقد ساهمت هذه المنظمات في إحداث حالة من اللااستقرار في المنطقة.
• استغلت إيران هذه الحالة، لتوسيع نفوذها في المنطقة من خلال وكلائها وشركائها، وهي تواصل زعزعة استقرار المنطقة وإدامة العنف فيها. هذا فضلًا عن استمرارها في تطوير برنامج صواريخها الباليستية، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية، وشن الهجمات الإلكترونية، على الرغم من توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
• ليس الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي السبب الرئيس في أزمات المنطقة، بل التهديد الإيراني وتهديد التنظيمات الإرهابية (وهذا التحليل مماثل للموقف الرسمي الإسرائيلي).
• يدرك زعماء كثيرون في المنطقة هذه المعطيات، ويعملون مع الولايات المتحدة على مكافحة التطرّف والإرهاب، والتصدّي لجهود إيران التخريبية في المنطقة، وهم يرون في إسرائيل شريكًا في ذلك.
خلاصة
تتمثّل الإستراتيجية المعلنة في ورقةٍ تجمع بين الشعبوية القومية ومواقف اليمين المتشدّد في السياسة الخارجية، بما في ذلك لغة ومفردات تجنبت الإدارات السابقة استخدامها، ومواقف المؤسسة الحاكمة ومحاولاتها كبح نزوات الرئيس. وقد نجحت الإستراتيجية الجديدة، في رأي المدافعين عنها، في التوفيق بين تفادي السقوط في فخ الانعزالية، وعدم الانجرار إلى تحالفاتٍ دوليةٍ لا تكون الولايات المتحدة القائدة فيها، ولا يتقاسم الحلفاء الأعباء كما يفترض بهم. ويذهب هؤلاء إلى أنها تمثّل عودةً إلى نظرةٍ عالمية، توحي بحقبة "القوى العظمى" في القرن التاسع عشر، ضمن سياق المنافسة، وتكون الدبلوماسية في خدمتها، وليس تنظيمًا وإدارةً لنظام تعاوني بين الحلفاء. غير أن حلفاء أميركا قلقون من سياسات إدارة ترامب تجاه ملفات عديدة، منها التوتر المتصاعد مع كوريا الشمالية، فضلًا عن تهديد الاتفاق النووي مع إيران، وفي المواقف الضبابية من أزمة الخليج، وعدم وضوح العلاقة مع روسيا، والشكوك في الالتزام المطلق بأمن أوروبا، إضافة إلى العبث بمسيرة السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المجمدة ... إلخ.
هذه كلها عوامل تثير شكوكًا لديهم حول موثوقية الحليف الأميركي، وقدرته على القيادة. وإضافة إلى ذلك، تقوم الإستراتيجية على التناقض عند الحديث عن "النظام الدولي"، إذ إنها تجادل بأنه أضرّ بالولايات المتحدة، ولكنها، في الوقت ذاته، تتهم روسيا والصين برفض النظام الدولي القائم ومحاولة تخريبه. وهو ما دفع بعض الناقدين إلى اتهام إدارة ترامب بالانضمام إلى تَيْنِكَ الدولتين، في رفض أسس النظام العالمي القائم حاليًا. وعلى الرغم من أن ترامب فاخر بأن الإستراتيجية الجديدة تمثّل ترجمة لأفكاره، فإن من يقارن الخطاب الذي كشف فيه عن هذه الإستراتيجية، بوثيقة الإستراتيجية نفسها، سيجد بينهما تناقضًا بينًا في عدد من الملفات. وهو ما يوحي أنها عكست توازنات المهنيين المحترفين والسياسيين والأيديولوجيين داخل إدارته. فمثلًا، لا تستخدم الوثيقة تعبير "الإرهاب الأصولي الإسلامي" الذي أورده ترامب في خطابه، بل تستخدم بدلًا منه "الجهاديين الإرهابيين". وفي حين تشير الوثيقة إلى روسيا نحو اثنتي عشرة مرة، وانتقدت تدخلها في شؤون البلدان الأخرى، وتتهمها بمحاولة إضعاف الولايات المتحدة، فإن ترامب لم يشر إلى روسيا إلا مرة، إلى جانب الصين، واصمًا كلتيهما بـ "القوى المنافسة".
باختصار، قد يكون ترامب مؤمنًا بأن الولايات المتحدة تخوض منافسة دولية، ليس مع الخصوم فحسب، بل مع الحلفاء كذلك. وقد يكون مقتنعًا بأن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي ينبغي لها أن تقود وتقرر عالميًّا، غير أن هذا لا يغير من الواقع شيئًا. فحتى الملفات الأهم لإدارة ترامب، وتحديدًا الملف النووي الكوري الشمالي، لا يمكنها حله من دون التعاون مع قوى "منافسة" وعلى رأسها الصين وروسيا. وهنا يكمن الفرق بين الشعارات الانتخابية و"الواقعية السياسية" التي تقول إدارة ترامب إنها تسترشد بها.