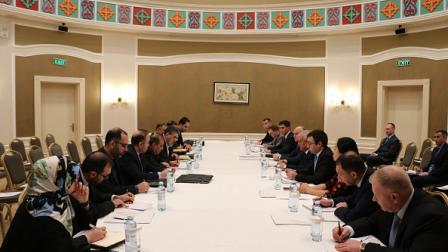تثير أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، ومفارقات الوضع الراهن، في الذكرى الثلاثين لتوقيع اتّفاق أوسلو، تساؤلاتٍ مهمّةٍ بشأن مآل المقاومة الفلسطينية، على ضوء القيود التي فرضها الاتّفاق على منظّمة التحرير الفلسطينية، وتاليًا السلطة الفلسطينية، ورؤية بعض أركانها لأهمّية "التنسيق الأمني" مع إسرائيل، على الرغم من فشل حلّ الدولتين، وتزايد مؤشرات انفجار الوضع الفلسطيني، في هيئة انتفاضةٍ شاملةٍ.
وعلى الرغم من تعهُّد رئيس منظّمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، في خطاب الاعتراف المتبادل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحاق رابين (9/9/1993)، "بحقّ إسرائيل في العيش في سلامٍ وأمانٍ"، و"نبذ الإرهاب"، فقد استمرت ظاهرة المقاومة الفلسطينية، بل تطوّرت تدريجيًّا، رغم قيود أوسلو، التي حصرت الفعل الفلسطيني الرسمي في التفاوض.
وفي المقابل؛ تجلّت بعض نقاط ضعف فصائل المقاومة الفلسطينية، بغياب الاستراتيجية الوطنية الشاملة، خصوصًا إهمال الجوانب المتعلقة بالأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية (أيّ تعزيز البناء الوطني، وبلورة الهويّة الفلسطينية الجامعة، وتنميّة المجتمع الفلسطيني وقدراته، وتعظيم مواطن قوّة الإنسان الفلسطيني)، وذلك مقابل المبالغة في سياسات "العسكرة"، والتنافس الفصائلي و"المحاصصات"، والاكتفاء بخطابات المقاومة دون ممارستها فعليًّا؛ إذ بات الصراع الفصائلي على السلطة، يتفوّق على النضال من أجل السيادة والعدالة، وتحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وعلى الرغم من أخطاء فصائل المقاومة بعد أوسلو، يبقى مهمًّا تفسير أسباب استمرار الانتفاضات والهبّات الشعبية الفلسطينية (والمقاومة بمفهومها الأشمل، التي تتكامل فيها أدواتٌ مختلفةً)، ما يطرح ثلاث ملاحظاتّ؛ أوّلها سوسيولوجيا "الحالة الثورية المتمردة" في فلسطين، المتعلقة في الشعور بالظلم والإذلال، وفقدان الأهل والأحبة، والتي يغذّيها تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، ودخول المستوطنين المتطرفين عنصرًا رديفًا لقوات الاحتلال، على نحوٍ أدّى إلى تشكّل مجموعاتٍ فلسطينيةٍ مقاتلةٍ في أماكن كثيفة السكان (مثل البلدة القديمة في نابلس، ومخيّم بلاطة، ومخيّم جنين)، ما مثّل "حزامًا شعبيّا" لهذه المجموعات، أسهم في تقليل إمكانية اقتحام قوات الاحتلال (أو حتّى أمن السلطة الفلسطينية)، هذه الأماكن، دون التعرّض لإطلاق النار.
ويبدو أنّ تصاعد إرهاصات تآكل القدرات الإسرائيلية في ردع المقاومة الفلسطينية، ناهيك عن ردع حزب الله اللبناني وإيران، وتفاقم "هشاشة" الوضع الداخلي، في ظلّ سياسات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه أزمة "التعديلات القضائية"، كلّها عوامل تفسّر تريث إسرائيل في توسيع حروبها، خشية أن تسفر أخطاء الحسابات في "المعارك الصغيرة"، إلى نشوب "حربٍ إقليميةٍ كبرى".
بيد أنّ الأهمّ هو نجاح جيل الشباب في تجديد أشكال المقاومة الفلسطينية، سيّما بعد حدثيْن دولييْن؛ أحدهما اشتداد الضغوط الأميركية على الطرف الفلسطيني، خصوصًا بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب (6/12/2017) الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، (ثم إعلانه صفقة القرن (28/1/2020)، ما أدّى إلى إطلاق مرحلةٍ "نوعيةٍ" من المقاومة الشعبية بأساليب مبتكرةٍ، (معركة "بوابات الحرم القدسي"، و"مسيرات العودة" على حدود قطاع غزّة، وأنماط مقاومة حي الشيخ جرّاح وقرية بيتا.. إلخ).
والآخر التداعيات الدولية والإقليمية للأزمة الأوكرانية (2022-2023)، التي استأثرت باهتمام واشنطن والعواصم الغربية، ومحاولة إسرائيل توظيفها بإطلاق حملة "كاسر الأمواج" في الضفّة الغربية، وفشل حكومة نفتالي بينت، في استعادة "الردع الإسرائيلي"؛ إذ أدّى تصاعد سياسات الاحتلال في شنّ العمليات العسكرية والاقتحامات، واغتيال المقاومين، إلى توسّع جيوب المقاومة (من جنين، إلى نابلس، وصولًا إلى بلدة بيت أمر شمال الخليل)، وبروز ظاهرة "الفدائيين الجدد"، وظهور مجموعاتٍ مسلّحةً عديدة ("كتيبة جنين"، و"مجموعات جبع"، و"مجموعات برقين"، و"مجموعات قباطية"، و"عرين الأسود" في نابلس، و"كتيبة بلاطة" في مخيم بلاطة).
ثمة فرصةً سانحةً لإعادة تشكيل "نموذجٍ انتفاضيٍّ" فلسطينيٍّ، يعمل على تصعيد المقاومة الفلسطينيّة، وتجديد أدواتها وأساليبها
وتكمن المفارقة هنا في أنّ تسارع معدلات التطبيع العربي والإقليمي مع إسرائيل، قد يحفّز الشباب على بلورة العامل الذاتي التحرري الفلسطيني لرفع سوية المقاومة، وتحسين أدائها في مواجهة بيئةٍ عربيةٍ وإقليميةٍ غير مساندة للمقاومة.
تتعلق الملاحظة الثانية بفشل الدعاية الإسرائيلية، رغم جهودها الحثيثة على مدار عقود طويلةٍ، في "تسميم" الثقافة السياسية الفلسطينية، عبر تقديم قيم التنمية الاقتصادية والازدهار، وتأخير قيم المقاومة واستعادة الحقوق، والحفاظ على الثوابت الوطنية.
وعلى الرغم من استهداف المجتمع الفلسطيني؛ خصوصًا جيل الشباب، في إطار أوسلو، بـ "ثقافة السلام والتطبيع"، وشيوع خطابٍ "نيوليبرالي" يعجّ بمصطلحات الفردانية والريادة، وعالم الطبقة الوسطى، لم تتمكّن إسرائيل من محو "ثقافة المقاومة والانتفاض"، بل تولّدت في مخيّمات الضفّة الغربية "حاضنةٌ شعبيةٌ"، تدعم التشكيلات المسلّحة الفلسطينية، سيّما مع انعدام أيّةٍ آفاق للتهدئة، وتضاؤل احتمال نجاح عملية التسوية والمفاوضات، ما أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وأدّى إلى نزع مبرراتها لإنهاء المقاومة المسلّحة، في ظلّ تغوّل قوّات الاحتلال والمستوطنين.
تتعلق الملاحظة الأخيرة بالتحدّيات أمام المقاومة الفلسطينية، وإحياء المشروع الوطني الفلسطيني إجمالًا؛ أوّلها عدم الانجرار إلى صراعٍ داخليٍ مع السلطة الفلسطينية، على نحوٍ يضعف المقاومة، ويبعدها عن مهمة استنزاف الاحتلال.
وثانيها ضمان استمرار المقاومة، وسلامة مسارها، لتطوير عملية نضالٍ طويل الأمد، استنادًا إلى مواطن قوّة الشعب الفلسطيني، وأهمّها استمراره على أرضه، ودخول جيل الشباب إلى ميدان الصراع مع إسرائيل. وثالثها تجديد أشكال المقاومة وأساليبها، بما يضمن تقويّة المجتمع الفلسطيني، وقواه السياسية، وليس إضعافه أو استنزافه، بالتزامن مع تعزيز تناقضات المجتمع الإسرائيلي، وليس دفعه نحو التكتل خلف حكومته أو جيشه، ما يؤدي إلى تحييد الآلة العسكرية الإسرائيلية قدر المستطاع.
يبقى القول ثمة فرصةً سانحةً لإعادة تشكيل "نموذجٍ انتفاضيٍّ" فلسطينيٍّ، يعمل على تصعيد المقاومة الفلسطينيّة، وتجديد أدواتها وأساليبها، ولا سيّما مع دخول جيلٍ جديدٍ من الشباب الفلسطيني والعربي، إلى حلبة الصراع مع إسرائيل.