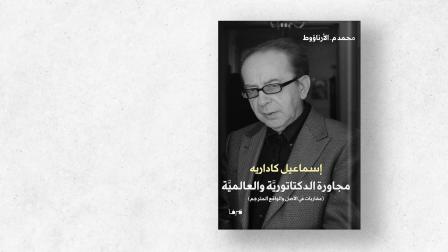خلال أيام الدورة الحادية والسبعين لـ "مهرجان أفينيون المسرحي" في فرنسا الذي اختتم أمس، لفت الأنظار عرض "سوبرو" للمخرج البرتغالي تياغو رودريغيس على المستويين الجماهيري والنقدي.
العمل الذي يُعرض للمرة الأولى في أفينيون، يطلّ على حياة إحدى العاملات في مهنة التلقين؛ مهنة في طريقها إلى الانقراض، حيث لم يبق في البرتغال، بحسب ما ذكر المخرج في المؤتمر الصحفي للعرض، سوى اثنين يمارسان هذه المهنة في يومنا الحالي.
في "المسرح الوطني" في لشبونة، التقى المخرج لأول مرة بالملقنة كريستينا فيدال سنة 2010، وهي التي ستصبح لاحقاً بطلة وموضوعة مسرحيته. في تلك الزيارة، تعرّف رودريغيس على مهنة الملقن عن قرب، واتفق مع فيدال على العمل سوياً من أجل عرض مسرحي، إلا أن الظروف، المالية تارة والإدارية تارة أخرى، حالت دون إنتاج العرض. هكذا حتى استلامه إدارة "المسرح الوطني" نهاية 2014 حيث عاد واستكمل مشروعه مع شريكته ليصلا إلى العمل المسرحي الذي عُرض على مدار تسعة أيام متواصلة في أفينيون ووُصف بأنه إحدى علامات دورة هذا العام.
ليست حكاية لقاء فيدال مع المخرج البرتغالي ثانوية أو هامشية عند الحديث عن "سوبرو" لأسباب عديدة أهمها أن مركزيتها في العمل المسرحي تتطابق إلى حد كبير مع علاقة الأخيرة مع الفن الرابع. فهي التي جاءت إلى المسرح في صغرها لأن عمّتها تعمل فيه، وبدأت علاقتها مع تلك "الحفرة الصغيرة" إلى اللحظة التي قرّر فيها رودريغيس إخراجها من الكواليس إلى الخشبة لتكون وجهاً لوجه أمام الجمهور بعد ربع قرن قضته في تلقين الممثلين حواراتهم من حفرتها المخصّصة لها في الظلام (الكمبوشة). وفِي ذات السياق شكلت محاولات المخرج إقناع الملقنة بالخروج للضوء حدثاً أساسياً في بنية العمل الدرامي.
هكذا، ستشكل علاقة الشخصيات مع المكان محور العرض المسرحي، وهو ما اشتغل عليه في سينوغرافيا العرض، فمنذ اللحظة الأولى نحن أمام خشبة تشكلها الألواح الخشبية المتراصة، خشبة مسرح موحشة تشبه الأطلال، تبرز منها بعض النباتات البرية، مكان يشبه إلى حد كبير دواخل تلك الشخصية التي اعتادت البقاء في الظل. ما يقدَّم على الخشبة هو من وجهة نظر الملقنة، وهذا ما اشتغل عليه المخرج في رسم حركة الممثلين على الخشبة، فظهور الممثلين دائماً كان باتجاه كريستينا، كذلك تندر مشاهِد المواجهة المباشرة أو التقابل بينها وبينهم، ولا تلتقي عيناها بعيونهم أيضاً.
ضمن العلاقة مع المكان نلحظ أيضاً ثلاثة مستويات تتماهى مع مستويات الحكاية المراد تقديمها: الأول مستوى الملقنة مع حفرتها، والثاني تشكله علاقتها مع "المسرح الوطني" في لشبونة، والثالث واقعي -درامي تنسجه علاقتها مع أمكنة المشاهد التي كان يؤديها الممثلون على الخشبة أثناء العرض.
من ضمن المستويات الثلاثة تطلّ شخصية ترتدي الأسود، تحمل نصها المكتوب والمغلف باللون الأسود، وتمشي بخفة وكأنها لا تؤدي حركة مدروسة (نجدها على الخشبة حتى أثناء دخول المتفرجين إلى الصالة)، ملامحها تكاد أن تكون غائبة، تتحدّث بصوت خفيض جداً.
استطاع العمل أن يروي عبر مستويات حكاياته جزءاً كبيراً من تاريخ "المسرح الوطني" في لشبونة عبر مشاهد أدّاها الممثلون وكريستينا فيدال تلقنهم أدوارهم على الخشبة أمامنا. هذا أيضاً جزء من ذاكرة الملقنة التي قضت عمرها في هذا المسرح.
على سبيل المثال، نسمع قصة تلك الخادمة التي حفظت حوارات مسرحية "روميو وجولييت" لأنها وقعت في عشق أحد ممثلي المسرح، وقصة مديرة المسرح المخلصة للمسرح… إلخ. التاريخ يُروى هنا على لسان واحدة من أكثر الشخصيات هامشية في هذه المؤسسة، ليس على لسان أحد المخرجين الكبار الذي يأتي ليقدم مشروعه أو عمله ويمضي، ويذكره الجميع دون أن يُذكر أحد من هؤلاء الذين عملوا في الظل.
حاول تياغو رودريغيس، كعادته، أن يكون متقشفاً في عرضه، فلا محاولة منه لتقديم إبهار بصري ولا جماليات الإضاءة (كثيراً ما استخدم ضوء النيون الأبيض)، كل ما سبق يندرج في إطار فلسفته الإخراجية بشكل عام وفي هذا العرض بشكل خاص وكأنه يحاول أن يقدم الملقنة فيدال بمفردات مكانها أي الكواليس التي مكثت فيها طويلاً. المؤثر الصوتي الوحيد كان صوت الأنفاس والرياح التي تعصف منذ لحظة بداية العرض، وكأنها الأنفاس التي تعطيها الملقنة لخشبة المسرح وللممثلين وللأدوار التي يلعبونها، فهي بذلك تشكل ذاكرة الكواليس و"المسرح الوطني" وذاكرة الممثلين على الخشبة. وفي السياق السابق يجدر الذكر بأن كلمة ملقن لها نفس الجذر اللاتيني لكلمة نفس، حتى كلمة الملقن في اللغة الفرنسية والبرتغالية مثلاً مأخوذة من النفس أو النفخة.
يصر رودريغيس من خلال خياراته الإخراجية وكذلك في مؤتمره الصحفي عقب العرض على أن كريستينا فيدال ليست ممثلة، وعلى أنه عمل جهده أن يوجّهها كمخرج بالحد الأدنى. هذا ما ينسجم انسجاماً كبيراً مع ما حاول العرض قوله عن طريق هذه الشخصية التي أخرجها رودريغيس من الكواليس، فكان وجودها وحكايتها مركز عرض يتجاوز ساعة و45 دقيقة، هذا على الرغم من تقديم الممثلين لمشاهد شديدة الإتقان من أعمال سوفوكليس وتشيخوف وشكسبير وراسين. كأن الأبطال غير المعروفين يتواجدون في جميع الأمكنة وفي أشدها ظلمة، وما المسرح إلا منبر أصيل لهم ولحكاياتهم.