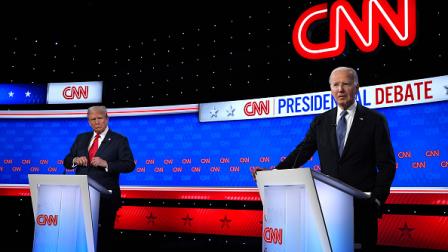الصدمة المكسيكية مثلما ترجمتها الصحف (يوري كورتيز/فرانس برس)
منطقياً، وبعدما حصل ما حصل في انتخابات الرئاسة الأميركية، يُفترض أن يزدهر "سوق" الدراسات الأنثروبولوجية وأبحاث علم الاجتماع السياسي في الولايات المتحدة خصوصاً، وفي العالم عموماً، لسنوات عديدة مقبلة، لعلّ العالم يفهم يوماً ما، كيف صوّت الناخب الأميركي عام 2016 ولماذا. لكن مهما حصل، سيكون صعباً فهم كيف أن الريف، في عام 2016 تحديداً، يغلب المدينة. كيف يمكن لخطاب الانعزال واللون الواحد والعرق الواحد، في عز عصر العولمة، أن يفوز على التعددية وعلى بقية الألوان في بلد المهاجرين تعريفاً.
سيكون صعباً للغاية، استيعاب أن آخر كاوبوي في آخر قرية من ريف تينيسي أو ميسيسيبي أو بنسلفانيا مثلاً، أطاح بإرادة الحزبين، اللوبيات والإعلام، وول ستريت، وبإنجازات باراك أوباما، الرافعة الرئيسية منطقياً لحملة هيلاري كلينتون التي طرحت نفسها كامتداد للرئيس رقم 44. كيف أنه في غضون ثماني سنوات فقط، يقرر المزاج الأميركي العام، انتخاب رئيس أسود، شاب، محامٍ، من جذور أفريقية وربما مسلمة وماركسية (ثلاثية الشر بالنسبة للريفي الأبيض الانعزالي المُسمَّى angry white man)، ينجز مشاريع اجتماعية تحررية تقدمية، ويحقق أرقاماً اقتصادية مهمة جداً، ويخفف الضرائب عن محدودي الدخل (ومن بينهم بشكل رئيسي أهل الريف والعمال، أي جمهور دونالد ترامب أساساً)، ويحدّ جدياً من التفاوت الطبقي في المجتمع الأميركي، ويقلل بشكل هائل عدد نعوش الجنود الأميركيين العائدين من مغامرات الحروب في الخارج... ثم يعود ليعاقب الرجل نفسه، رغم أنه لا يزال حاصلاً على تأييد 54 في المئة من الأميركيين، أي تقريباً حافظ على نسبة التأييد التي أتت به رئيساً. لن يكون سهلاً الاقتناع بكيف يمكن أن يصوّت الملايين من الأميركيين السود واللاتينيين والمسلمين (مع أن الفئة الأخيرة هامشية ولا تشكل أكثر من 3 في المئة من نسبة الأميركيين) لمصلحة رجل يتوعدهم بالإقصاء والطرد والمعاملة الدونية التي تدنو من تعاطي النازية مع اليهود.
كيف حصل أن نال ترامب 29 في المئة من أصوات اللاتينيين وهو الذي يحتقرهم علناً؟ كيف يمكن لدولة جارة مثل كندا، أن تأتي بليبرالي مثل جاستن ترودو، بينما أميركا تنتخب أسوأ ما في أميركا كدونالد ترامب؟ بعد كل هذه الأسئلة، لا أهمية كبيرة للثرثرة حول أخطاء هيلاري وسأم الأميركيين من الاستابلشمنت، لأن البديل المطروح من ترامب، ليس نظاماً جديداً، بل مجرد فوضى، مجرد غوغاء.