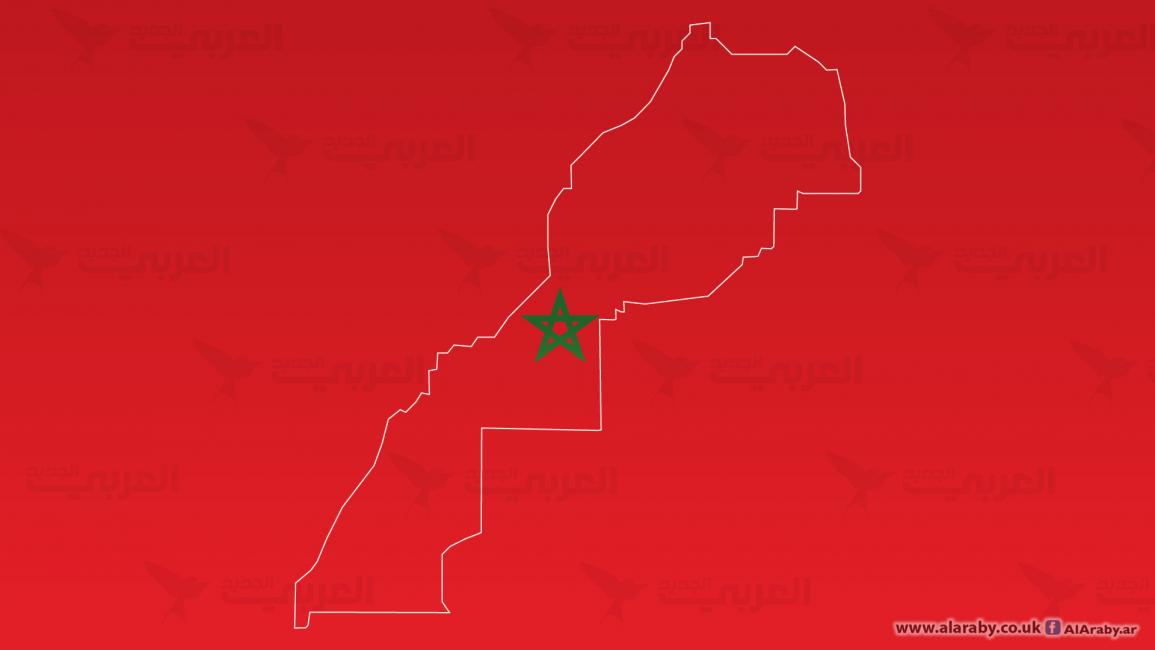08 نوفمبر 2024
السلطة والنخب والطبقة الوسطى في المغرب
تؤكد وقائع السياسة المغربية خلال السنة التي انقضت جدليةَ الثابت والمتحول التي تحكم هذه السياسة، وتكرس بنيتها المغلقة، على الرغم من وجود بعض مظاهر اللَّبرلة التي تنخرط، بشكلٍ لا يخلو من مفارقة، في صيانة هذه البنية، والحيلولة دون تحديثها بشكلٍ يخلخل التوازنات الاجتماعية والسياسية القائمة.
أثبت عُسْر تشكيل الحكومة (البلوكاج) وما ترتب عنه أن هياكل هذه السياسة لا تشتغل وفق منظور تراكمي، يحمي المكتسبات الديمقراطية، ويُوسِّع تدريجياً هوامش الحريات والحقوق، ويزيد من منسوب الانفتاح داخل المؤسسات، ويبحث، بالتالي، عن آفاقٍ لترسيخ الخيار الديمقراطي، وجعله مرجعيةً تستضيء بها الدولة والنخب والمجتمع. يتعلق الأمر بمشهدٍ تحكمه استراتيجية سلطوية بنيوية، يتم تصريفها عبر تكتيكاتٍ تستجد من حين إلى آخر، حسب ميزان القوى الداخلي، والظرفين، الإقليمي والدولي.
ضمن هذا السياق، تبدو آلية التنخيب مدخلاً مناسباً لمساءلة بعض إشكالات الاجتماع السياسي المغربي المعاصر. فقد دأبت السلطة، منذ عقود، على تنخيب قطاعات من الطبقة الوسطى، ضمن استراتيجيتها للتحكم في الصراع الاجتماعي. ومن ثمّة، شكلت النخب الوزارية والبرلمانية والمحلية والإدارية حزاماً مؤسساتياً، لعب أدواره في تصريف جزءٍ من فائض الاحتقان الاجتماعي والسياسي؛ معادلة استفادت بموجبها هذه النخب من الريع السياسي (أجور مرتفعة، تعويضات، امتيازات لا حصر لها..) مقابل إسهامها في إحداث نوعٍ من الاستقرار الاجتماعي والأهلي، من خلال الحيلولة دون وقوع احتكاكٍ مباشر بين السلطة والشارع، واجتراح حلولٍ لما يستجد من مشكلاتٍ وأزمات، وفق ثقافةٍ سياسيةٍ تقليديةٍ تُشكل المحاباة والريع والتقرّب إلى دوائر السلطة عصبها الأساسي.
يقودنا هذا إلى تساؤلاتٍ على قدر كبير من الدلالة؛ لِم لَم تعتمد السلطة على الطبقة الوسطى في إحداث هذا الاستقرار؟ لِم لم تعمل على تعميق خياراتها الليبرالية المحدودة بفتح المجال أمام المشاركة الواسعة لهذه الطبقة، في تسيير الشأن العام، والمساهمة في تحديث السياسة المغربية؟ ألا تقع الانهياراتُ المتوالية في قطاع التعليم في قلب هذا النقاش، في ضوء إقصاء هذه الطبقة من معادلة الثروة والسلطة، والاستعاضة عنها بنخبٍ انتهازيةٍ، أثبتت الأحداث أنها غير قادرة على حماية السلطة من ارتدادات المجتمع القوية؟
سبق للباحث والمؤرخ الفرنسي، بْيير فيرمورين، أن استدعى بعض هذه التساؤلات في دراسة مقارنَة له حول ''المدرسة والنخبة والسلطة في المغرب وتونس''، واستنتج أنه في الوقت الذي اتجهت فيه تونس إلى الاستثمار في الطبقة الوسطى، وتعزيز مواقعها داخل المجتمع من خلال مورد التعليم، اتجه المغرب إلى الاستثمار السياسي في النخب، في مقابل التلكؤ في بناء منظومة تعليمية ناجعة. لما لذلك، بالطبع، من كلفةٍ سياسية على المدى البعيد.
يفرز التعليم الجيد، مع تعاقب الأجيال، مجتمعاً متعلماً تشكل الطبقة الوسطى عموده الفقري. وقد كان لخيار المراهنة على النخب كُلفتُهُ الاجتماعية الباهظة التي تتجاوز أزمة المنظومة التعليمية إلى ما لا حصر له من مظاهر الفشل الاجتماعي والثقافي والسياسي. هذا في وقتٍ استطاعت فيه الطبقة الوسطى في تونس أن تشكل أحد المداخل الأساسية في النجاح النسبي للمسار الانتقالي في هذا البلد العربي، من خلال فاعليتها وحيويتها داخل المجتمع المدني.
استطاعت معادلة السلطة والنخب في المغرب أن تنتج سرديتها السياسية التي زكّتها الأحزاب والنقابات، وقطاع من المجتمع المدني، وبعض فئات الطبقة الوسطى منذ بداية التسعينات. انتظمت هذه السردية حول ''الخيار الديمقراطي'' الذي يعني التوسيعَ المتحكّم فيه للحريات، والإصلاحَ المتدرج المرتبط بالاستقرار، ومعالجةَ قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السلطة، بما يطرحه ذلك، بطبيعة الحال، من أسئلةٍ بشأن طبيعة السياسات العمومية في المغرب.
وما كان لهذه السردية أن تفرز امتداداتها داخل المجتمع، من دون النقلة النوعية التي حدثت على مستوى إدماج عائلات حزبية وسياسية ومدنية جديدة في بنيات السلطة وهياكلها (أحزاب الحركة الوطنية، الإسلام السياسي المعتدل، نخب المجتمع المدني..). وبقدر ما كانت دائرة هذه السردية تتسع، بقدر ما كان الواقع يسجل تراجع مؤسسات الوساطة في القيام بأدوارها الاجتماعية والسياسية بسبب انفصامها عن الواقع، وعزوف معظم شرائح الطبقة الوسطى عن المشاركة في تجديد دماء هذه المعادلة، بسبب تردّي أحوالها المعيشية وتراجع فعالية المورد التعليمي والثقافي في عملية الترقي الاجتماعي.
بالموازاة مع ذلك، كانت هناك مياه تجري بهدوء تحت جسور الاجتماع والسياسة؛ إذ ظهر جيل جديد من الحركات الاحتجاجية لم يمر عبر الأحزاب والنقابات التي انتهت صلاحيتها، ولم يعد يعنيها شيء غير استحقاقات موسمية، تشكل فرصةً بالنسبة لها، لتجديد صلاتها بقنوات الريع الانتخابي والسياسي. جيلٌ من الاحتجاجات التي لا تكترث لوعود الحكومة والبرلمان والنخب المحلية، ولا تعنيها بلاغاتٌ خشبيةٌ لا علاقة لها بالواقع.
استطاعت هذه الاحتجاجات أن تربك هذه المعادلة، وتكشف أمام الرأي العام خواء النخب ونفاقها، وعجزها البنيوي عن الإسهام، ولو قليلاً، في إدارة التوترات الاجتماعية والسياسية والتخفيف من حدّتها. ولعل الحراك الشعبي في الحسيمة وجرادة، وتوالي الإعفاءات الملكية وزراء ومسؤولين كباراً، يؤشر ذلك كله على تَحوُّلٍ دالٍّ في أدوار الوساطة ومآلاتها.
انهيارُ آليات الوساطة، بهذا الشكل الذي بات يُقلق السلطة، يقتضي التفكير جدياً في اجتراح بدائل للحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وأبرزها إعادة الاعتبار إلى الطبقة الوسطى، وتجاوز النظر إليها بعين الريبة، باعتبارها مصدر خوفٍ وإزعاج، ولعل ذلك لا يتأتى إلا بإعادة الاعتبار لأهم مواردها (التعليم)، والتوقف عن الإجهاز على مكاسبها.
أثبت عُسْر تشكيل الحكومة (البلوكاج) وما ترتب عنه أن هياكل هذه السياسة لا تشتغل وفق منظور تراكمي، يحمي المكتسبات الديمقراطية، ويُوسِّع تدريجياً هوامش الحريات والحقوق، ويزيد من منسوب الانفتاح داخل المؤسسات، ويبحث، بالتالي، عن آفاقٍ لترسيخ الخيار الديمقراطي، وجعله مرجعيةً تستضيء بها الدولة والنخب والمجتمع. يتعلق الأمر بمشهدٍ تحكمه استراتيجية سلطوية بنيوية، يتم تصريفها عبر تكتيكاتٍ تستجد من حين إلى آخر، حسب ميزان القوى الداخلي، والظرفين، الإقليمي والدولي.
ضمن هذا السياق، تبدو آلية التنخيب مدخلاً مناسباً لمساءلة بعض إشكالات الاجتماع السياسي المغربي المعاصر. فقد دأبت السلطة، منذ عقود، على تنخيب قطاعات من الطبقة الوسطى، ضمن استراتيجيتها للتحكم في الصراع الاجتماعي. ومن ثمّة، شكلت النخب الوزارية والبرلمانية والمحلية والإدارية حزاماً مؤسساتياً، لعب أدواره في تصريف جزءٍ من فائض الاحتقان الاجتماعي والسياسي؛ معادلة استفادت بموجبها هذه النخب من الريع السياسي (أجور مرتفعة، تعويضات، امتيازات لا حصر لها..) مقابل إسهامها في إحداث نوعٍ من الاستقرار الاجتماعي والأهلي، من خلال الحيلولة دون وقوع احتكاكٍ مباشر بين السلطة والشارع، واجتراح حلولٍ لما يستجد من مشكلاتٍ وأزمات، وفق ثقافةٍ سياسيةٍ تقليديةٍ تُشكل المحاباة والريع والتقرّب إلى دوائر السلطة عصبها الأساسي.
يقودنا هذا إلى تساؤلاتٍ على قدر كبير من الدلالة؛ لِم لَم تعتمد السلطة على الطبقة الوسطى في إحداث هذا الاستقرار؟ لِم لم تعمل على تعميق خياراتها الليبرالية المحدودة بفتح المجال أمام المشاركة الواسعة لهذه الطبقة، في تسيير الشأن العام، والمساهمة في تحديث السياسة المغربية؟ ألا تقع الانهياراتُ المتوالية في قطاع التعليم في قلب هذا النقاش، في ضوء إقصاء هذه الطبقة من معادلة الثروة والسلطة، والاستعاضة عنها بنخبٍ انتهازيةٍ، أثبتت الأحداث أنها غير قادرة على حماية السلطة من ارتدادات المجتمع القوية؟
سبق للباحث والمؤرخ الفرنسي، بْيير فيرمورين، أن استدعى بعض هذه التساؤلات في دراسة مقارنَة له حول ''المدرسة والنخبة والسلطة في المغرب وتونس''، واستنتج أنه في الوقت الذي اتجهت فيه تونس إلى الاستثمار في الطبقة الوسطى، وتعزيز مواقعها داخل المجتمع من خلال مورد التعليم، اتجه المغرب إلى الاستثمار السياسي في النخب، في مقابل التلكؤ في بناء منظومة تعليمية ناجعة. لما لذلك، بالطبع، من كلفةٍ سياسية على المدى البعيد.
يفرز التعليم الجيد، مع تعاقب الأجيال، مجتمعاً متعلماً تشكل الطبقة الوسطى عموده الفقري. وقد كان لخيار المراهنة على النخب كُلفتُهُ الاجتماعية الباهظة التي تتجاوز أزمة المنظومة التعليمية إلى ما لا حصر له من مظاهر الفشل الاجتماعي والثقافي والسياسي. هذا في وقتٍ استطاعت فيه الطبقة الوسطى في تونس أن تشكل أحد المداخل الأساسية في النجاح النسبي للمسار الانتقالي في هذا البلد العربي، من خلال فاعليتها وحيويتها داخل المجتمع المدني.
استطاعت معادلة السلطة والنخب في المغرب أن تنتج سرديتها السياسية التي زكّتها الأحزاب والنقابات، وقطاع من المجتمع المدني، وبعض فئات الطبقة الوسطى منذ بداية التسعينات. انتظمت هذه السردية حول ''الخيار الديمقراطي'' الذي يعني التوسيعَ المتحكّم فيه للحريات، والإصلاحَ المتدرج المرتبط بالاستقرار، ومعالجةَ قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السلطة، بما يطرحه ذلك، بطبيعة الحال، من أسئلةٍ بشأن طبيعة السياسات العمومية في المغرب.
وما كان لهذه السردية أن تفرز امتداداتها داخل المجتمع، من دون النقلة النوعية التي حدثت على مستوى إدماج عائلات حزبية وسياسية ومدنية جديدة في بنيات السلطة وهياكلها (أحزاب الحركة الوطنية، الإسلام السياسي المعتدل، نخب المجتمع المدني..). وبقدر ما كانت دائرة هذه السردية تتسع، بقدر ما كان الواقع يسجل تراجع مؤسسات الوساطة في القيام بأدوارها الاجتماعية والسياسية بسبب انفصامها عن الواقع، وعزوف معظم شرائح الطبقة الوسطى عن المشاركة في تجديد دماء هذه المعادلة، بسبب تردّي أحوالها المعيشية وتراجع فعالية المورد التعليمي والثقافي في عملية الترقي الاجتماعي.
بالموازاة مع ذلك، كانت هناك مياه تجري بهدوء تحت جسور الاجتماع والسياسة؛ إذ ظهر جيل جديد من الحركات الاحتجاجية لم يمر عبر الأحزاب والنقابات التي انتهت صلاحيتها، ولم يعد يعنيها شيء غير استحقاقات موسمية، تشكل فرصةً بالنسبة لها، لتجديد صلاتها بقنوات الريع الانتخابي والسياسي. جيلٌ من الاحتجاجات التي لا تكترث لوعود الحكومة والبرلمان والنخب المحلية، ولا تعنيها بلاغاتٌ خشبيةٌ لا علاقة لها بالواقع.
استطاعت هذه الاحتجاجات أن تربك هذه المعادلة، وتكشف أمام الرأي العام خواء النخب ونفاقها، وعجزها البنيوي عن الإسهام، ولو قليلاً، في إدارة التوترات الاجتماعية والسياسية والتخفيف من حدّتها. ولعل الحراك الشعبي في الحسيمة وجرادة، وتوالي الإعفاءات الملكية وزراء ومسؤولين كباراً، يؤشر ذلك كله على تَحوُّلٍ دالٍّ في أدوار الوساطة ومآلاتها.
انهيارُ آليات الوساطة، بهذا الشكل الذي بات يُقلق السلطة، يقتضي التفكير جدياً في اجتراح بدائل للحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي، وأبرزها إعادة الاعتبار إلى الطبقة الوسطى، وتجاوز النظر إليها بعين الريبة، باعتبارها مصدر خوفٍ وإزعاج، ولعل ذلك لا يتأتى إلا بإعادة الاعتبار لأهم مواردها (التعليم)، والتوقف عن الإجهاز على مكاسبها.