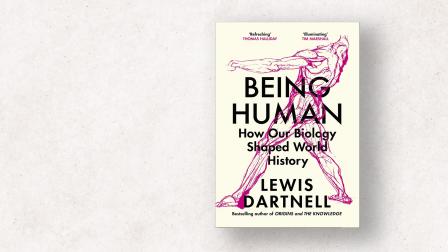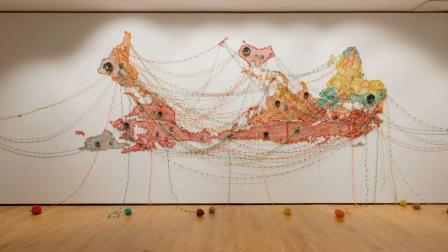أقف وسط الغرفة، أشعلُ شمعةً لذكرى ميلادي ثم أُوقفها على طرف صحنٍ مدوّر. أشعل شمعة ثانية لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، فأبقيها في يدي، بنشيجها الصامت، وأبدأ حفلتي بحضور تسعةٍ وعشرين ظِلّاً، ظِلال الشهداء التي لا تنطفئ.
اليوم تتساوى أعمارنا، "أوسلو"، وأنا، ومجزرة الحرم التي تعود بي 26 عاماً، من خلال شفاه أمي التي تقُصّها عليَّ مع كُلّ ذكرى، أسمع البداية ومن ثَمّ يتلاشى صوتها وتبقى حركة الشفاه وتعابير الوجه بالتقلّب، ثُم تبهت الصورة شيئاً فشيئاً، لأصبح ظلاً يتحرّك في الماضي، ورضيعاً يبكي في المشهد.
تبدأ هي القصّةَ من الانهيار الصحّي فجر ذاك اليوم، وأحضرُ كطيفٍ أُشاهدها تودّع أطفالها الخمسة، أكبرهم 12 عاماً، وأصغرهم أنا، بالكاد أبلغ شهراً من عمري، وكطيفٍ شاهدت مركبة الإسعاف تقلّها برفقة أبي، وضوء لوّاحة المركبة الأحمر الذي اقتحم الغرفة من النوافذ ينسحب مسرعاً نحو "مستشفى المقاصد" في القدس.
شاهدتُ القلق والحزن واللهفة داخل المركبة، وكطيفٍ، جلست وحيداً على باب غرفة الإنعاش من الخارج، وكاد قلبي ينخلع خوفاً حين انفجر صخبٌ لسيلٍ من الناس يحملون أشخاصاً يقطرون دماً، يتدفّقون في الممر، وخشيت أن أُهرَس تحت الأقدام لولا تذكُّري أنّي طيف. حينها ربت ظِلٌ على كتفي وهمس في أُذني: أترى ذاك المصاب المخضب بالدماء في غرفة العناية؟ ذاك أنا، وسيُعلَن عن استشهادي بعد قليل، وضجّ المستشفى ثانية بالصراخ: "شهيد ثان.. شهيد ثان"، وعلمت منه أنّ الطُرق قد أُغلقت وأنّ مجزرةً في مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل قد أودت بتسعة وعشرين مصلّياً، نفّذها صهيوني - لا يهمّ اسمه - ولكني خلته السفاح النيوزيلندي، لولا تذكّر أني طيفٌ يسير في ماضٍ أبعد.
يطلّ طيف الشاعر أمل دنقل يلقي مقطعاً من "بكائية ليلية": "تسقط في ظلال الضّفّة الأخرى، وترجو كفنا!/ وحين يأتي الصبح - في المذياع - بالبشائر/ أزيح عن نافذتي السّتائر/ فلا أراك!/ أسقط في عاري. بلا حراك/ أسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى؟/ أم أنّها هناك؟"، ويختفي في آخر الممر.
خلال الأيام الخمسة في المستشفى، تسلّلتُ إلى غرفة أمي وشهدتُها تقبض على يد أبي، وتبكي الحُرقةَ على رضيعها البعيد، وتلعن "الحواجز" التي تمنع والدتها من الوقوف بجوارها، يقف بجانبي ظلُّ أحد أولئك المخضّبين، ويلعن الحواجز ذاتها التي منعت أهله من الوصول إلى جسده في اللحظة الحساسة. أعود من شرودي في نهاية القصة وقد جرح خنجر التفاصيل صوتَها، وحزّ قلبي.
كبرنا والذكرى سويّاً، وكبرت شجرة الحلم والأمل، وفي يافا، عاش طيفي حياةً سرَدَها جدّي قبل أن يموت، وأخرى نقلها عنه أبي، وكلّما عدتُ من يافا الحُلم بصقتُ في وجه أوسلو التي تهزأ بعودتي. كبرتُ وكبُرَت أوسلو، وظلال الماضي في يافا تضحك حين أقصّ عليها كطيفٍ، أنّ ابن يافا في 2020 لا يملك أرضاً يزرعها برتقالاً ولا بحراً يصيد فيه السمك، يعيش اللجوء من وظيفةٍ لأخرى ومن وهم استقرار إلى آخر، يحمل الهَمّ وقهر الفساد كيساً على كتفه ويسير كطيفٍ وراء جدّه الأوّل في اللجوء لعلّه يوقفه فنرجع، أو نهلك بشرف.
اليوم، ورغم كل الأسى، تبتسم الظلال من حولنا، مع كلّ طفل يُولد في غزّة حين تغضب، أو في القدس حين تُفتح أبوابها عُنوةً بيد أهلها، أو مع كل طفلٍ في الضفّة أو أُم الفحم يبصر فلسطين بلا حدود. اليوم فقط تصطف كُلّ الظلال التي استشهد أصحابها قبل 26 عاماً في مجزرة الحرم الإبراهيمي، خلف روّاد "الفجر العظيم" يُنبئون بفجرٍ عظيم رغم كلّ "صفقة" و"اتفاقية".
* وقعت مجزرة الحَرَم الإبراهيمي في 25 شباط/ فبراير 1994 في اليوم نفسه الذي ولد فيه الكاتب. اقتحم مستوطن صهيوني مسلّح الحرم أثناء صلاة الفجر وأطلق الرصاص على المصلين داخل الحرم. استشهد 29 مصلياً وجُرح العشرات داخل المسجد