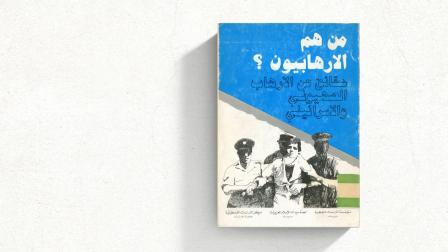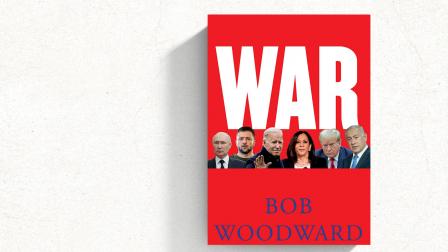يرى الباحث البريطاني بندكت أندرسن (1936) في كتابه "الجماعات المُتخيّلة" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) أن نهاية عصر القوميّة، التي طالما جرى التبشير بها، لا تلوح في الأفق ولو من بعيد. بل على العكس، إن الانتماء إلى أمّة ما، هو القيمة التي تحظى بأكبر قدر من الشرعية الشاملة في حياة عصرنا السياسية.
أهمية هذا الكتاب، الذي ترجمه ثائر ديب، وقدّم له المفكّر عزمي بشارة، تكمن في كونه يأتي من موقع مغاير للنظرة الأوروبية، وفي اتساع بيكاره لموضوعات كثيرة قياساً إلى حجم صفحاته العادي، وفي يُسر أسلوبه على القارئ غير المتخصص، وفي كون المنهج فيه، كما يقول المؤلّف، أكثر ليبراليّةً من أن يكون ماركسيّاً، وأكثر ماركسية من أن يعدّ ليبرالياً.
يعرّف أندرسن الأمّة بأنّها "جماعةٌ سياسية متخيّلةٌ، حيث يشمل التخيُّل أنّها محدّدة وسيدة أصلاً". ومن هذا التعريف، يعود الكاتب إلى الجذور الثقافية للمفهوم، حيث يرى أن فكرة "تخيُّل" الأمة لم تنشأ، في أوروبا، إلا بعد تراجع اللغة اللاتينية كلغةٍ مقدسة، في ظل الاكتشافات والاختراعات العلمية، وبوجهٍ خاص اختراع الطباعة؛ وبعد التغيير الذي جرى في طبيعة السلطة الملكية غير الوطنية التي تحكم بالمصاهرة والقرابة دولاً وشعوباً، من دون أن ترتبط بالشعوب بمقدار ما ترتبط بنفسها؛ وبعد نشوء مفهوم جديد للزمن يفصل الزمن اليومي الفارغ والقابل للملْء بالأفعال الإنسانية، عن الزمن الديني المملوء أساساً.
انهيار تلك الأقانيم مكّن أعداداً من البشر من التفكير بذواتهم، وربطِ أنفسهم بآخرين من خلال طرق جديدة، خصوصاً مع الطباعة التي هيّأت المنصة للأمة الحديثة؛ إذ وصل عدد الكتب المطبوعة في عام 1500 إلى ما يقارب عشرين مليوناً. وشكّلت صناعة النشر آنذاك الشكل المبكّر للمشروع الرأسمالي، لبحثها الدائم عن الأسواق وفتْحِ أصحاب المطابع فروعاً جديدة في أنحاء أوروبا، ما ساهم في نشر اللغات المحلية، وتوحيدها بين ملايين الناس، وبزوغ الإصلاح الديني في ألمانيا، في القرن السادس عشر، الذي سيبدأ من أطروحة مارتن لوثر التي علّقها على باب كنيسة "ويتنبرغ" عام 1517، بترجمة ألمانية؛ أطروحة انتشرت في أصقاع البلاد في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
هكذا، ستزداد الكتب المطبوعة بالألمانية بشكل كبير، وتتحول "الألمانية الشمالية الغربية" الشفوية إلى اللغة المتداولة نظراً إلى قابليتها للجمع والاستيعاب.
وهنا لا بد من عودة إلى مقدمّة عزمي بشارة التي يوضّح فيها خصوصيات تطور العربية إلى لغة قومية، قياساً لما حدث للغات الجرمانية أو اللاتينية: "العربية التي جرى التدرّج في تحديثها طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم جرت طباعتها وجرى نشرها، بقيت لغة قومية (على نحو يفارق العبرية التي حُدّثَت ووُضعت قواعدها كجزءٍ من مشروعٍ رأى نفسه مشروعاً قومياً هو المشروع الصهيوني) ولم تُستحدث، كما الفرنسية، من اللاتينية، كما لم تتحوّل اللهجات المحلية العربية إلى لغات. وفي حالة العرب والعربية، أصبحت اللغة المقدّسة لغة قومية.
 ولا شك في أن هذا من عوامل اختلاط المتخيّل العلماني بالديني، وإصرار أوساط واسعة نسبياً على استخدام العربية لتخيّل أمة دينية لا أمة قومية. ويبقى هذا سهل الحدوث طالما لم يصادف العربي شعوباً أخرى إسلامية لا تتكلم العربية، ولا يوحّدها الخيال ولا الأجندة والزمن مع المتخيل العربي إلا في المواسم المقدسة مثل الحج والأعياد".
ولا شك في أن هذا من عوامل اختلاط المتخيّل العلماني بالديني، وإصرار أوساط واسعة نسبياً على استخدام العربية لتخيّل أمة دينية لا أمة قومية. ويبقى هذا سهل الحدوث طالما لم يصادف العربي شعوباً أخرى إسلامية لا تتكلم العربية، ولا يوحّدها الخيال ولا الأجندة والزمن مع المتخيل العربي إلا في المواسم المقدسة مثل الحج والأعياد".
في فصل "رواد كريوليون"، يسرد أندرسن كيف أن التحرر القومي حصل في بلدان القارة الأميركية، على أيدي المستوطنين الكريوليين، قبل حصوله في البلدان الأوروبية، مبيّناً أن نهاية مسلسل هذا التحرر الناجح في البلدان الأميركية تتزامن مع انطلاق عصر القوميات في أوروبا.
في فصل "لغات قديمة، نماذج جديدة"، يرى المؤلف أن تفحُّص طابع القوميات الجديدة التي غيّرت وجه العالم القديم، في البلدان الأميركية الثورية، بين عامي 1820 و1920، يوحّده أمران؛ الأول هو الأهمية الأيديولوجية والسياسية التي حظيت بها "اللغات الطباعية القومية"، والأمر الآخر هو أن هذه القوميات كانت قادرة على العمل انطلاقاً من نماذج قدمتها سابقاتها البعيدة، وغير البعيدة، بعد زلزال الثورة الفرنسية.
هكذا "غدت الأمة ذلك الشيء الذي هو طموح واعٍ انطلاقاً من إطار للرؤية قديمٍ، لا انطلاقاً من إطار للرؤية يزداد حدة شيئاً فشيئاً".
وفي هذا السياق، يلاحظ الباحث أنه بعد قيام جمهوريات أميركية على أساس الحدود السياسية والإقليمية، بقيت الحدود الإدارية الاستعمارية في عام 1810 هي الأساس لتقسيم الدول. وتحوّلت هذه الدول القومية المستقلة إلى أنموذج لدول أوروبا وآسيا وأفريقيا، بفارق أن استقلال الأخيرة لم يقده مستوطنون كريوليون (creoles)، بل أهل البلاد.
ومع ازدياد انتشار اللغة والمشاعر القومية على مستوى شعوب الإمبراطوريات، وتضعضع شرعية السلالات غير القومية الحاكمة، أصبح لزاماً على أبناء هذه السلالات الذين يحكمون شعوباً أن يتبنوا قومية هذه الشعوب ولغتها، التي لم يكونوا يتحدثون بها قبل ذلك. فمثلاً، كانت الفرنسية لغة بلاط آل رومانوف في سان بطرس بورغ في القرن الثامن عشر، وكانت الألمانية لغة الكثير من نبلاء الريف في روسيا وبولندا وأوكرانيا.
أما ما يسمّيه أندرسن بـ"قوميات الموجة الأخيرة"، ومعظمها في مناطق آسيا وأفريقيا الكولونيالية، فكانت في الأصل رداً على الإمبريالية العالمية التي جعلتها منجزات الرأسمالية الصناعية ممكنة.
في نهاية كتابه، يعلن الباحث براءة القومية من الحركات العنصرية التي يعيدها إلى التراتبية التي خلقتها الطبقات الأرستقراطية كي تبرر حكمها. فالعنصرية ليست قومية، ولا من صيغ القومية، ما دامت غالباً تنفي القومية عن الخصم أو العدو أو الآخر، وتختزله إلى قسماته البيولوجية.
الكتاب الذي يدور حول ثلاثة أنماط من القومية: القومية الرسمية، والقومية الشعبية، وجمهوريات المواطنين؛ يكشف أنه أصبح لقوميات القرن العشرين طابعٌ قياسي نمطي، إذ تستطيع أن تستند إلى هذه التجارب الإنسانية.
بقي أن نقول إن المؤلّف، ربما ليسهّل عملية الرجوع إلى الكتاب، قد عمد إلى تلخيص أفكار كل فصل عند نهايته. كما أن المقدّمة التي وضعها عزمي بشارة (تقارب ربع متن الكتاب) تضع مفاهيم وأطروحات الكاتب في سياق عربي، وتقرّبها من القارئ العربي، خصوصاً وأن أندرسن لم يقارب القومية في منطقتنا.