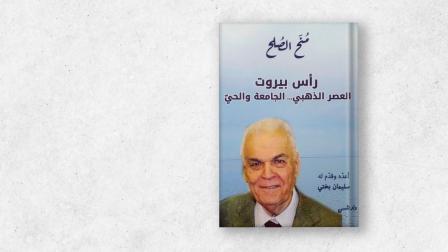لطالما كنت راغباً في قول ذلك، في الخروج تماماً من تلك الحقبة التي تبدو، بالنسبة لي في الأقل، تمريناً طويلاً ومضجراً على أداء تحية كشافة، أو إبراز وثيقة رسمية مختومة تثبت أبوّة "الروّاد".
إذا كان لجيل الثمانينات من الشعراء العرب الذي يضم قائمة طويلة من التجارب، من بينهم أمجد وأنا، اذا كان له أن يضيف فمن اضافاته، دون شك، حذفه لهذه الأبوّة التي فرضها نقاد مدرسيون تجولوا مثل عرفاء شرطة عابسين في الستينات والخمسينات، نقّاد لم يكن لهم، أيضاً، تأثير يذكر على هذه التجارب.
أمجد ناصر كان وسيلتي للخروج من تلك الوصاية الشعرية.
وصلنا إلى عمان معا ودون اتفاق، قبل أن نتجاوز العشرين في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، جاء من المفرق من بيت ضابط مدرعات صارم وعاطفي، وجئت من مخيم لاجئين من بيت موظف في وكالة الأمم المتحدة وناشط سياسي.
حملت في ذاكرتي مشهد معلّبات الإغاثة المعلقة على رفوف مرتجلة في بيوت اللاجئين الفلسطينيين، وحمل في نصوصه معلّبات الجيش التي تصل المطابخ الفقيرة للجنود الأردنيين في إجازات الخميس والاثنين.
تربطني بأمجد ناصر صداقة مركبة وعميقة لم تخضع للتخطيط، علاقتي به تشبه علاقتي بشعره، علاقة تتعمق كلما قرأت له قصيدة أو نصاً جديداً، لذلك بالضبط استمدت قوتها عبر كتاباته.
أستطيع أن أتذكر أن ذلك بدأ، عندما قرأ في أمسية بعيدة في النصف الثاني من السبعينات، في رابطة الكتاب الأردنيين، قصيدتيه "فيفا" وقصيدة أخرى عن "عمال النسيج" في حي "ماركا" إذا كانت الذاكرة تسعفني، شعرت بهذا الرابط من الود الذي لا يخلو من ندية، رغم كثير من الجفاء الذي اتسمت به لقاءاتنا في تلك الأيام، ذلك الجفاء الذي سيتحول عبر السنوات الى صداقة صافية تواصل بناء صفائها بدأبها الخاص، وباستقلال عن الجغرافية التي ألقتنا نحوها سنوات طويلة من المنافي.
يبدو ذلك غريباً الآن، قرأ بصوت مرتجف، لا يشبه على الإطلاق النبرة العالية المشاكسة اليقينية التي كان يخوض فيها جدالاته حول الشعر والأشخاص، كانت نبرته عندما قرأ في تلك الأمسية منخفضة وفيها الكثير من الشك، وبينما كان يقرأ كنت أعرف بما يشبه الحدس أن صداقة عمر بدأت بالتشكل.
لم أخبر أمجد بذلك، وسيعرفه ربما للمرة الأولى وهو يقرأ هذه المساهمة القصيرة في ملف احتفاء كهذا، ولكنه بالنسبة لي منذ تلك الأمسية كان الفتى البدوي الذي وصل عمان على غفلة من المدينة والشعراء الراسخين، وكان من الجرأة بحيث يكتب قصيدة مبكرة، لا تخلو من السرد، عن "عمال النسيج"، حين كان الشعر مشغولاً بتورية أفكار يسارية محفوظة ومتفق حولها في ثنايا التفعيلة وتأنيث "الوطن"، كان ذلك صادماً وبالنسبة لي ومدهشا، لقد فسر لي، من حيث لم يقصد، كيف يمكن للقصيدة أن تكون اكتشافاً.
في "منذ جلعاد كان يصعد الجبل" أهداني قصيدة، كنا قد وصلنا بيروت.
"وصول الغرباء" كانت دائما قصيدتي المفضلة، وستبقى إحدى قصائد جيلنا اللافتة، التي ستحتفظ بتأثيرها الخاص وبنائها المشهدي المتماسك المبني على سرد متوتر يخطف القلب.
فيما بعد ستشكل كل محطة في تجربة أمجد محطة في علاقتنا كما لو أن تلك الأمسية في صيف عمان البعيد تواصل التحديق بنا ونحن نطوف في الأفاق، من "سرّ من رآك" و"مرتقى الأنفاس" إلى "حياة كسرد متقطع"، مرورا بكتب الرحلة وروايتي "حيث لا تسقط الأمطار" و"هنا الوردة"، وحتى يوميات الحصار في كتابه "بيروت صغيرة بحجم اليد" الذي سمح لي بكتابة مقدمته.
ربما لهذا عندما حملت حقيبة الظهر الصغيرة وجلست في مقعد مظلي في طائرة "الهيركوليز" العسكرية في الطريق من تونس إلى مطار العريش في سيناء، ثم إلى غزة للمرة الأولى، كان في الحقيبة أربعة كتب أحدها "رعاة العزلة" كتابه اللافت الذي أنجزه أمجد أثناء إقامته في جزيرة قبرص.
لأمر ما كان لدي إحساس أنه أحب تلك السنوات التي قضاها في الجزيرة، حتى عندما غادرها إلى لندن بقيت عالقة في ذهني كمكان ملائم لسكن أمجد.
الحديث عن علاقتي بتجربة أمجد بحاجة الى مساحة أوسع بكثير، وتتبع أكثر دقة إذ سيتقاطع في كل زاوية مع السيرة الذاتية، وهو مشروع كنت بدأت به منذ سنوات.