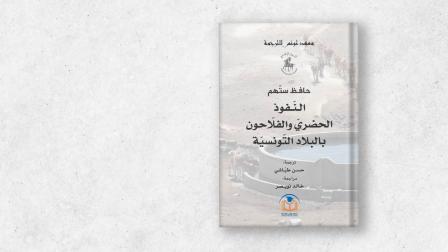عودٌ على بدءٍ، استِئنافاً لمُساءلة التنوير العربي واستنطاق ما قامت عليه "نَهضة العرب" من حَرَج المواءمة بين الأصالة والحداثة، للولوج في التاريخ الكوني المعاصر، أعيدت هذه المعضلة إلى الواجِهة مُؤخراً، وكأنَّ القلق فيها لا يَنفذ، في ظلّ تحوّلات عالمية جمّة، أصابت الإجاباتِ التقليدية الناشئة قبل قرنٍ في مقتلٍ وأثارت تحدّياتٍ جَديدةً، صاغها المفكّر التونسي عياض بن عاشور (1945) في كتاب "في أصول الأرثوذكسية السُّنّية"، الذي صدر، في الأصل باللغة الفرنسية، سنة 2008، عن "منشورات الجامعة الفرنسية" بباريس، وصدرت ترجمته مؤخراً في طبعة مشتركة بين "معهد تونس للترجمة" و"دار محمد علي".
ينحدر بن عاشور من أسرة تولّت في تاريخ تونس الحديث مناصبَ دينية وعلميّة كبرى كالإفتاء والتدريس والقضاء. وقد تلقّى تكويناً قانونياً أردفه بمعرفة دقيقة لنصوص الإسلاميات التطبيقيَّة. وتجلت ثقافته المزدوجة في كتبه التحليلية التي تعيد موضعةَ مؤسّسات الإسلام ضمن سياقاتها الثقافية. من أهم مؤلّفاته في العشرية الأخيرة: "أيُّ إسلامٍ لأوروبا؟" (2017)، و"تونس: ثورة في بلاد الإسلام" (2016)، و"الفاتحة الثانية: الإسلام وفكر حقوق الإنسان" (2011)، و"الإغراء الديمقراطي: السياسة والدين والقانون في العالم العربي" (2010)، و"القانون الإداري" (2010)، وغيرها.
وقد ارتأى "معهد تونس للترجمة" نقلَ هذا التأليف إلى العربية، على ما في مبادرته من عُسر وتعقيد، فالكتاب حافلٌ بمصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية والقانونية. وتصدّت لنقله الباحثة أسماء نويرة، أستاذة العلوم السياسية والقانونية بالجامعة التونسية، وهي تشتغل على مؤسّسات الإسلام الرسمي، ومن أبرز مؤلّفاتها: "مفتي الجمهورية في تونس" (2001)، و"الرد على الوهابية" (2008) بالاشتراك مع حمادي الرديسي. وقد قدَّمت هنا ترجمةً دقيقة استعادت عبرها تجرّد المفاهيم وعمق التحليل، مُطوِّعةً الضاد للتعبير عن أكثر المعضلات غموضاً. لم يَجُرْ نصُّها السلس على أصالَة الأسلوب ولا جسارة التحليل.
في هذه "المحاولة"، ومن الفَلسفة التحليلية مَعينُها، اختار صاحب "الفاتحة الثانية" التركيز، لا على نظرية الأخلاق لدى الصوفية أو الفلاسفة الذين خَصّصوا خطاباتِهم للتعالي بمَصادر القيم ومنشأ القواعد المقدّسة، ولا على كُتب العقيدة والفقه الطافحة بالجدل والخلافيات، وإنما على النظرية السياسية، ويَعني بها ابن عاشور "نقطة الالتقاء بين طبقةٍ من المفكّرين والجمهور والمؤسّسة الأرثوذكسية".
ولتفكيك نقطة الالتقاء هذه، قسَّم المؤلفُ كتابَه إلى أربعة أجزاء: خصَّصَ القسمَ الأولَ لاستعراض المجهود النظري الذي وَضعَ المنظومة الفكرية لأهل السنة وبيان ما اعتمدوه من مبادئ ومفاهيمَ لإقامة "منظومة الإيمان" التي صارت غالبةً بفعل التواطؤ مع السلطة والمثقّفين. وخَصّص الثاني لتحليل العناصر الجوهرية لأسس المذهب، ولا سيما المبادئ الخمسة لدستورية الإسلام السنّي، الذي يعتمد على زمنٍ أولي - تأسيسي، كما على نصٍّ مرجعي وقواعد متعالية، ثم تناول طبيعة السلطة وتداخل الزمني والروحي فيها عبر قضية الخلافة والملكية وسلطة الاضطرار، ومنها تعرَّضَ إلى مسألة الأقليات المنشقّة، التي كان يُطلَق عليها اسم "الفِرق الضالّة" أو "المِلَل والنحل"، ويختمه بتحليل مناقب الأمير والرعية أو الحاكم والمحكومين.
وأما الثالث، فَتصدّى فيه لنظرية العنف ومبادئها، كما ارتسمت في قلب هذا البناء الفكري السياسي. وفي رأينا، هذا هو الجزء الأكثر أصالة وجسارةً، لأنه تطرّق فيه إلى العلاقات المنعقدة بين النظام الإلهي والطبيعي وأجرى خلاله تصنيفات مُبتَكرَة عن أصناف العنف وآلياته، أكان محموداً أم مذموماً. وتعرّض إلى معضلة الإرهاب وعلاقته بالإسلام، كما إلى قضية الردّة وحرية الضمير ووضع المغيّر لدينه، (المرتد)، وهي من أعقد المسائل في ظل عولمة القيم القانونية وكونية مبادئ حقوق الإنسان، ولو على المستوى النظري. وأخيرا تَناول ابن عاشور رؤية السنّة للقانون في مجمل الأحداث والاضطرابات التي تهز العالَم الإسلامي بعد أن انطوى في الشبكة العالمية من القيم وأبنية الإنتاج.
كانت نقطة الانطلاق، في هذا العمل الجسور، اعتبارَ المذهب السنّي منظومةً رمزية- بشريّة، تأسست تدريجيّاً في سياق تحوّلات واحتمالاتٍ تاريخية، كان من الممكن ألا تنجحَ، إن أخذت الأحداث مساراً مغايراً. ثمّ استحالت هذه المنظومة إلى مجموعة من المبادئ والأفكار التي استَبْطنَها الجمهور، أو العامّة، بعد أن نظَّرتْ لها الفئات العالمة من فقهاءَ وكَتَبَة. وكلهم كان واقعاً، بحكم طبيعته الدنيوية، تحت إكراه التاريخ وقيوده.
وينزع هذا التصوّر التفكيكي كلَّ قداسةٍ سماوية عن "المذهب"، إذ ينظر إليه كتيّارٍ معقدٍ، تبنته ثقافاتٌ محلية متنوّعة، وخَضعت به، كما أخضعته ضمن جدلٍ دائري، إلى مَنطق التاريخ وقانون التحوّل. وقد كان نجاح هذه المنظومة وليد التعاون الضمني والصريح بين "أهل السيف وأهل القلم وأهل الخبز اليومي"، وهو تعاونٌ أفضى إلى تهميش رسميٍّ لكل المخالفين، واعتبارهم من فئة المنحرفين عن جادة السبيل، أو "الأقليات" بلغتنا المعاصرة. وتَجدر الإشارة إلى أنَّ مفهوم "orthodoxie"، الذي انبنى عليه الكتاب بأسره، يَعني: الصراط المستقيم، ويقتضي ضرورَةَ التطابق معه. وهو مشتق من اللفظة الإغريقية: Doxa الدالة على: الرأي السديد. وقد خَصَّص لها عالم الاجتماع الأميركي ميلتون روكيش سلسلةً من الأبحاث رابطاً إياها بالدغمائية والانغلاق. كما سَبَق للمفكّر الإسلامي محمد أركون في كتابه "الإسلام: قراءة علمية" أن وظَّف هذا المفهوم في تحليله للظواهر الإسلامية.
ولِسَبَبٍ ما أهمَل عياض بن عاشور تحليلَ المضمون الشعائري في المذهب السنّي، وهو الذي لا يختلف في جوهره عن المضامين الشعائرية للمذاهب والجماعات الأخرى عموماً، وأغفل أنَّ قِوام هذا المذهب كسائر المذاهب المعارضة، ليس نظرية العنف ولا نظرية القانون اللتين لا تهمان عامّة الناس إلّا قليلاً، بحكم عدم الاطلاع على تفاصيلها وتغييبهم المقصود عنها. ولذلك نرى أنّ التركيز عليهما كجوهرين رئيسين في تشكل المذهب وتطوّره فيه مبالغة وإهمال لقطاعٍ أساسي في المقاربة. ويقال نفس الشيء عن "العقيدة" في بُعدها العالِم، وفي بعدها العامي الشعبي، فهي التي استُبطِنَت كمجموعة من المبادئ الغيبية التي تؤثر مباشرة في السلوك اليومي للمؤمنين وتملي عليهم قواعد وكيفيات النظر إلى العالم وممارسة التاريخ فيه.
 وقد يكون ابن عاشور صاغ عمله حول "العنف والقانون" بإملاء من الضغط العالمي الذي مورس على الإسلام بُعيد أحداث سبتمبر 2001، إذ نجد آثار الانتقاد الغربي لهذا الدين وربطه الآلي بالعنف والإرهاب، مما جعل بحثه عن أصول السنيّة أشبه ما يكون بحوار مع "مهاجم خارجي"، فرض وجهة النظر ومضمون المكافحة وحتى منهج الجدل، ثم حشَرَ فيه ابن عاشور، فاضطرَّ إلى الإجابة بأدوات مهاجمه.
وقد يكون ابن عاشور صاغ عمله حول "العنف والقانون" بإملاء من الضغط العالمي الذي مورس على الإسلام بُعيد أحداث سبتمبر 2001، إذ نجد آثار الانتقاد الغربي لهذا الدين وربطه الآلي بالعنف والإرهاب، مما جعل بحثه عن أصول السنيّة أشبه ما يكون بحوار مع "مهاجم خارجي"، فرض وجهة النظر ومضمون المكافحة وحتى منهج الجدل، ثم حشَرَ فيه ابن عاشور، فاضطرَّ إلى الإجابة بأدوات مهاجمه.
كما نلاحظ أخيراً أن التركيز على "الخصوصية السنّية"، ولا سيما في ما يتعلق بالتشريع أو العنف، أو العلاقة بالدولة والسلطة، غير مبرَّر كفايةً، فثمّة نفس الآليات التي تحكم الشيعة في بلادهم وشتاتهم، وكذا الإباضية، بل وسائر المذاهب والديانات والأيديولوجيات، بمعنى أن هذه التحالفات التي أجاد في وصفها تكاد تكون ثوابت أنثروبولوجية كونية تميّز كل الجماعات الإيمانية، مهما اختلف مضمونها الروحي.
ويحقُّ التنويه هنا بما بُذل، في هذه الترجمة، من الجهود المضنية في سبيل نقل مُصطلحات العلوم الإنسانية ومفاهيم القانون العام، والنفَس النقدي- الحفري، ذي الخلفية الفوكولتية، الذي اتّبعه الباحث. وهكذا، ذَلَّلت أسماء نويرة هذه الصعوبات مقدّمةً للقارئ العربي نصّاً سلساً، يحافظ على بريق الأدبيّة دون أن يَتَنازل عن صرامة المنهج ودقّة التوصيف. وليست ترجمة مثل هذه الأبحاث المتينة مجرّدَ نقلٍ لخطاب، بل هي استحداثٌ لمنزع عقلي وأسلوب في التحليل وَفَتْ به المترجمة ولم تُخِلّ. واجترحت في سبيل ذلك مفردات المنزع التفكيكي ضمن الضاد المعاصرة من أجل تيسير الاغتراف من هذه الترجمات في نقد الخطاب الديني وتجديده. ترجمة الكتاب في حدّ ذاتها إثراءٌ للمكتبة العربية بسلسلة من المصطلحات والخطوات الإجرائية في تفكيك النصوص وكشف التلاعب بها، وقراءة الأحداث وما يكتنفها من الغموض.
ويبقى، مع ذلك، هذا البحثُ العالِمُ نقطةَ تحوّل في النقد التاريخي لوجه من وجوه الإسلام وحفراً أركيولوجياً لعَتَباته وطبقاته، التي تشكلت لاوعياً جماعيّاً أملى مسالك في السياسة والثقافة. ويبقى أيضاً البعد الغيبي في الإنسان عصيّاً على التحديد، ولا يمكن تحليله فقط بمتغيّرات السياسة وتناقضات الاقتصاد. بَين ضرورة الخبز وتألّق القلم تَرتمي الروح في مراح الغَيب. والتاريخ، كما قال هيغل، حركة جدلية وسلسلة من الثورات، يستخدم فيها "المُطْلَق" الشعوب إثر الشعوب والعباقرة إثر العباقرة أدواتٍ لتحقيق التطوّر نحو "الحرية"، وهذا هو هدف الصوفية السنّية التي أغفلها ابن عاشور.